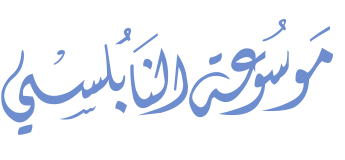الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
لكل قصة في القرآن مغزى يتِّصل اتصالاً وثيقاً بحياة كل إنسان:
أيها الإخوة الكرام؛ مع الدرس الخامس من سورة القلم، ومع الآية الكريمة السابعة عشرة من هذه السورة، وهي قوله تعالى:
﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17)﴾
أيها الإخوة الكرام؛ قبل أن نبدأ بشرح تفاصيل هذه القصّة لابدَّ من الحديث عن
محورها أو عن مغزاها، ومغزاها أو محورها يتَّصل أشدّ الاتصال بحياة كل مؤمن، أو بحياة كل مسلم، لأنه ما من إنسانٍ إلا وساق الله له من الشدائد ما ساق، هذه الشدائد واقعة لا أحد يُنكرها، ولكن الفرق الكبير بين فهم المؤمن لها وفهم الكافر بون شاسع، فالجاهل قد يراها تضييقاً من الله، أو إزعاجاً لهذا الإنسان، وقد يراها المؤمن محض رحمةٍ، ومحض لطفٍ، ومحض تربية.
كما قلت قبل قليل هذه القصة لها مغزى أو لها محور، ومغزاها أو محورها يتِّصل اتصالاً وثيقاً بحياة كل إنسان، فبعد أن حدَّثنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين كذَّبوا رسول الله، واعتدّوا بمالهم، وبمكانتهم، وكيف أنهم سخروا من الحق وكذَّبوه، يقول الله عزَّ وجل:
﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ(16)﴾
قصة أصحاب الجنة قصة لكل من كذب واستكبر واعتدّ بمكانته وماله:
هذا الذي كذب، واستكبر، واعتدّ بماله، وأولاده، ومكانته، ربنا عز وجل يضع بين يديه هذه القصة: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ بلوناهم الأولى تعود على هؤلاء المكذِّبين، معنى بلوناهم أي امتحنَّاهم، ومعنى بلوناهم أي أصبناهم بالمصائب، إما أنه امتحان وإما أنه عقاب، ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ وقال بعض المفسرين: البلاء لم يقع بعد، ولكن الله إذا توعَّد إنساناً فكأنه وقع.
ولأضرب لكم مثلاً؛ لو أنك تعلم علم اليقين أن هذه السيارة ليس فيها مِكْبَح، وأن راكبها –سائقها-ركبها وسيَّرها إلى طريقٍ هابطٍ، وهذا الطريق الهابط ينتهي بمنعطفٍ حاد، وكان سائق هذه السيارة يبتسم ويضحك، وأنت تعلم علم اليقين أن مكبح السيارة معطَّل، وأن الحادث حتمي، إذا قلت: هلك صاحب هذه السيارة، هو لم يهلك بعد، هذا الكلام يعني أن المنحرف، الكافر، الفاسد، الضال، العاصي ينتظره عقابٌ أليم، وهذا العقاب الذي توعَّده الله في الدنيا أو في الآخرة واقعٌ لا محالَة، بل وقع، وكأنه وقع، يؤكِّد هذا المعنى قول الله عزَّ وجل:
﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1)﴾
لا تستعجلوه أي لم يأت بعدُ، وأتى: فعل ماضٍ، ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ وأنت أحياناً ترى مقدمة الأحداث تحكم قطعاً بنتائجها، أي إذا قربت ناراً من بارود الانفجار واقع لا محالة وكأنه انفجر، إذا ألقيت ماء في منحدر وكأنه سال، هذا علمٌ بالقوانين، فربنا عز وجل أي إنسانٍ يكذِّب، يرفض الحق، يستكبر عن أن يعتنقه، يكيد لأهل الإيمان، يستكبر بماله، بمكانته، بقوَّته، يريد أن يطفئ نور الله عزَّ وجل، بإمكانك أن تعتقد اعتقاداً جازماً أنه هالكٌ لا محالة، هالكٌ مع وقف التنفيذ، ولابدَّ من أن يأتي التنفيذ بعد حين، والمؤمن لشدة يقينه بكلام الله عزَّ وجل هو يقول: هذا مستقيم نرجو له التوفيق، وهذا منحرف نخشى عليه من العقاب، السيدة خديجة رضي الله عنها حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وحدثها بما رأى ماذا قالت له؟
(( عن عائشة أم المؤمنين: .. فَوَاللَّهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَدًا؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ علَى نَوَائِبِ الحَقِّ. ))
معنى ذلك أن السيدة خديجة من علمها؟ هذه الفطرة، وهذا الكلام أيها الإخوة نستفيد منه جميعاً، لو أن شاباً تعرَّف إلى الله، واستقام على أمره، وابتغى رضوانه، ورجا رحمته، وانضبط بالشرع، وحرر دخله، وضبط جوارحه، لك أن تقول له وأنت واثق: والله لا يخزيك الله أبداً، التوفيق حليفك، والحفظ واقع، والله يرعاك ويؤيدك ويحفظك، وهذا معنى قول الله عزَّ وجل:
﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)﴾
هناك معيّةٌ عامّة ومعيّة خاصَّة.
﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)﴾
هذه معيّةٌ عامَّة، معية العلم، أما: ﴿أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ فهذه معية خاصة، هو معهم مؤيداً، وناصراً، وحافظاً وموفِّقاً، فالمستقيم قل له: لا تخش شيئاً، الله معك، المُكذِّب بالحق؛ الذي يأكل المال الحرام، الذي يبني ماله على إفقار الناس، الذي يبني حرفته على إيذاء الناس، الذي يعتدي على أعراض الناس، الذي يعتدي على أموال الناس، الذي يُضَلل الناس، الذي يبني ثروةً على إفساد أخلاق الناس؛ يُنشئ ملهىً، يتاجر بأفلام لا تُرضي الله عزَّ وجل، الذي يكسب المال الحرام بإمكانك أن تتوقع له الدمار، وأنت لا تعلم الغيب ولكنها قوانين الله عزَّ وجل.
على الإنسان أن يتلقى وعد الله وكأنه وقع:
إذاً يجب أن تتلقَّى وعد الله وكأنه وَقَع.
﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116)﴾
هذا الحوار جرى؟ لم يجر بعد، هذا الحوار سيجري يوم القيامة، لكن لماذا قال الله عزَّ وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ ، طبعاً عُبِّر عن هذا الحدث بالفعل الماضي لأنه محقق الوقوع، ولماذا قال الله عزَّ وجل:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1)﴾
من منكم رأى ماذا فعل الله بأصحاب الفيل؟ معنى ذلك أنه ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنه شيءٌ تشاهده لليقين، إذا بعض العلماء قالوا: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ أي هؤلاء أهل مكة، كفَّار مكة، زعماء مكة، أغنياء مكة، هؤلاء الذين عَتَوْا عن أمر ربهم، ورفضوا الحق، وكذَّبوا النبي، واستعلوا، هؤلاء واقع بهم الهلاك لا محالة، لذلك قال بعض المفسرين: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ أي سنبلوهم مع وقف التنفيذ، أحياناً قد يبني الإنسان مجده على المال الحرام، يتيه بماله، يتيه ببيته، يتيه بما عنده، ولكن الله سيدمره، وكأنه دمَّره، وكأنه أهلكه: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ فالحديث عن هؤلاء الكفَّار الذين يمثِّلهم الوليد بن المغيرة الذي جرت قصَّته في الدرس الماضي: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ وقال بعض المفسريّن: لقد أصابت الشِّدة أهل مكة في بعض السنوات، وكأن هذه الشدَّة تأديبٌ من الله عزَّ وجل، أو عقابٌ لهم على كفرهم وتآمرهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ أي امتحنَّاهم، أو أصبناهم بالمصيبة، ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ .
كلّ حظوظ الدنيا ليست نعماً ولا نقماً إنما هي ابتلاء:
هناك معنى ثالث: أي شيءٍ بين يديك تتمتع بصحة، هل هي نعمة؟ لا، هل هي نقمةٌ؟ لا، إنها امتحان، فإذا أنفقت هذه الصحة في طاعة الله انقلبت إلى نعمة، وإذا أنفقتها في معصية الله انقلبت إلى نقمة، بين يديك مال وفير هل هو نعمةٌ؟ لا، هل هو نقمةٌ؟ لا، مادة امتحان، إن أُنفق هذا المال في طاعة الله كان سُلَّماً ترقى به، وإن أنفق هذا المال في معصية الله كان دركاتٍ تهوي بها، لك زوجة هل هي نعمة؟ لا، هل هي نقمة؟ لا، إنها امتحان، إن أخذت بيدها إلى الله ورسوله والدار الآخرة كانت نعمةٌ من أَجَلّ النعم، أما إذا أفسدتها وأفسدت بها الآخرين كانت نقمةً من أعظم النقم، لك أولاد هل هم نعمةٌ؟ لا، هل هم نقمة؟ لا، إذا نَشَّأْتَهُم على طاعة الله كانوا لك نعمةً، وكانوا لك صدقةً جارية، وإن تركتهم وشأنهم ولم تؤدبهم ولم تعلمهم كانوا نقمةً، فكل أعمالهم الخسيسة في صحيفة الذي لم يعتن بهم، معنى ذلك كل حظوظ الدنيا ليست نعماً ولا نقماً إنما هي ابتلاء، فإذا أُنفقت هذه النعم في طاعة الله كانت نِعَمَاً، وإن لم تنفق في طاعة الله كانت نِقَمَاً يؤكِّد ذلك قول الله عزّ وجل:
﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17)﴾
كلا: أداة ردعٍ ونفيٍّ؛ كلا ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، من السذاجة وضيق الأفق والغباء أن يتوهَّم الإنسان أن المال الذي بين يديه نعمةٌ عُظمى، هو نعمةٌ إذا أنفقته في طاعة الله، أما إذا أنفقته على المعاصي والآثام كان نقمةً وأية نقمة، قس عليه الزوجة، والأولاد، والصحة، وطلاقة اللسان، والقدرات العقلية، والاختصاص والمهن الراقية، كل هذه الحظوظ ليست نعماً وليست نقماً، إنما هي سُلَّمٌ ترقى به إن أنفقتها في طاعة الله، أو دركاتٌ تهوي بها إن أنفقتها في معصية الله: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ أي سنبتليهم، أي سنعاقبهم، أو عاقبناهم، أو: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ أي جعلنا هذا المال الذي بين أيديهم مادة امتحان لهم، ألم يقل الله عزَّ وجل:
﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14)﴾
إنَّا بلوناهم بهذا المال والبنين، هذا المعنى الثالث.
﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ أصحاب الجنة -فيما تروي التفاسير-في اليمن بالقرب من صنعاء كان هناك رجلٌ صالح، وله بستانٌ فيه من كل الثمرات، وكان هذا الرجل الصالح يؤدّي حق الله للفقراء والمساكين عند حصاد الثمار وقِطافها، توفِّي هذا الرجل وخَلَفه أولاد عدة.
وقبل أن أتابع القصة أُصَغِّرَها لكم في قصّةٍ قصيرة سمعتها: بيتٌ من بيوت الشام القديمة في أحيائها التقليدية في هذا البيت شجرة ليمون، تحمِلُ من الثمرات ما لا يُعَدّ ولا يُحصى، كان في هذا البيت امرأةٌ صالحة، فكلَّما طُرق باب هذا البيت وطُلِب منهم ثمرة من هذه الثمار قدمت هذه الثمرة وكأنها وقفٌ لأهل الحيّ، ماتت هذه المرأة الصالحة وجاءت من بعدها زوجة ابنها الشابَّة، فلمَّا طُرِق الباب وطلب الطارق ثمرةً من هذه الثمار طردته ومنعته من هذا الطلب، بعد حين يَبِسَت هذه الشجرة وماتت، تلخيص بسيط جداً لهذه القصة، إنّ لله عباداً أعطاهم من النعم الشيء الكثير يقرُّهم عليها ما بذلوها فإن منعوها حوّلها إلى غيرهم، إياك ثم إياك ثم إياك إن كان بيدك شيء ثمين تنفع الناس به إياك أن تمتنع عن نفع الناس به، لأنك إن فعلت ذلك أُخِذَ منك وحُوِّل إلى غيرك.
﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ بستان جميل فيه من كل الثمرات، صاحبه رجلٌ صالح يؤدي حقّ الله ويطعم الفقراء والمساكين، وكان من عادة هؤلاء الفقراء والمساكين أن يأتوا إلى هذا البستان يوم الحصاد، أو يوم قطف الثمار، فيأخذون حقَّهم ونصيبهم طيبةً به نفوسهم، توفِّي هذا الرجل وترك أولاداً، هؤلاء الأولاد نوع آخر كما هي العادة، ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾ اجتمعوا ليلاً وتدارسوا الأمر، ورأوا ألا يعطوا أحداً من المساكين، عليهم أن يقطفوا هذه الثمار دون أن يشعر بهم أحد، وأن يبيعوها وأن يقبضوا أثمانها دون أن يعطوا الفقراء والمساكين حقَّ الله عزَّ وجل، ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾ أي العمل مؤكَّد، الإنسان أحياناً يفعل شيئاً عن غير قصد أو عن غير تصميم، أما هؤلاء اجتمعوا وتدارسوا، وتناقشوا وتحاوروا، وقرَّروا وأقسموا: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ أي أن يذهبوا بعد منتصف الليل قبل أن يأتي هؤلاء الفقراء يقطفوا هذه الثمار، يضعوها في الصناديق إن صحّ التعبير، ويسوِّقونها دون أن يعطوا هؤلاء الفقراء شيئاً.
معاني قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾:
﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18)﴾
هذه الآية لها معنيان؛ قال بعضهم: لا يستثنون من هذه الثمار الفقراء، كلها للبيع.
قرأت مرَّةً أن محصول البرتقال في أمريكا أراد زارعو البرتقال إتلافه للحفاظ على الأسعار المرتفعة، خافوا من هبوط الأسعار أرادوا إتلاف هذا المحصول، تسلل الزنوج الفقراء تحت الأسلاك الشائكة ليأكلوا هذا البرتقال الطيِّب الذي أراد أصحابه إتلافه، في العام القادم فعلوا الشيء نفسه ولكن مع تسميم هذا المحصول لئلا ينتفع منه إنسان، هكذا الكافر، شحيح.
﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12)﴾
في أستراليا قبل عدّة أعوامٍ تمّ إعدام عشرين مليون رأس غنم بالرصاص، وحُفرت الحفر ودُفِن هذا العدد الكبير، عشرون مليون رأس غنم تمّ إعدامها ودفنها تحت الأرض للحفاظ على أسعارها المرتفعة، بينما هناك شعوبٌ تئن من الجوع، تموت من الجوع، أهلكتها المجاعات، هذا هو الكفر، ولا يُستبعد أن يكون أصحاب هذه الأغنام في أستراليا هم أنفسهم أصحاب البقر الذي جنّ في إنكلترا، العقاب كان شديداً، ثلاثة وثلاثون مليار جنية إسترليني قيمة ثلاث عشرة بقرة يجب أن تُحرق، فهذا هو الكافر: ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ .
﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)﴾
﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18)﴾ لا يعطون أحداً، هذا معنى.
المعنى الآخر؛ إذا قلت مثلاً: أنا سأذهب إلى الجامعة غداً، إذا قلت: إن شاء الله تعالى، لقد استثنيت، وأيَّ يمينٍ استثنيت معه لا تحنث إطلاقاً إذا فعلته، لن أفعل هذا إن شاء الله، هذا يمين لا حِنْثَ فيه لأن فيه استثناء، والمؤمن الصادق لا يتكلَّم كلمة إلا أن يقول: إن شاء الله تعالى، نحن والعياذ بالله بعض الناس فَهِم هذا الاستثناء فهماً شيطانياً، أي إن أراد أن يدفع يقول: سأدفع لك غداً، أما إن أراد ألا يدفع يقول: إن شاء الله ندفع لك غداً، يستثني إن أراد ألا يفعل، لكن المؤمن وهو في أعلى درجات العَزْمِ والتصميم على أن يفعل يقول: إن شاء الله.
﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)﴾
فهناك عندنا إن شاء الله الإيمانية، وإن شاء الله النفاقية، إن شاء الله الإيمانية أي أنت عازم على أن تفعل.
﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18)﴾ ماذا يعني أن يقول الإنسان: سأفعل ذلك غداً ولا يستثني؟ هو قد يظن القضية سهلة، من قال: سأفعل ذلك غداً دون أن يستثني، معنى ذاك أنه متأكدٌ من أنه سيعيش غداً، متأكدٌ من أن غداً يتمتع فيهً بالصحة، متأكدٌ أن ماله بيديه غداً، وكل هذا لا يملكه، لذلك قالوا: من عَدَّ غداً من أَجَله فقد أساء صُحْبَة الموت، كل إنسان يقول: سأفعل هذا غداً بتصميمٍ وعزمٍ، دون أن يستثني فهو مشرك، لأنه يعتقد أنه مستقلٌ بإرادته وبفعله عن الله، أنت حينما تستثني تكون عبداً صالحاً، وتكون مؤمناً، وتكون عالماً، هؤلاء لا يستثنون جزءاً للفقراء من الثمار التي سيقطفونها، ولا يستثنون بقولهم فيقولون: إن شاء الله، ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18)﴾ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، إن سلَّمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلِّم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79)﴾
هكذا اجتمعتم؟ وهكذا قرَّرتم؟ وهكذا تعاهدتم؟ وهكذا أقسمتم؟ وهكذا صمَّمتم؟
طائف الله من آيات الله الدالة على عظمته:
إذاً:
﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19)﴾
الشيء المألوف الآن موجة صقيع واحدة لبضع دقائق تُتلف محاصيل بمئات الملايين، وهذا شيءٌ يعلمه كل من يعمل بالزراعة، جاء صقيعٌ للغوطة أتلف كل محصول المشمش، هذا طائفٌ من ربك وهو نائمون، كل إنسان يفكر أن يضمّن بمئتي ألف أوبخمسمئة ألف أو بمليون، جاءه طائفٌ من ربك وهو نائمون، لذلك كل إنسان وهذا من آيات الله الدالة على عظمته يؤدي زكاة الزروع، زكاة الزروع الأرض المسقية زكاتها نصف العشر، والأرض البعل زكاتها العشر دون أن تُحسَب النفقات، من أدَّى زكاة مزروعاته حفظ الله له هذه المزروعات، هناك أدلَّةٌ كثيرة جداً، قد يزرع مزارعان أرضين متجاورتين يسقيهما نهرٌ واحد، والذي زرع هذه وتلك مزارعٌ واحد، ونوع البذار واحد، ونوع السماد واحد، والأمطار التي هطلت واحدة، ثم تجد أن هذا الحقل أعطى أضعافاً مضاعفة، وهذا الحقل أعطى شيئاً نزراً يسيراً، ما السبب؟ هذا نوى أن يؤدي زكاة مزروعاته، وهذا أراد أن يمنع حق المسكين.
سمعت قصةٌ قديمةً جداً أنه قبل خمسين عاماً جاءت موجة جرادٍ إلى هذه البلدة لم تُبقِ شيئاً، أكلت الأخضر واليابس، وأهلكت كل المزارع والبساتين، إلا أن هناك بستاناً بقي يتمتَّع بأعلى درجات النضْرَة، سألوا صاحبه: ما سرّ أن الجراد لا يأتي إلى بستانك؟ قال: عندي دواء، قالوا: ما هذا الدواء؟ تمنع الناس من هذا الدواء؟ قال: تأدية الزكاة! هذا هو الدواء، ويُقسِم أحدهم بالله أنه جاء بكيس جراد من الحقول المجاورة وألقاها في هذا البستان بأقل من دقائق لم تبق جرادةٌ واحدة كلها طارت بعيداً، الذي يؤدي زكاة ماله.
سألني أحدهم مرَّة: هل على العسل زكاة؟ قلت له: نعم، قال: فإذا لم ندفع؟ قلت له: القُرَّاض جاهز، هذه حشرة تأكل النحل وتتلف الخلايا، وقد جاءت موجة قُرَّاض منذ أعوام أتلفت معظم خلايا النحل، فإما أن تدفع الزكاة وإما العلاج جاهز، هؤلاء قال: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ لك أن تفهم الطائف بأنه الصقيع، ولك أن تفهم -كما تَروي بعض التفاسير والله أعلم-أن ملائكةً اقتلعت هذه الأشجار كلَّها، ووضعتها في الطائف، نحن يعنينا أن هذا الثمر تَلِفْ بطريقةٍ أو بأخرى، ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ وهذا الطائف موجود دائماً في كل عصر، موجة صقيع طائف، فيضانات تُتلف المحاصيل طائف، رياحٌ عاتية تقتلع البيوت البلاستيكية كلها هذا طائف.
مرة فأر الحقل، مرَّة الذبابة البيضاء، أي عدد الحشرات التي تقضي على المزروعات لا تُعَدّ ولا تحصى، من حشرات، إلى آفات، إلى فيضانات، إلى رياح عاتية، إلى صواعق، إلى صقيع، هذا كلَّه من الطائف، ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ وهذا للمزارعين، أما للتجَّار فتوجد الحرائق، يحترق مستودع فيخسر صاحبه عشرين مليوناً، وهذا طائف أيضاً، الحريق طائف، والمصادرة طائف، وتلف البضاعة طائف، وأن تأتي البضاعة بغير التي اشتريتها فتخسر خسارة كبيرة طائف، أي عدد الأدوية التي عند الله لا تعد ولا تحصى، عدد الأدوية التي عند الله والتي يعاقب بها هؤلاء الذين منعوا حقّ الفقير لا تعدُّ ولا تُحصى، ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ هم يحلمون بقطف الثمار، وجني المحاصيل، وبيع هذه الثمار، ووضع أثمانها في جيوبهم، ثم يرفلون بأثواب العز والغنى، نائمون اجتمعوا وقرَّروا، وأقسموا واتخذوا القرار، وتعاهدوا، وهم يحلمون بالثروة طائلة:
﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20)﴾
كأنها مقطوعة، إما أنها أرضٌ خلاء لا شيء فيها، اقتُلِعَت أشجارها، وإما أن هذه الثمار احترقت من الصقيع فأصبحت وكأنها قد قُطِعَت ثمارها، وكأنها قد جنيت ثمارها ﴿فَأَصْبَحَتْ كالصَّرِيمِ﴾ .
اتفاق أهل الجنة على جني المحاصيل وبيع الثمار ومنع حق الفقير:
استيقظوا مبكِّرين بحسب ما اتفقوا:
﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22)﴾
هيا قوموا إلى جني المحاصيل، وبيع الثمار، ومنع حق الفقير.
﴿ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23)﴾
ما أرادوا أن يُشعِروا أحداً أنهم سيقطفون الثمار اليوم، لأن الفقراء من عادتهم أن يأتوا إلى البستان ليأخذوا حقَّهم، أرادوا أن يقطفوا الثمار في وقتٍ مبكرٍ جداً.
﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24)﴾
هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟
نقف هنا قليلاً لندخل موضوعاً في العقيدة مهمٌّ جداً، الإنسان مسير ومخير، حينما خلقك الله عزَّ وجل من أبٍ وأمّ، وفي بلدٍ معين، وزمنٍ معين، وبيئةٍ معينة، وإمكاناتٍ معينة، وخصائص وقدرات، وشكل وطول ولون...إلخ، هذه القدرات التي أودعها الله فيك نوعٌ من التسيير، هي قطعاً لصالحك، فلما بلغ الإنسان رشده كلَّفه الله؛ كلفه الله أمره ونهاه، افعل ولا تفعل، أمره أن يصلي، أمره أن يصوم، أمره أن يحج، أمره أن يضبط جوارحه، أن يغضَّ بصره عن محارم الله، وأن يصون سمعه عن الذي لا يرضي الله، ثم أمره أن يُقيم شرع الله في بيته وفي عمله.. إلخ، الإنسان مكلَّف، والإنسان مخير، مكلَّفٌ ومخيرٌ فيما كُلُف، إما أن يستقيم وإما أن ينحرف، إما أن يستجيب وإما أن يتبع الهوى، إما أن يُحسِن وإما أن يُسيء، إما أن يصدُق وإما أن يكذب، إما أن ينصف وإما أن يجحد، مخير، الإنسان اختار شيئاً من هذين الشيئين، اختار الانحراف، الله جلَّ جلاله ماذا يفعل به؟ يدعه إلى أن يموت؟ يموت إلى جهنّم، ورب العالمين ماذا يفعل به؟ الآن يسيّره إلى دفع ثمن اختياره تربيةً وتعليماً.
لو أن إنساناً مخيَّراً خُيّر فيما كُلِّف فاختار الاستقامة، الآن يسيّره توفيقاً، وفقه، يحفظه، يرعاه، يصونه، يؤيده، لو أنه اختار المعصية يسوق له من الشدائد ولو كان ذكياً، لأن الذكاء لا ينفع مع الله أبداً، يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع ذا الجد يا رب منك الجد، إذا أراد ربُّك إنفاذ أمرٍ أخذ من كل ذي لبّ لُبَّه، فالإنسان مخير فيما كُلِّف، فإذا اختار شيئاً طاعة أو معصية، صدقاً أو كذباً، إحساناً أو إساءة، استقامة أو انحرافاً، إنصافاً أو جحوداً، إذا اختار شيئاً من هذين الشيئين تقتضي حكمة الله ورحمته وتربيته لنا أن يكافئ المحسن، وأن يعاقب المسيء، الآن سيّره إلى دفْع ثمن اختياره، فالمستقيم يُسَيَّر ليكافئه الله، يلهمه الصواب، يلهمه هذه الصفقة يربح بها، يلهمه هذا العمل يسعد به، والمنحرف يُسَيَّر لدفع ثمن اختياره السّيئ، فالإنسان إذا كُلِّف واختار الشيء السيئ عنده تسيير لتربيته، وهذا الذي حصل:
﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24)﴾
تلف المحاصيل وإحراقها بعد تصميم أصحابها على منع حقّ المساكين والفقراء:
﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26)﴾
الحَرْد: هو المَنْع، أي اعتقدوا أنهم قادرون على منع حقّ المساكين والفقراء، ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ صُعِقوا، أين الثمار؟ أو أين الأشجار؟ هذا ليس بستانهم، سلكوا له طريقاً خطأً، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴾ ليس هذا هو البستان، أخطأنا في الطريق، البستان مُثْقَل بالثمار، المحاصيل طيّبة، والأسعار غالية، والثروة مقبلة، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴾ ثم اكتشفوا أن هذا هو بستانهم، وأن الطريق هيَ هي، وأن المحاصيل قد تلفت، وأن الثمار قد أُحرِقَت، أو أن الأشجار قد اقتُلِعَت على رأي بعض المفسرين.
التسيير الإلهي لدفع ثمن الاختيار:
﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27)﴾
هذا هو التأديب الإلهي، هذه هي التربية الإلهية، هذا هو التسيير الإلهي لدفع ثمن الاختيار، لو أن الله سبحانه وتعالى أَخَّر الثواب والعقاب إلى يوم القيامة لهلك معظم الناس، ولكن رحمة الله جلَّ جلاله اقتضت أن يُتابَع الإنسان، إن اختار اختياراً سيئاً أدَّبه في الدنيا، قال تعالى:
﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)﴾
أليس من الممكن أن يظَهَر الفساد دون أن يذيق الله الناس بعض ما كسبوا؟ أليس من الممكن أن تكون الإباحية على أُشدِّها في العالم الغربي دون أن يظهر مرض الإيدز؟ ممكن، لو أن الله لم يخلق هذا الفيروس أصلاً، والإباحية على قدمٍ وساق، والناس غارقون في ملذَّاتهم إلى أن يأتيهم الأجل إلى جهنَّم وبئس المصير، لكن تربية الله تقتضي خلاف ذلك، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لماذا يُذيقهم بعض الذي عملوا؟ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تصوّر لو أن صاحب مؤسسة أعلن عن حاجته إلى وظيفة، جاء موظَّف وبيّن له أنه هناك عدة أشهر للتدريب، إما أن نقبلك وإما أن نرفضك، وهذا المدير العام كلَّما أخطأ هذا الموظَّف المدرَّب سجَّل عليه خطأه، فلما تراكمت أخطاؤه فصله واستغنى عن خدماته، هذا أسلوب.
الأسلوب الآخر كلَّما أخطأ حاسبه وبيّن له الصواب، فإذا بعد حين موظَّف متفوق أبقاه عنده، أيهما أرحم؟ وأيهما أَحْكَم؟ وأيهما أكمل؟ أن تحصي على الناس أخطاءهم ثم تهلكهم أم أن تربيهم يوماً بيوم وساعةً بساعة؟ هذا ما يفعله الله عزَّ وجل، إذا أحَبَّ الله عبده عجَّل له بالعقاب، إذا أحَب الله عبده ساق له بعض الشدائد، إذا أحبَّ الله عبده حاسبه حساباً عسيراً في الدنيا كي يرقى، كي يستقيم، هؤلاء يبدو أن الله يحبّهم لذلك أتلف مزروعاتهم حينما غفلوا عن حقّ الفقير، وهناك آلاف القصص.
حدَّثني صديق حسب في رمضان ما عنده من مال، فزكاة ماله مثلاً أحد عشر ألفاً وخمسمئة وستون ليرة، دخل في خصامٍ مع زوجته، من دون دفع زكاة هذه السنة، ندهن البيت، ضغطت عليه إلى أن استجاب لها وألغى دفع الزكاة، قال: عندي مركبة أُصيبت بحادث، أخذتها للتصليح، مجموع الفاتورة الكاملة أحد عشر ألفاً وخمسمئة وستون ليرة، هذه تربية إلهية، فكل إنسان يمتنع عن تطبيق الشريعة أو عن أداء الزكاة يؤدّبه الله بإتلاف، أحياناً يتلف له بقدر الزكاة، أحياناً الضعف، أحياناً أربعة أضعاف، بحسب الحكمة، فهناك آلاف القصص، هذه قصَّة متكررة لكنها نموذجية، تشكل نموذجاً بشرياً، إنسان ضنَّ بماله عن أن يزكِّي، إنسان آثر المال على تأدية حقّ الله له.
العودة إلى الحق فضيلة من الفضائل:
﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28)﴾
أي أقربهم إلى الله.
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143)﴾
وسطاً أي وسطاء بيني وبين عبادي، هؤلاء إخوة أقربهم إلى الله: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ معنى ذلك أنه عارضهم حينما اجتمعوا، وقرروا، واتفقوا عارضهم فلماذا أَتْلَفَ الله حصَّته معهم؟ لأنه في النهاية سايرهم، هو عارضهم فضغطوا عليه فاستجاب لهم فشمله عقاب الله عزَّ وجل، ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ إذاً لا يكفي أن تقول ثم أن ترضخ، يجب عليك أن تقول وأن تفعل، لا أن تقول وترضخ، أحياناً يقول لك شريك: شريكي لم يدفع الزكاة وقد أقنعته كثيراً ولم يرض، لكنك ستأكلها معه، لابدَّ من أن يصيبك ما يصيبه، أما إذا كنت صادقاً فقل: لابدَّ من دفع الزكاة، أنا سأدفع زكاة نصيبي وأنت لك الاختيار، أما اعترضت اعتراضاً لطيفاً جداً الضغط شديد استجبت: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ أي لو سَبَّحْتُم الله، نزَّهتموه عن الشرك، أنتم ظننتم أنكم قادرون على استيفاء ثمن محاصيلكم وثماركم ووضعها في جيوبكم، والله عزَّ وجل لا علاقة له بذلك، أنتم أشركتم، أنتم بهذا العمل لم تنزِّهوا الله عزَّ وجل عن الشريك، بيده كل شيء، محاصيلكم بيده، إذاً: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ أي لو نزَّهتم الله عن الشريك ولم تشركوا أنفسكم معه في أنكم سوف تفعلون ما تفعلون والله سبحانه وتعالى لا يعلم أو لا يفعل شيئاً:
﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29)﴾
اعترفوا بذنبهم، وهذه نعمةٌ كُبرى، نعمةٌ كُبرى أن تعترف بخطئك، نعمةٌ كُبرى أن تسترجع، نعمةٌ كُبرى أن تحاسب نفسك، نعمةٌ كُبرى أن تعود إلى الحق، العودة إلى الحق فضيلة من الفضائل.
من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر:
﴿ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30)﴾
الحق عليك، لا، الحق عليك، بدؤوا يتراشقون التهَمْ، أنت لم تصر عليّ، وأنت كذلك اتخذت موقفاً قاسياً:
﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31)﴾
طغينا، تجاوزنا الحد المعقول، ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31)﴾ .
لذلك أيها الإخوة؛ مرَّة ثانية من نعم الله الكبرى أنه إذا جاءت مصيبة وعرفت سرَّها وعُدَّتَ إلى الله فهذه نعمةٌ كبرى: ﴿يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر.
الشدائد التي يسوقها الله لعباده إنما هي لتقريبهم إليه:
﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32)﴾
سَمِعَتْ أم سلمة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه ينبغي على المؤمن إذا أصيب إنسان بمصيبة ينبغي أن يقول ويدعو:
(( عن أم سلمة أم المؤمنين: ما مِن مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ ما أمَرَهُ اللَّهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لي خَيْرًا مِنْها ، إلَّا أخْلَفَ اللَّهُ له خَيْرًا مِنْها، قالَتْ: فَلَمَّا ماتَ أبو سَلَمَةَ، قُلتُ: أيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِن أبِي سَلَمَةَ؟ أوَّلُ بَيْتٍ هاجَرَ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ إنِّي قُلتُها، فأخْلَفَ اللَّهُ لي رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَتْ: أرْسَلَ إلَيَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حاطِبَ بنَ أبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي له، فَقُلتُ: إنَّ لي بنْتًا، وأنا غَيُورٌ، فقالَ: أمَّا ابْنَتُها فَنَدْعُو اللَّهَ أنْ يُغْنِيَها عَنْها، وأَدْعُو اللَّهَ أنْ يَذْهَبَ بالغَيْرَةِ. ))
عندها زوج توفي، أبو سلمة، لا تعلم أن في الرجال من هو أفضل منه؛ رجولةً، و مروءةً، وكرماً، وشهامةً، وطاعةً، وتفوقاً، وعلماً، حينما بدأت تدعو كما علَّمها النبي قالت: غير معقول ليس هناك أفضل منه، ثم فوجئت أن رسول الله قد خطبها لنفسه، لذلك: ﴿عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا﴾ أي إذا جاءت مصيبة لا سمح الله وأتلفت المال واستفدت منها، أنت الرابح الأكبر، المال يُعوّض، ما ضاعت عَبرةٌ كانت لصاحبها عِبْرَة، لو ذهب نصف مالك وحملك هذا على طاعة الله أنت الرابح الأكبر، لو فقدت أثمن شيءٍ تملكه وحملك هذا الفقد على طاعة الله أنت الرابح الأكبر، لو فقدت وظيفتك العالية، ومِلْتَ إلى الله وطاعته وطلب العلم أنت الرابح الأكبر، أي شيءٍ يضيع منك إذا كان سبب هداك إلى الله أو سبب معرفتك بالله أنت الرابح الأكبر، المحاصيل تلفت لكنهم عادوا إلى الله وعادوا إلى طاعته.
أنا أعرف رجلاً كان الدِّين خارج حساباته، يعيش لدنياه، اتهم بشيء هو بريء منه، فسيقت له شدة هي قاسية جداً، فحملته هذه الشدة على التوبة، وأداء الصلوات، وطاعة الله، هل هو رابحٌ أم خاسر؟ الرابح الأكبر، ﴿عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ تَلَفُ هذه المحاصيل جعلهم يرغبون إلى الله، تَلَفُ هذه المحاصيل جعلهم يعترفون أنهم طَغَوا وبَغَوا، تَلَفُ هذه المحاصيل جعلهم يعترفون أنهم ظلموا أنفسهم، ﴿إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ كل هذه القصة مطويةٌ بكلمتين هي حكمتها، ومحورها، ومغزاها:
﴿ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33)﴾
أي يا عبادي كل أنواع العذاب الذي أسوقه لكم في الدنيا؛ عذاب نفسي همّ، خوف، نقصٌ في الأموال، نقص في الأنفس، نقص في الثمرات، موت الأقارب، تلف المال، الأمراض بشتَّى أنواعها حتى العُضال منها كل أنواع الشدائد التي أسوقها لعبادي على هذه الشاكلة كي أُقَرِّبَهُم، كي أنقلهم إلى الهدى، إلى الطاعة، إلى التوبة، إلى الإقبال على الله، إلى الرغبة فيما عند الله، ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ فهناك خياران هناك عذابٌ أكبر يوم القيامة في جهنم، وهناك عذابٌ أصغر في الدنيا، قال تعالى:
﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)﴾
تأديب الناس ومعالجتهم من قِبل الله لأنه يحبهم:
هذه القصة تصوِّرُ كل أنواع المصائب على اختلافها التي يسوقها الله للناس في الدنيا من أجل أن يقولوا: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ من أجل أن يقولوا: ﴿إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ﴾ من أجل أن يقولوا: ﴿يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ فالإنسان يجب أن يعلم علم اليقين إذا كان هناك انحراف، هناك تقصير، هناك عدوان، هناك أكل مال حرام، يجب أن يعلم علم اليقين أن علاجاً سينتظره، وأن تأديباً من الله ينتظره، وأن الله لن يدعه هكذا لأنه يحبّه، وقد قال الله عزَّ وجل:
﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)﴾
فهذه القصَّة مفتاحها، مغزاها، كلمة سرَّها إن صحَّ التعبير: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ هذا هو العذاب، شرّ للشر لا وجود له، شرّ للشر يتناقض مع وجود الله أبداً، إما أن تؤمن بوجود الله، وإما أن تؤمن بالشر للشر، شرّ للخير يبدو لك شراً:
﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)﴾
أعرف رجلاً متعلقاً بابنته الجميلة تعلقاً لا حدود له، وهو متفلّت، أُصيبت هذه الفتاة بمرضٍ خبيث، جعل الأب والأم ينفقان كل ما يملكان، اضطرا لبيع بيتهما، ثم خطر في بالهما خاطر، لو أننا تبنا إلى الله لعل الله يشفيها لنا، فتابا إلى الله، والتزما أمره ونهيه وبعد حين شُفيت من مرضها، المرض المخيف كأنه ضيف أتى دفعهما إلى طاعة الله ثم انسحب، ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ هكذا العذاب، يجب أن تعلم علم اليقين ما الذي يحصل، آلاف الحوادث؛ إنسان يصاب بمرض عُضال، إنسان يفتقر فجأةً، إنسان يُعذَّب، أنت لا تعلم إلا الفصل الأخير، أما الفصول السابقة فلا نعرفها أنت، لكن يجب أن تعلم أنه ما من نتيجةٍ إلا متطابقة مع المقدمات تطابقاً رائعاً، لكن ما كل شيء تعلمه أنت، يجب أن نستسلم، ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ قس عليه كل شيء، كل أنواع الشدائد المادية، والمعنوية.
﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)﴾
إخواننا الكرام؛ مِفْتَاح هذه القصَّة في كلمة: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ أي كل أنواع العذاب التي أسوقها لعبادي من هذا النوع، على هذه الشاكلة، لماذا أسوقها لهم؟ قال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ممكن أب أن يوافق على قطع يد ابنه؟ طبعاً إذا كان هناك مرض الغرغرين، اليوم من هنا، ثاني يوم من هنا، ثالث يوم من هنا، فالإنسان العادي إذا أيقن أن هناك خطراً متفاقماً يوقفه عند حده، فربنا عزَّ وجل يسوق الشدائد، لكن لماذا يسوقها؟ لئلا يذوق صاحبها نار جهنم، هو ملخص الآية أو القصة:
﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)﴾
﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ في الدنيا لأنه: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ .
الملف مدقق