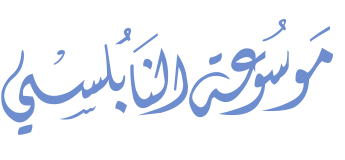الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الكرام؛ مع الدرس الواحد والستين من دروس مدارج السالكين، في منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ومنزلة اليوم الورع، الله جلَّ جلاله يقول:
﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51)﴾
هذه الآية أصلٌ في الورع، ورد في الأثر أن ركعتين من ورِع خيرٌ من ألف ركعة من مخلِّط، والمُخلِّط الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً، لأن العمل الصالح قيمته الكُبرى أنه يعينك على الاتصال بالله، فإذا رافق هذا العمل الصالح عملٌ سيئ كان دور العمل السيئ مثبطاً وقاطعاً وحجاباً، فالأعمال الصالحة مع الأعمال السيئة المؤدى في قطيعة، إلا أن هذه الأعمال لها عند الله جزاء، لكن لا يستطيع المرء أن يستغلَّها أو أن يعتمد عليها في الاتصال بالله، لأن العمل السيئ خالطها فعطَّل قيمتها الإقباليَّة إن صحَّ التعبير.
﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ آية أصلٌ في الورَع:
هناك آيةٌ أخرى هي أصلٌ في الورع قال تعالى:
﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)﴾
قال مجاهد: طهِّر نفسك من الذنب ، فكنَّى عن النفس بالثوب.
وقال ابن عبَّاس: لا تلبسها على معصيةٍ، ولا على غدر ، لا تلبس ثيابك على معصيةٍ، ولا على غدر.
وقال الضحَّاك: عملك فأصلح ، لأن عملك ثوبٌ لك.
الإنسان يرتدي ثوباً من عمله؛ فلان مخلص، فلان غدَّار، فلان صالح، فلان ورع، فلان تقي، فلان كاذب، فلان صادق، سلوكه العام يجعله يرتدي ثوباً من عمله، فقال الضحَّاك: عملك فأصلح.
والعرب تقول للرجل إذا كان صالحاً إنه طاهر الثياب، وإذا كان فاجراً إنه خبيث الثياب.
وقال سعيد بن جُبير: وقلبك وبيتك فطهِّر .
وقال الإمام الحسن: وخُلُقك فطهِّر ؛ فهذه الآية: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ أصلٌ في الورع، إلا أن المعنى الظاهري المادي يمكن أن يكون وارداً، فالله عزَّ وجل أمَرَ بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز فيها الصلاة، لأن المشركين كانوا لا يتطهَّرون، ولا يُطَهِّرون ثيابهم، وقال بعض العلماء: وثيابك فطهر أي وثيابك فقصِّر، لأن تقصير الثياب طهرةٌ لها.
من الورَع تطهير القلب من الدنس:
أيها الإخوة؛ المقصود من الورَع أن يُطهَّر القلب من الدنس كما يُطهِّر الماء دنس الثوب، والشيء الغريب أن بين الثياب والقلوب مناسبةً ظاهرة، فالثياب تدل على قلب الإنسان وحاله، كما قلت قبل قليل: الإنسان يرتدي ثوباً من عمله، فإخلاصه هو ثوب، وغشُّه ثوب، تواضعه ثوب، كِبْره ثوب، فلأن الإنسان يرتدي ثوباً من عمله كانت هناك مناسبةٌ بين القلب وبين الثياب، فالمقصود بالورع تطهير القلب من الدنس.
الكلمة التي جمع النبي فيها الورَع كله:
النبي عليه الصلاة والسلام جمع الورع كلَّه في كلمةٍ واحدة:
(( عن علي بن الحسين بن علي: مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ. ))
[ الترمذي في سننه: مرسل ]
المؤمن مشغول، له هدفٌ كبير، ليس في وقته متسعٌ للسفاسف، هدفه أكبر من وقته، وهذه حقيقة، وهي أنك حينما تختار هدفاً كبيراً أنت أسعد الناس، لأن هذا الهدف الكبير يأخذ كل وقتك، فلا تجد وقتاً لسفاسف الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام:
(( عن الحسين بن علي بن أبي طالب: إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ مَعاليَ الأُمورِ، وأَشرافَها، ويَكرَهُ سَفْسافَها. ))
[ صحيح الجامع : خلاصة حكم المحدث : صحيح ]
((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ)) قال: هذا الترك يعمُّ الكلام، ترك الكلام الذي لا يعنيك، وترك النظر الذي لا يعنيك، إياكم وفضول النظر فإنه يبذر في النفس الهوى، وترك الاستماع الذي لا يعنيك، التنصُّت على الآخرين، تقصّي أخبار الآخرين، هذا لا يعنيك،
((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ)) ترك الكلام وترك النظر وترك الاستماع، والإنسان حينما يعلم ويوقن أن كلامه جزءٌ من عمله يكون ورعاً، العوام يتوهَّمون أنه كلام بكلام، ما فعلنا شيئاً تكلَّمنا، وغاب عنهم:
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ». ))
وكم من كلمةٍ فرَّقت بين زوجين؟! وكم من كلمةٍ فرَّقت بين شريكين؟! وكم من كلمةٍ فرَّقت بين أم وابنها؟! وبين أخٍ وأخيه؟! فالكلمة الطيبة صدقة:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24)﴾
أي التعريف بالله عزَّ وجل:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25)﴾
فمِلاك الورع كلِّه ترك المرء ما لا يعنيه من الكلام، والنظر، والاستماع، والبَطش، والمشي، والفكر، الحقيقة الإنسان الذي ليس له هدف إنسان ضائع، كل شيء يشغله، يبحث عن كل شيء، يتقصَّى كل شيء، يهتم بكل شيء، يقف أمام المناظر يتأمَّلها، أمام الرجال يتفحَّصهم، أمام الحاجات يُقلِّبها لأنه فارغ، أما حينما يكون لك هدفٌ كبير، الهدف الكبير هو الذي يسمو بك، ويجعلك إنساناً عند الله كبيراً، ومرَّة ثانية: ((إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيَّها)) فلذلك: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ)) هذا في الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمشي، والفكر.
من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كلمةٌ كافيةٌ شافيةٌ في الورع:
الحقيقة أنت دقِّق بطالب يؤدي امتحاناً في الجامعة، لا يأتيه ولا خاطر في ثلاث ساعات لا علاقة له بالسؤال أبداً، موضوع طعامه، وشرابه، وبيته، وأصدقائه، وعلاقاته، ومشكلاته، وطموحاته، ورغباته كلها مجمَّدة، لأنه أمام ثلاث ساعات مصيريَّة، كل جهده متعلِّق بمادة السؤال، والمعلومات التي يمكن أن تكون إجابةً لهذا السؤال، الحقيقة الإنسان حينما يُشغَل بالله عزَّ وجل صار عنده اصطفاء، إنسان عنده فحص بعد أيام، دخل إلى مكتبة فيها آلاف الكُتب، يأخذ الكتاب المقرَّر، يصطفي، وهذا الشيء ملاحظ عند بعض المؤمنين، يقتني مجلَّة فيها مقالة تهمه؛ مقالة علميَّة، مقالة دينيَّة، أما هناك قصَّة، هناك موضوع تاريخي لا يعنيه إطلاقاً، هناك قضيَّة معلَّقة ببلد بعيد، بفنَّان مثلاً، بشاعر، فنفسه تعزف عن موضوعات لا تعنيه، أنت مع مجلَّة تصطفي منها ما يهمُّك وما يعينك على أداء رسالتك في الحياة، ((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ)) من الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كما قال العلماء عنها: كلمةٌ كافيةٌ شافيةٌ في الورع.
الورع أول باب من أبواب الزهد:
قال بعض العلماء: الورع في المنطق أشدّ منه في الذهب والفضَّة، والزهد في الرياسة أشدّ منه في الذهب والفضَّة، لأنهما يُبذلان في طلب الرياسة، الورع ثمين جداً، والزهد أثمن، وحينما تكون ورعاً وزاهداً فأنت على أول الطريق الصحيح.
أيها الإخوة؛ كما قال بعض العلماء: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا، الورع أول الزهد، حينما تتورَّع فأنت زاهد، ما معنى زاهد؟ أي أنت زاهد في الدنيا الفانية، لكنَّك طموح ومتعلِّق بالآخرة الباقية.
الآن يوجد مجموعة تعاريف للورع، الورع: الوقوف على حدّ العلم من غير تأويل، الملاحظ عند معظم المثقَّفين الذين لم يرتقِ إيمانهم إلى المستوى المقبول يتساءلون: لماذا حُرِّم كذا؟ يناقش التحريم، ويحاول أن يبحث عن علة التحريم، ثم يقول: هذه العلَّة غير موجودة الآن، لماذا حرَّم الله الربا؟ لأنه لم يكن في الجاهليَّة إلا قرض استهلاكي، فيأتي المرابي فيستغل حاجة الفقير إلى المال، فيأخذ منه أضعافاً مضاعفة، يقول لك بعض المثقَّفين: الآن هناك قرض استثماري، أي شركة تحتاج إلى أن تضيف لمعملها خطاً، تريد أن تتوسَّع، فتأخذ قرضاً ربوياً بنية التوسُّع لا بنية سدّ الحاجة، فهذا القرض لا علاقة له بالربا، وإن كان فيه فائدة ربويَّة، هنا يقول أحد العلماء: الورع الوقوف على حدّ العلم من غير تأويل.
لكن علماء الأصول حلوا هذه المشكلة، حينما يأتي التحريم مع علَّته فالتحريم يدور مع العلَّة وجوداً وعدماً، أما حينما يأتي التحريم مطلقاً، فلذلك لا يمكن أن تُعلِّل هذا التحريم، ولا أن تبحث في العلل التي اخترعتها أنت وهي موجودة أو غير موجودة، مثلاً يقول لك: ألا لا تسافرن امرأةٌ إلا مع ذي محرم، كان ذلك أيام السفر الطويل جداً على الجِمال، أما الآن يوجد طائرات، هذا التحليل من أجل إلغاء الحُكم، وحينما يأتي التحريم من قِبل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى، حينما يأتي التحريم خالياً من العلَّة، فلذلك لا ينبغي أن نضع عللاً وهمية، وأن نبحث في وجودها أو عدمها، أما حينما يأتي التحريم مع العلَّة فالأمر يختلف، لذلك قال بعض العلماء: الورع الوقوف على حدّ العلم من غير تاويل.
وقال بعضهم: الورع على وجهين؛ ورعٌ في الظاهر وورعٌ في الباطن، فورع الظاهر ألا يتحرَّك إلا لله، والمؤمن الصادق حركته، ذهابه، إيابه، دخوله، خروجه، صلته، قطيعته، عطاؤه، منعه، كل شيءٍ يفعله لله، قال تعالى:
﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)﴾
فورع الظاهر ألا يتحرَّك إلا لله، وورع الباطن هو ألا تُدخِل قلبك سوى الله، القلب له ورع، والجوارح لها ورع، الجوارح ألا تتحرَّك إلا لله، والإنسان أعلم بنيَّته:
﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15)﴾
وقال بعض العلماء: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء، أي كلما كنت دقيقاً في سلوكك، كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لم يقف في ظلّ بيتٍ مرهونٍ عنده، لئلا ينتفع بظلِّه، طبعاً هذا من باب الورع، أما ليس من الفتوى في شيء، أما الورع أن تدع ما لا بأس به حَذَراً مما به بأس.
ويا أيها الإخوة الكرام؛ هذا الموضوع عالجته البارحة بشكل مختصر، لأن الحلال بيِّن، لا أحد يسأل عن الحلال لأنه واضح، والحرام بيِّن، لا أحد يسأل عنه، لكن كل الأسئلة تنصبّ على الشبهات، ومعنى الشبهات تشبه الحلال من جهة والحرام من جهة، الورع ترك الشبهات استبراءً للدين والعِرْض، لذلك قيل: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء، والإنسان ممتحن:
﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)﴾
سيدنا عمر بن عبد العزيز كما يُروى إذا أراد أن يتكلَّم مع أهله هناك سراجٌ خاصٌ لأهله، فإذا أراد أن يحلّ شؤون الخلافة هناك سراجٌ خاصٌ لشؤون الخلافة. والإنسان يظهر ورعه من تعامله: قال له: هل تعرفه؟ قال: نعم، قال: هل سافرت معه؟ قال: لا، قال: هل جاورته؟ قال: لا، قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا، قال: أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه.
وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات.
رضوان الله ومحبته شعور لا يعرفه إلا من ذاقه:
بالمناسبة الله عزَّ وجل رحيم، الله عزَّ وجل كريم، ما حرمك، أية شهوةٍ أودعها فيك جعل لها قناةً نظيفةً تسري خلالها، فلذلك الشهوات لها قنوات نظيفة، مرة لي زميل بالعمل صارحني قال لي: والله كانت لي جاهليَّةٌ كبيرة، ثم تبت إلى الله عزَّ وجل، واصطلحت معه، وتزوَّجت، قال لي: يا سبحان الله! ساعةٌ مع الزوجة تعدل آلاف البغايا، أي يوجد طهر، يوجد طمأنينة، يوجد سرور، يوجد حب، يوجد إخلاص، يوجد وفاء، يوجد ثمرة لهذا الحب، يوجد ولد، أي ساعةٌ مع زوجةٍ مخلصةٍ تعدل آلاف التجارب التي مرَّ بها.
صدِّق أيها الأخ الكريم أن المؤمن حينما يأتمر بما أمر الله، وينتهي عما نهى الله عنه في أعلى درجة من السعادة، وأية سعادةٍ أكبر من أن تشعر أن الله يحبك، وأنك في رضوان الله، هذا شعور لا يعرفه إلا من ذاقه، أي أنت في حركتك، وسكنتك، وزواجك، وعملك، ورحلتك، وإقامتك، وابتسامتك، وزياراتك، ولقاءاتك، ونشاطاتك كلها تبتغي رضوان الله، رضوان الله واسع جداً، أحياناً أنت عندما تتقن عملك هذا يُرضي الله عزَّ وجل، إذا أدخلت على قلب أهلك السرور هذا يرضيهم، فأنت دائماً تبحث عن رضوان الله عزَّ وجل.
قيل: الورع الخروج من كل شهوة، طبعاً الشهوة محرَّمة، وترك كل سيئة، والورع الخروج من كل شُبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين، ومن كان حساب نفسه حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً، ومن حاسب نفسه حساباً يسيراً في الدنيا كان حسابه يوم القيامة حساباً عسيراً.
وخوفان وأمنان لا يجتمعان؛ من خاف الله في الدنيا أمَّنه يوم القيامة، ومن أمِنه في الدنيا أخافه يوم القيامة، ذكرت اليوم في درس الظهر أن الإنسان عندما يتحرَّك حركة حرَّة من غير منهج الله يفقد حريَّته، لو إنسان سرق أو قتل انتهت حريته، وحينما ينضبط يكون حراً، على المستوى المدني، مواطن يتقيد بالقوانين والأنظمة، مواطن صالح، يسافر إلى أي مكان، يغادر القطر إلى أي مكان، ليس عليه إذاعة بحث، حر، حريَّته جاءت من تقيُّده، تتقيَّد تكون حراً، تتفلَّت تكون بقيد، وأجمل آية:
﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)﴾
على تفيد العلو، الهدى رفعهم، قال تعالى:
﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22)﴾
الضلال شيء ضمن شيء، في، في تفيد الظرفيَّة، فالإنسان الضال إما في كآبة وإما في سجن، والإنسان المؤمن المستقيم كلَّما ازداد إيماناً ازداد عزَّاً وازداد رفعةً.
الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات، والورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين، سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاكَ في نفسك فاتركه، شيء شوَّشك اتركه،
(( عن سالم عن أبيه مرفوعاً: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. ))
[ رواه أبو نعيم عن ابن عمر مرفوعاً ]
في الدين قضايا يوجد معها أدلَّة ضعيفة، وهناك أدلَّة تحرِّمها، وأدلَّة تجيزها، فالشيء المريح دعها، هذا سمَّاه العلماء الفقهاء: الخروج من الخلاف وسلوك الأحوط، الورِع يسلك السلوك الأحوط ويخرج من الخلاف، ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه، وكما قال عليه الصلاة والسلام:
(( عن وابصة رضي الله عنه: يا وابصة، البِر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاكَ في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ))
[ صحيح الترغيب: حسن لغيره ]
ذكاء الإنسان وبطولته في خوفه من الله عزَّ وجل:
ذكرت لكم مرَّة أن أخاً من إخواننا، كان يعمل في تجارة الأبنية، كان يبني البيوت ويبيعها، قال لي: وجدت محضراً في منطقة مهمة جداً، في مركز استراتيجي في المدينة، وتمكَّنت مع عدة أصدقاء أن ندخـل المزاودة بشكل تمثيلي، أي أربعة خمسة أطراف يرفعون السعر قليلاً، فاستقرَّت هذا المحضر على ثمنٍ يعدل ثُلُثي ثمنه الحقيقي، طبعاً أصحاب هذا المحضر مئات من الناس وفيهم أيتام، قال لي: بعد أن استقر على سعرٍ مغرٍ جداً، ورسا عليّ، وشعرت بغبطةٍ شديدة، ثم تذكَّرت القبر، لو أنني وُضِعت في القبر ماذا سأقول لله عزَّ وجل؟ كيف حرمت هؤلاء الأيتام حقَّهم من السعر الحقيقي؟ قال لي: والله خفت، قال لي: فما رأيك؟ قلت له: أنت أجبت نفسك؛ إما أن تعطي أصحاب هذه الأراضي الحق الكامل، وإما أن تنسحب من هذه المزاودة، ((البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك)) دائماً يسأل السائل وهو قلق، أينما ذهبت، حتى في بلاد الغرب، اشترى بيتاً بالتقسيط، هو مرتاح فيه، لكن عنده قلق عميق، يكون عملي حرام، لماذا يسأل؟ لأنه قَلِق، كل شيء فيه مخالفة النفس تخاف، وذكاء الإنسان وبطولته في خوفه من الله عزَّ وجل، كلَّما ازددت خوفاً منه أمَّنك .
قال بعض العلماء: الحلال هو الذي لا يُعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا يُنسى الله فيه، الحلال الذي لا يُعصى الله في كسبه، أي كل شيء فيه ورع، وفيه استقامة فهو حلال، والصافي منه الذي لا يُنسى الله فيه، هناك أشياء مباحة إذا استغرقت فيها نسيت الله عزَّ وجل، هذا معنى ما ورد: لا تبلغ مرتبة المتقين حتى تدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس.
هناك أشياء مباحة لو أخذتها وتعمَّقت فيها ربَّما أبعدتك عن الله عزَّ وجل، لذلك قلت لكم سابقاً: إن الشيطان ذكي جداً، أول شيء: يأمر الإنسان بالكُفر، فإن لم يستطع أن يحمل هذا الإنسان على الكفر يأمره بالشرك، فإن رآه موحِّداً يأمره أن يبتدع، فإن رآه على السنة يأمره أن يفعل الكبائر، فإن لم يستطع أن يحمله على ذلك يأمره بفعل الصغائر، فإن لم يستطع يأمره بفعل الشُبهات، فإن لم يستطع يأمره بالمباحات، يغرق في الدنيا إلى درجة أنه ينسى الله فيها، فإن لم يستطع، ماذا بقي؟ بالتحريش بين المؤمنين، يدخل بعيّ مع المؤمنين، الكفر فالشرك فالابتداع فالكبائر فالضغائر فالمباحات فالتحريش بين المؤمنين بشكل تسلسلي، فالحلال الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا يُنسى الله فيه.
سأل الحسن غلاماً فقال له: ما مِلاك الدين؟ قال: الورع، قال: فما آفته؟ قال: الطمع، فعجب الحسن منه، مرَّة قرأت أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى رأى غلاماً أمامه حفرة، قال: إياك يا غلام أن تسقط، كان هذا الغلام فطِناً، فقال: بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالَم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد.
وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس، هذا قول لبعض السلف.
كيفية محافظة الإنسان على الاتصال بالله عز وجل:
أيها الإخوة؛ الآن يوجد الورع موضوع دقيق، قال صاحب المنازل، مدارج السالكين في منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين: الورع: توقٍّ مستقص على حذر، وتحرُّج على تعظيم؛ أي أن يتوَّقى الحرام والشُّبَه، وما يخاف أن يضرَّه أقصى ما يمكنه من التوقي.
الحقيقة أن الإنسان حينما يصل إلى الله عزَّ وجل، ويصطلح معه، ويتصل به، يشعر بسعادةٍ كبيرة، وكل واحد من إخواننا الكرام عندما يتألَّق مع الله عزَّ وجل، أكبر دعاء له: يا رب أدِم هذا الحال، يا رب أدِم هذا الفضل، أدِم هذا الاتصال، أجمل شيء بالحياة الاتصال، أصعب شيء الانفصال.
أحبّ رجل فتاة، فاشترط عليه أبوها أن يحضر دروسه، فحضر الدروس فنسي الفتاة، قالت له مرَّةً: أين الوعد بالزواج؟ فقال: يا وصال كنتِ سبب الاتصال.
الإنسان أحياناً يتصل بالله عزَّ وجل، هذه الصلة هي الدين كله، هي كل السعادة فيها، فالذي وصل إلى ثمار الاتصال كيف يُحافظ على هذا الاتصال؟ بالورع يحافظ عليه، أما حينما يتساهل أي تساهل حجبه عن الله عزَّ وجل.
الحجاب أكبر عقاب من الله للعبد:
القصَّة التي أرويها لكم كثيراً أن شاباً سمع من شيخه أن لكل سيئةٍ عقاباً، زلَّت قدمه في سيئة، فتوقَّع أن يُعَاقبه الله عقاباً شديداً، انتظر؛ صحَّته سليمة، أولاده، مركبته، تجارته، لا يوجد شيء، فناجى ربه قال: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال: فوقع في نفسه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدر، ألم أحرمك لذَّة مناجاتي؟ المؤمن له صلة بالله، له حال مع الله طيب، حينما يُخطئ يُحجب عن الله، هذا الحجاب أكبر عقاب، والحقيقة أكبر عقاب حقيقة الحجاب عن الله:
﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)﴾
التوقي والحذر متقاربان؛ التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب:
التوقي والحذر متقاربان، التوقي فعل الجوارح، والحذر فعل القلب؛ أي يُوَقّي جوارحه من المعصية، ويُوَقّي قلبه من الطمأنينة الساذجة، لكن هناك أشخاص وهذه نقطة مهمة جداً في الخندق الآخر، ليسوا بالدين، في خندقٍ معادٍ للدين، فيحافظوا على شيء من استقامتهم وكرمهم وعفَّتهم، حتى يثبتوا لأهل الدين أننا نحن الصح ولستم أنتم، فالإنسان حينما يكون كاملاً بنية أن يدحض الحق، هذا الكمال لا أجر له به، فقال: هناك من يُظهر نزاهةً، هناك من يُظهر عزة، هناك من يتوقَّى أن يفعل فاحشةً، هناك من يتوقَّى أن يفعل دناءةً تصوُّناً عنها، ورغبةً عن مواقعتها، وطلباً للمحمدة عند الناس، الإنسان يحبّ أن يكون كبيراً، فإذا ما اتّخذ الدين سبباً إلى علوِّه في نظر الناس قد يتخذ مواقف أخلاقية مصطنعة كي ينتزع إعجاب الناس، فقال: الورع هو التوقّي، توقّي الجوارح عن معصيةٍ أو شبهة، وحذر القلب أن يلتفت لغير الله.
وفي تعريف آخر: الورع تحرُّج عن تعظيم، أي أن الباعث على الورع عن المحارم والشُّبه حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب جلَّ جلاله، الإمام الحسن له كلمة: لا تنظر إلى صِغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت.
قال أحدهم لي كلمة، والله تأثَّرت لها، قال لي: كنت في بلاد الغرب، وهناك أجهزة لهو، وهناك مئات القنوات، وهناك مشاهد لا ترضي الله عزَّ وجل، قال لي بالحرف الواحد: والله أستحيي من الله عزَّ وجل أن أنظر، تعظيماً لله عزَّ وجل، كل واحد إذا زاره إنسان عظيم في بيته، قد يكون شخصاً مهماً، عالِماً جليلاً، لا يستطيع أن يقابله بلباس مبتذل، يستحي منه، لأنه يعرف قيمته، إذا الإنسان مع إنسان يرتدي أجمل ثيابه، يُنمِّق كلماته، في أول اللقاء الأول تجد أموراً كلها منمَّقة، مُرتَّبة، مضبوطة، هذا من باب الاستحياء، فإذا الإنسان يُعظِّم الله عزَّ وجل تكون خلوته كجلوته، وسريرته كعلانيَّته، وسرُّه كجهره، وإقامته كسفره، لذلك العلماء قالوا: الورع عن المعصية إما عن خوف من العقاب، وإما عن تعظيم لله عزَّ وجل، المرتبة الثانية أرقى.
1-صون النفس بتجنب القبائح:
الورع أيها الإخوة؛ يبعث على تجنُّب القبائح لصون النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الإيمان، فهذه ثلاث فوائد من فوائد تجنُّب القبائح، فصون النفس هو حفظها وحمايتها عما يَشينها ويَعيبها، ويزري بها عند الله عزَّ وجل، وعباده المؤمنين وسائر خلقه، لأنه من كرُمت عليه نفسه وكبُرت عنده صانها وحماها، وزكَّاها وعلّاها، ووضعها في أعلى محل.
هذا كلام دقيق؛ إذا الإنسان نفسه كريمة، لا يخالف قوانين السير، لماذا؟ حتى لا يقف موقفاً ضعيفاً، حتى لا يترجى، حتى لا يتذلَّل، يطبِّق الأنظمة حتى يبقى عزيزاً، إذا الإنسان نفسه كريمة يطيع الله عزَّ وجل حتى لا يؤدِّبه الله عزَّ وجل بمصيبة مهينة، لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.
الله عزَّ وجل عنده أدوية كثيرة، يوجد عنده عذاب مهين، يوجد عنده عذاب عظيم، عنده عذاب شديد، وله أدويــة لا تُعدّ ولا تحصى، والله عزَّ جل رحيم.
ولله المثل الأعلى؛ كيف أن الأب الطبيب، حينما يعلم أن الزائدة عند ابنه قد التهبت، قد يُجري له عملية بيده، قد يفتح بطنه بيده، وقد يقطع الشرايين، وقد يستأصل هذه الزائدة، وهو يعلم أن هذا ابنه، لكن لابدَّ من ذلك، فعندما الإنسان يستدعي أن يُعاقب يعاقبه الله، وقد يُهان بهذا العقاب، فالإنسان كلَّما كَرُمَت نفسه كلَّما أراد أن تبقى مصونة من كل سوء، من كل إهانة، من كل إحراج، يستقيم، لذلك المستقيم دائماً رافع الرأس، لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه:
﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26)﴾
ما هذه الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، معنى دقيق؛ من كَرُمت نفسه عليه صانها بالاستقامة.
تسمعون قصصاً كثيرة، أن فلاناً سرق ويُعذَّب فرضاً، هذا العذاب جزاءً وفاقاً، لكن لو كانت نفسه كريمة عليه مثلاً ما كان فعل شيئاً، حفاظاً على كرامته، وعلى سمعته، وعلى راحته، وعلى سلامة نفسه، وعلى مكانته، وعلى تألُّقه يستقيم، فالورع تخوُّف أو تعظيم.
أول شيء: صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينها، ويعيبها، ويزري بها عند الله عزَّ وجل وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرُمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها، وزكَّاها وعلَّاها، ووضعها في أعلى محل، وزاحم بها أهل العزائم والفضل، ومن هانت عليه نفسه، وصغُرت عنده، ألقاها في الرذائل، وحلَّ زمامها وأرخاه ودسَّاها ولم يصُنها عن قبيح، فأقلّ ما في تجنُّب القبائج صون النفس، تجد الإنسان يعيش سبعين سنة، يقول لك: ما دخلت إلى مخفر، ما دخلت لقصر العدل، ما أحد أقام عليّ دعوى، من استقامته، عزيز.
الشيء الثاني: توفير الحسنات، لأن السيئات تُعَطِّل فعل الحسنات، إن أردت أن تستفيد من الحسنات بالإقبال على الله فالسيئات إن اجتمعت مع الحسنات تُبطل مفعولها، فالسيئات قد تُحبِط الحسنات، وقد تستغرقها بالكليَّة أو تنقصها، فلابدَّ من أن تُضعِفها قطعاً، السيئات قد تستغرق الحسنات وقد تُضعِفها، فتجنُّبها يُوفِّر ديوان الحسنات، وذلك من فوائد الورع.
أما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
بالمناسبة: إذا الإيمان اعتقاد لا يزيد ولا ينقص، أما إذا الإيمان اتصال يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض، فالتصديق لا يتغيَّر، إيمانك أن الله موجود ثابت، لا يزيد ولا ينقص، ولكن الذي يزيد وينقص الإقبال والفتور والقطيعة، فالإيمان يزيد كإقبال بالحسنات ويَضعُف بالسيئات.
قال الإمام الشافعي: إضعاف المعاصي للإيمان أمرٌ معلومٌ بالذوق والوجود، فقد جاء في الحديث:
(( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ. ))
[ أخرجه الترمذي في سننه: حسن ]
﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)﴾
فالقبائح تُسَوِّد القلب، فالوَرِع يصون نفسه عن أن تُذلّ، ويحفظ حسناته من أن تُرَد، ويصون إيمانه من أن ينقص، هذا هو الورِع، قال تعالى:
﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)﴾
﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)﴾
قال: صيانة النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الإيمان أرفع باعثٍ على الورَع.
الآن هناك مراتب للورع، قال: يرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدي به إلى حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاءً على الصيانة والتقوى، وتخلُصاً من اقتحام الحدود، أي يدع الورِع دائماً بينه وبين الحد هامش أمان، الزنا له حد؛ الرجم أو الجلد، هامش الأمان غضّ البصر، دائماً الورِع بينه وبين الحدود هوامش أمان، وهذا يؤكِّده قوله تعالى:
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)﴾
قال: العارف يترك كثيراً من المباح إبقاءً على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بينه وبين الحرام، عندنا حرام وعندنا حلال، هناك مباح برزخٌ بينهما، فإذا انتقل الإنسان من الحلال إلى حلال هو برزخٌ بين الحلال والحرام، يَدَعُ هذا البرزخ خوفاً من أن ينتقل إلى الحرام، وأما التخلُّص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حدُّه، فمن اقتحم هذا الحد وقع في معصية، سيدنا عمر كان وقَّافاً عند كتاب الله.
بالمناسبة هناك آية تقول:
﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)﴾
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ الورِع لا يقرَب، أما الأقل ورعاً يقف عند الحد تماماً، ورد في بعض الأحاديث القدسيَّة أن يا عبادي لا تتعدوا ما أبحت لكم، ولا تقربوا ما حرَّمت عليكم.
الثمار الطيبة اليانعة للورَع:
الآن الثمار الطيبة اليانعة للورع؛ الخوف يُثمر الورع، هناك معنيان للخوف: الخوف من عقاب الله، والخوف من انقطاع الصلة بالله، الخوف الثاني خوف راقٍ جداً، أي إذا وُصِف النبي بأنه يخاف ربه، لا بمعنى أنه يخاف عقابه بقدر ما هو المعنى بأنه يخاف أن تنقطع صلته بالله، فالخوف يُثْمِر الورَع، والاستعانة، وقِصَر الأمل، وقوة الإيمان، والمعرفة تُثمر المحبَّة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذِّكر يُثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يُثمر التوكُّل، ودوام التأمُّل بأسماء الله وصفاته يُثمر المَعرفة، والورع يُثمر الزُّهد أيضاً، والتوبة تُثمر المحبَّة أيضاً، والرضا يُثمر الشُكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع أحوال المقامات.
أيها الإخوة؛ تقريباً إذا جئنا بمصفاة لها ثقوب، كلَّما كنت أشدّ ورعاً كان الثُّقب أصغر، هناك إنسان مصفاته قطرها كبير تمر منه برتقالة، هناك إنسان قطرها أصغر، أصغر، أصغر إلى أن تصبح هذه المصفاة متصلة، هذا هو الورع، أي لا يمر عبرها شيء، هناك إنسان يتغاضى كثيراً عن أشياء، هذا الكلام والله لي ولكم، ليس لكم وحدكم، كلَّما ازددت ورعاً ازددت قرباً من الله عزَّ وجل.
وعودٌ على بدء؛ ركعتان من ورع خيرٌ من ألف ركعةٍ من مُخلِّط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية اللّه إذا خلا بها لم يعبأ اللّه بشيء من عمله، وهناك أناس لهم أعمال كجبال تهامة، تصبح يوم القيامة هباء منثوراً، لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
الملف مدقق