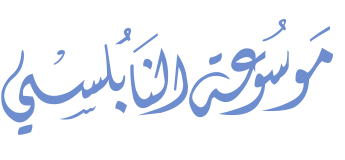الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس السادس من دروس جامع العثمان.
وعدتكم في لقاءٍ سابق أن يكون هذا الدرس في موضوع الاستقامة، وكنت قد قلت لكم حينما تحدثنا في موضوع الحب أو منزلة المحبة أن الحب أصلٌ من أصول الدين، وحينما تحدثنا عن الإخلاص، قلت لكم إن الإخلاص هو كلُّ شيء، وحينما تحدثنا عن العلم، قلت لكم: العلم أساس الدين، وأنا اليوم أقول لكم: الاستقامة عين الكرامة، لأن كلَّ ثِمار الدين، وكلَّ ما في الدين من سعادةٍ، وسكينةٍ، واطمئنانٍ، وتوفيقٍ، وشعورٍ بالأمن، وشعورٍ بالتفوق، وشعورٍ بالفوز، وهذه الثمار الخطيرة والثمينة لا يقطفها الإنسان إلا إذا استقام على أمر الله، فبين الذي يستمع كثيراً ولا يطبّق، وبين الذي يستمع ويطبّق بونٌ شاسع.
ماذا وردَ في القرآن الكريم عن الاستقامة؟
ربنا سبحانه وتعالى في سورة فُصّلت الآية الثلاثون يقول:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)﴾
أي ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ هذه ليست كلمة تُقال، ولكنها بحثٌ ذاتي، بحثٌ طويل، الإيمان لا يتأتى بكلمةٍ تقولها، ولكن ببحثٍ ذاتي طويل تبحثه، فنهاية المطاف، ونهاية هذا البحث، ونهاية التأمل، ونهاية التفكر، ونهاية التدبر، أن تقولَ: ربيَّ الله، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ذَكَرَ الله عزّ وجل في هذه الآية ثمرتين من ثمار الاستقامة ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ وقد يخاف الناس، وقد ينخلعُ قلبُ الناس لخطرٍ داهمٍ، وقد يقلقون، وقد يُقهرون، أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين: ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات، وهل من شعورٍ يدمّر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم؟ إنَّ من أمضِّ المشاعر، ومن أشدّها إيلاماً أن تندمَ على شيء فات، وأن تقلقَ للمستقبل، ومن دون أن تستقيم القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين، دائماً يندم على ما فات، ودائماً يقلق لِما هو آت، فالمستقيم كما وعدَ الله عزّ وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أما قالوا ربنا الله ثمَّ استقاموا، أي تكوّنت قناعاتهم بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو الربّ، وهو الربّ وحده، يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه لا خالقَ سِواه، وأنه هو الربّ، وأنه لا ربَّ سِواه، وأنه هوَ المُسير، وأنه لا مُسير سِواه، عبّرَ علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم: وحدة الخَلق، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية.
الآية الثانية في سورة الأحقاف:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)﴾
الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزِعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ، المفهوم الساذج، كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم: أخي أنا لست نبياً، ومن قال لك: إن الاستقامة خاصة بالأنبياء؟ من قال لك ذلك؟ إليكَ الدليل القطعي، القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته:
﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112)﴾
استقمْ: فِعلُ أمرٍ يفيد الوجوب،
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ النبي عليه الصلاة والسلام فسّرَ هذه الآية فقال:
(( عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المُرسلين؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [المؤمنون:51]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]، ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟! ))
كلما دعوتَ إنساناً إلى أن يستقيم رفعَ عقيرته وقال: أخي أنا لست نبياً، لا تكلفني ما لا أطيق، هذا كلامٌ فيه ضلالٌ كبير، وفيه زيغُ خطير، ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ لهذا هذه الآية وردت في سورة هود، لذلك حينما قالَ عليه الصلاة والسلام: شيّبتني هود، أي سورة هود، والذي شيّبَ النبي فيها هذا الأمر الخطير، ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ أنتَ أيها الأخُ الكريم تطلب من الله الكرامة، تطلب من الله أن ينصرك الله على أعدائك، أن يُوفقك، أن يرفع شأنك، أن يستخلفكَ في الأرض، أن يُمكّن لكَ دينك، وهو يطلب منك الاستقامة، إذا أردتَ أن تكون أكرمَ الناس فاتقِ الله، أي استقم على أمرِ الله، ما الاستقامة؟ قال بعضهم: إنها ضدّ الطغيان.
ما معنى طغى؟ أي خرجَ عن الخط المستقيم، طغى: خرجَ عن المنهج، طغى القطار: إذا خرجَ عن سكته، طغت السيارة: إذا خرجت عن الطريق المعبّد إلى وادٍ سحيق، معنى طغى أي خرج عن الخط المستقيم، والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقَ له منهجاً، وقالَ الله عزّ وجل:
﴿ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3)﴾
قدّمَ الله تعليم القرآن على خلقِ الإنسان، هذا التقديم ليسَ تقديماً زمنيّاً، لا يُعقلُ أن يُعلّمَ القرآن ثمَّ يُخلق، هذا مستحيل، لكن هذا التقديم تقديم رُتبي، أي ما قيمة الإنسان بلا منهج؟ ما قيمة هذه الآلة المعقدة بلا تعليمات؟ ما قيمة هذه الجامعة بلا نظامٍ داخلي؟ ما قيمة هذا الشيء بلا توجيهات استعماله، ﴿الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْإِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ إذاً الاستقامة أن تلزمَ المنهجَ الإلهي، أن تلزم أمرَ الله وسُنّة نبيه، والطغيان أن تحيدَ عن هذا المنهج، في عقيدتك، في تصرفاتك، في كسبِ المال، في إنفاق المال، في علاقاتك، في جِدّكَ، في لَهوكَ، في إقامتكَ، في سفركَ، في علاقاتك الداخلية، في علاقاتك الخاصة جداً، في علاقاتك العامة، حينما تخرج عن منهج الله.
أيها الإخوة الأكارم؛ متى تخرج عن منهج الله؟ لابد من أن تعرف هذا المنهج، حتى تعرف ما إذا كنتَ قد خرجتَ أو لم تخرج، كيف تعرف أنك خرجت عن هذا المنهج إن لم تعرف المنهج؟ إذاً طلب العِلمِ فريضة، طلبُ الفِقهِ حتمٌ واجبٌ على كلِّ مسلم، طلب العلمِ أساس الاستقامة، وطلب العلم أساس التوبة، كيف تتوب من ذنبٍ قبلَ أن تعرفَ أنه ذنب؟ وكيف تستقيم على منهج الله قبلَ أن تعرف منهج الله عزّ وجل؟ إذاً الخطوة الأولى، الحركة الأولى، الموقف الأول، الهمُّ الأول، الاهتمام الأول أن تعرف منهجَ الله عزّ وجل، أمره ونهيه.
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)﴾
هنا أضيف معنى جديداً، ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ قد تستقيم إلى زيدٍ أوعُبيد، قد تستقيم لتنالَ مكانة عندَ فلان، قد تتسلمُ عملاً ذا عائدٍ كبير ودخلٍ كبير، من حرصكَ على هذا الدخل تستقيم في هذا العمل، ولكن استقامتك من أجلِ أن يرضى صاحب العمل، فأنت استقمتَ لا إلى الله عزّ وجل، استقمتَ إلى زيدٍ أو عُبيد، هنا يوجد معنى جديد: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ هذا يشبه قول الله عزّ وجل:
﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)﴾
قد توضعُ في ظرفٍ تؤمر أمراً تعسفيّاً، وأنتَ ضعيف، وليس في إمكانكَ أن تقولَ: لا، إنكَ تصبر، ولكن تصبر وأنتَ مقهور، ليسَ هذا الصبر هو الذي أراده الله عزّ وجل، الله عزّ وجل يقول: ﴿ولربّكَ فاصبر﴾ .
وبالمناسبة كلما تذللتَ إلى الله رفعكَ الله، وكلما صغرتَ لله أعزكَ الله، وكلما كنتَ خاضعاً لله أخضعَ الله الآخرين إليك، وكلما هِبتَ الله هابَكَ الناس، وكلما نُزِعَت من قلبكَ هيبة الله نُزِعت من الناس هيبتك، قواعد، قوانين، الإنسان لو أنه يفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهماً عميقاً، إذا فهمَ ما قاله النبي على أنه قواعد ثابتة، قوانين مثلاً:
(( عن عبد الله بن عمر: برُّوا آباءَكم تبرُّكم أبناؤُكم، وعِفُّوا تعِفَّ نساؤكُم. ))
[ الهيتمي المكي : الزواجر عن اقتراف الكبائر: خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن: التخريج : أخرجه الطبراني ]
أي كلما غضضتَ بصركَ عن محارم الله، الله سبحانه وتعالى حفظَ لكَ زوجتكَ من أن تَزِلَّ قدمها، ((برُّوا آباءَكم تبرُّكم أبناؤُكم)) الأبناء يبرون آباءهم، ما أكرمَ شابٌ شيخاً لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عندَ سنه.
(( عن عائشة أم المؤمنين: من التمس رِضا اللهِ بسخَطِ الناسِ؛ رضِيَ اللهُ عنه، وأرْضى عنه الناسَ، ومن التَمس رضا الناسِ بسخَطِ اللهِ، سخِط اللهُ عليه، وأسخَط عليه الناسَ. ))
[ صحيح الترغيب : خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره. التخريج : أخرجه الترمذي ]
هذه قواعد، لو عرفتَ أن هذه القواعد حتميّة واقعةٌ لا محالة، لأنها من عندِ خالق البشر، من عندِ خالق الكون، القضية أن تقف من هذا الأمر أو هذه القاعدة موقف المصدّق، موقف المهتم، والطريق إلى ذلك كلما عَظُمَ عِندكَ ربك كلما عَظُمَ أمره، إذاً إذا تفكرّتَ في خلقِ السماوات والأرض، وازدادت خشيتك لله عزّ وجل، من ثمار هذه الخشية أنك تُعظّمُ أمرَ الله عزّ وجل، لهذا قال أحد أصحاب رسول الله، أظنه سيدنا بلال: لا تنظر إلى صِغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت.
إذاً ﴿فاستقيموا إليه﴾ يجب أن تكون استقامتك خالصة إليه، لكن أحياناً قد قلتها لكم سابقاً: قد يأتي أمرٌ إلهي متوافقٌ مع أمرٍ وضعي، فالسرقةُ حرامٌ في شرعِ الله، وحرام في قوانين الناس، فالذي يمتنع عن السرقة لا تدري أهوَ خوفٌ من عِقاب البشر أم خوفٌ من عِقاب خالق البشر؟ القضية هنا مختلطة، أما هناك أوامر ينفردُ بها الدين وحده، أمركَ بغض البصر، وأمر المؤمنة بغض البصر، فحينما يستجيب المؤمن لهذا الأمر مع أنه ليسَ في الأرض كلها قانون أو أمرٌ يُحَظّرُ عليك أن تنظرَ إلى امرأةٍ في الطريق، حينما تنفذُ أمراً ينفرد به الدين هذا يؤكد لك أنك مخلصٌ لله عزّ وجل، غضُّ البصر هذه مدرسة لماذا؟ لأن كلَّ من يغضّ بصره عن محارم الله يشعر في قرارةِ نفسه أنه لا يبتغي بهذا الغض إلا وجه الله، لأنَّ الناسَ لا يعنيهم هذا الأمر، ولا يُوَجّهونَ هذا التوجيه.
يوجد عندنا شيء آخر من الاستقامة، معنى جديد:
﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)﴾
الطريقة مستقيمة إذا استقاموا عليها، إذا تابعوا هذا السير المستقيم، قال تعالى:
﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17)﴾
أول ثِمار الاستقامة، أن تكونَ في بحبوحة، هذا كلام خالق الكون، كلام الله عزّ وجل، هذه الأمطار الشحيحة، المعدلات المتدنيّة، انحباس ماء السماء، هذه الظاهرة أهي ظاهرة جغرافية أم ظاهرة إلهية؟ الحقيقة إن الله عزّ وجل حينما يقول في كتابه الكريم: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ يتضح من هذه الآية أن الناس لو استقاموا على أمر ربهم لانهمرت السماء بمائها، لذلك كلما قلَّ ماء الحياء قلَّ ماء السماء، وكلما رَخُصَ لحم النساء غلا لحم الضأن، علاقات ثابتة، وكلما هانَ الله على الناس هانوا عليه، أي الإنسان حينما لا يبالي أكان دخله من حلالٍ أم من حرام، لا يبالي، الكلمة الشائعة: ضع في الخرج، من هنا ليوم الله يفرجها الله، لا تدقق، كلما هانَ الله على الناس هانوا عليه، ماذا قال الله عزّ وجل؟
﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65)﴾
هذه البراكين والصواعق، وما يشبه الصواعق القذائف، ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ الزلازل، ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ ما أقصى بأس الإنسان، قال تعالى:
﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130)﴾
هذا عقابٌ من الله عزّ وجل، إذاً: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ من ثمار الاستقامة من خلال هذه الآيات ألا تخاف مما هو آت، وألا تحزنَ على ما قد فات، أنتَ في منجاةٍ من القلق ومن الندم، والقلق والندم حالتان نفسيتان تدمران الصحة النفسية.
شيء آخر؛ يجب أن تستقيم على أمر الله كما أُمرَ النبي أن يستقيم على أمر الله، أنتَ بهذا الأمر واحد.
الشيء الآخر؛ الاستقامة يجب أن تكون في سبيل الله، ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء زيدٍ أو عُبيد، ولا فلان ولا علان، والاستقامة من ثِمارها أن الله سبحانه وتعالى يُفرّجُ عنك، يُزيلُ عنكَ كلَّ كرب، كلَّ همّ، كلَّ حزن، كلَّ ضيق، كلَّ قلق.
أقوال الخلفاء الراشدين بالاستقامة:
أبو بكر الصديق رضي الله عنه:
الآن إلى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
(( عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الأعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، يَرَى بَعْدِي اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ))
[ أبو داود والترمذي: صحيح ]
ماذا قالَ سيدنا الصديّق عن الاستقامة؟ قالَ: ألا تُشركَ باللهِ شيئاً.
تعريف الصّدّيق للاستقامة ألا تُشركَ باللهِ شيئاً، لمجرد أن تطيعَ إنساناً وتعصي ربك فقد أشركتَ به، رأيتَ طاعته أغلى من طاعة الله، لمجرد أن تتبعَ هواك وتعصي أمرَ الله عزّ وجل أشركتَ نفسكَ مع الله، قال تعالى:
﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)﴾
هذا فهمٌ عميقٌ جداً للاستقامة، الاستقامة عندَ هذا الصحابيّ الجليل، عندَ سيّدِ الصحابةِ والتابعين، عِندَ من لم تطلع شمسٌ على رجلٍ خيرٍ منهُ، سيدنا عمر لمّا كان مع أصحابه الكِرام، أحدهم أرادَ أن يتقرّبَ منه، كما يحدث دائماً، قالَ: واللهِ ما رأينا أحداً أفضلَ منكَ بعدَ رسول الله، هذا الكلام قيل لسيدنا عمر، ما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن نظرَ في أصحابه محدّقاً ومستنكرّاً، أحدهم قال: لا والله لقد رأينا من هو خيرٌ منك، قال: ومن هو؟ قال: أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد كذبتم جميعاً، أي جعلَ سكوتَ هؤلاء جميعاً كذِباً، وصدقْتَ، خاطب الذي قال: لقد رأينا من هو خيرٌ منك، ماذا قال عن سيدنا الصديق؟ قال: كنتُ أضلَّ من بعيري، وكانَ أبو بكرٍ أطيبَ من ريح المِسك، سيدنا الصدّيق يقول: الاستقامة ألا تُشركَ باللهِ شيئاً، بالضبط، اعلم عِلمَ اليقين لمجرد أن تعصي الله عزّ وجل، رأيت في هذه المعصية أنها مغنمٌ، هنا الشِرك، رأيتَ هذا الإنسان إذا أطعته وعصيتَ الله تستفيد، وقعتَ في الشركِ وأنتَ لا تدري.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، ماذا قال عن الاستقامة؟ قالَ: أن تستقيم على الأمر والنهي، أي أن يجدكَ حيثُ أمرك، وأن يفتقدكَ حيثُ نهاك، ولا تروغ روغانَ الثعلب، أخي نريد فتوى؟ هل عندك فتوى؟ هذا اسمه: روغان، نريد حيلة شرعية، يجب هذا الرجل هل هناك طريقة أن يسكن مع زوجة أخيه من دون حرج، يروغ روغان الثعلب، ما الحل؟ الحل يعقد عقداً على فتاة صغيرة في سنّ الرضاع، ثم تأتي زوجة أخيه فترضعها، فإذا هي أمُّ زوجته من الرضاع، ثمَّ يُطلّقُ هذه الفتاة الرضيع، زوجة أخيه هي أمُّ زوجته على التأبيد، له الحقُّ أن يراها، هذا ما اسمه؟ هذا اسمه: روغان الثعلب كما قال سيدنا عمر، حيلة شرعية، وكأن الله لا يدري ما يحصل، وكأن الله عالمُ السرِّ والنجوى لا يدري.
عثمان بن عفان رضي الله عنه:
سيدنا عثمان ماذا قال عن الاستقامة؟ قال: استقاموا أي أخلصوا العمل لله، سيدنا عثمان ألقى الأضواء على الإخلاص في الاستقامة، سيدنا عمر على العمل، سيدنا الصدّيق على العقيدة، التركيز عندَ الصدّيق كان على الشِرك، المنحرف مشرك، سيدنا عمر التركيز على العمل، سيدنا عثمان على الإخلاص، وكلهم من رسول الله ملتمس.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أما سيدنا عليّ رضيَّ الله عنه وابن عباس قالوا:
استقاموا أيّ أدَوّا الفرائض. من أين جاء بها؟ ما عُبدَ الله بأفضلَ مما افترضه عليكم، أي أداء الفرائض مُقدمٌ على كلِّ شيء،
(( عن أبي هريرة: اتَّقِ المحارمَ تكن أَعْبدَ الناسِ، وارضَ بما قسم اللهُ لك تكن أغنى الناسِ، وأَحسِنْ إلى جارِك تكن مؤمنًا، و أَحِبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلمًا، و لا تُكثِرِ الضَّحِكَ، فإنَّ كثرةَ الضَّحِكِ تُميتُ القلبَ. ))
[ صحيح الجامع: خلاصة حكم المحدث : حسن ]
سيدنا الحسن رضي الله عنه:
سيدنا الحسن قال: استقاموا على أمر الله عَمِلوا بطاعته واجتنبوا معصيته، اجتنبوا معصيته أيّ تركوا بينهم وبينها هامشَ أمان.
بعض العلماء يقول: استقاموا أي استقاموا على محبته وعبوديته، كما قلت لكم دائماً: العبودية غاية الخضوع مع غاية الحب، هذا معنى استقاموا.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم:
(( عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الإسْلامِ قَوْلا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: بَعْدَكَ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. ))
هذا هو الدين كله، أي إذا الإنسان آمن بالله ولم يستقم، ما فعل شيئاً، مع أن الاستقامة لابد لها من إيمانٍ بالله، أما إذا آمنت ولم تستقم ما فعلت شيئاً، أي إنسان على وشكِ الموتِ عطشاً، عَرَفَ أن في هذه الجهةِ نبعاً فياضاً، فيه ماء نميرٌ زُلال، لم يذهب إليه، هذه المعرفة ما قيمتها؟ وماتَ عطشاً، فالمعرفة هو لم يرتوِ إلا إذا عرف النبع، أما إذا عرف النبع ولم يذهب إليه ما فعل شيئاً، هذه حقيقة، هذا كلام ملخص الملخص، إنسان يتلوى جوعاً، أو يكاد يموت عطشاً وعرف النبع ولم يذهب إليه، لهذا ربنا عزّ وجل يقول:
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)﴾
أي:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)﴾
ما قيمة إيمانهم؟ ما قيمة كلِّ قناعاتك؟ كلّ الحقائق التي عرفتها إن لم تتخذ موقفاً عمليّاً، إن لم تنته، إن لم تأتمر، إن لم تفعل، إن لم تترك، إن لم تصل، إن لم تقطع، إن لم تغضب، إن لم ترضَ، إن لم تُعطِ، إن لم تمنع، إن لم تأخذ موقفاً عملياً لا قيمة لكلِّ قناعاتك، النبي عليه الصلاة والسلام في حديثٍ صحيحٍ رواه الإمام أحمد في مسنده يقول:
(( عَنْ ثَوْبَانَ، أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دينكم الصَّلاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إلا مُؤْمِنٌ. ))
[ الحاكم في مستدركه: صحيح ]
النبي عليه الصلاة والسلام كما قالَ عن نفسه أوتي جوامعَ الكلم، ((اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)) لكَ أن تفهمَ هذا الحديث فهمين، الأول: أنكَ إذا استقمتَ على أمر الله لن تُحصي الخيرات التي تتأتى من هذه الاستقامة، أي سعادة نفسية، توفيق في العمل، سرور، طمأنينة، شعور بالراحة، شعور بالتفوق، هذا كله من لوازم الاستقامة، أي من علامات الاستقامة أن يقول المستقيم: ليس في الأرض من هو أسعدُ مني، المؤمن مُبتلى، المؤمن قد تأتيه بعض المكاره، ولكن ليسَ معنى هذا أنه ليسَ بسعيد، سعادته داخلية، شعوره أنَّ الله يحبه هذا شيء مُسعد، شعوره أن الله راضٍ عنه هذا شيء مُسعد، شعوره أنه على منهج الله هذا شيء مُسعد، شعوره أن الله وعده بالجنة هذا شيء مُسعد، فالإنسان المؤمن سعيدٌ في داخله، ولا يمنع أن يُبتلى في ظاهره، يبتلى، قال تعالى:
﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)﴾
الإنسان لابد من أن يُبتلى:
﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)﴾
هذه: ((اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا)) ممكن الحديث يكون له معنى آخر، أي إنسان عنده مخبز، بذل جهداً كبيراً ألا، هناك حالات إذا الإنسان دخل بالوسواس القضية صعبة جداً، فيمكن أن يُفهم هذا الحديث أن الإنسان لا يدخل في حالة الوسواس، توضأ، لا لم يتوضأ، الماء تبلّغ، لا لم يتبلّغ، أعاد وضوءه مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، دخل بما يسمى وساوس، فهذا المعنى الآخر قد يكون من هذا الباب.
على كل الاستقامة هي السداد، السداد يعني أن تُصيب الهدف، وهناك حالات قد لا تستطيع شيء فوقَ طاقتك، إذاً لابد من المقاربة، المقاربة كما قالَ عليه الصلاة والسلام:
(( حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ. ))
أهون الشرّين، أحياناً الإنسان يُفرض عليه وضعان، عليه أن يختارَ أهونهما، أهون الشرّين سماها النبي عليه الصلاة والسلام: مقاربة، له أخت ليست ملتزمة على أمر الله، هل يقاطعها أم يصلها؟ إن قاطعها تزداد انحرافاً، وإن وصلها لا تصلي، نقول له: صِلها، إنكَ إن وصلتها لعلها تهتدي، يقول لكَ: ليست مستقيمة، بيتها فيه كذا وكذا، أهون الشريّن أن تصلها، هناك حالات أحياناً أنتَ مضطر أن تفعل ما هو قريب من الاستقامة، لا في الأحكام الشرعية ولكن في المعاملات، ((سددوا وقارِبوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قالَ: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)) إذا أعطيناك مفتاح بيت، ثمنه ثلاثون مليوناً، المفتاح ما ثمنه؟ عشرون ليرة، ظننت أن البيت مِلكُكَ، أنتَ أخذتَ مفتاح البيت ولم تدفع ثمن البيت، البيت فضلٌ من الله عزّ وجل، مثل للتقريب، أنتَ حينما تستقيم على أمر الله دفعتَ ثمن الجنة أم دفعتَ ثمن مفتاح الجنة؟ اشتريتَ مفتاح الجنة ولم تشترِ الجنة بكاملها، الجنة محضُ فضلٍ من الله عزّ وجل، فرقٌ بين أن تشتري المفتاح وبين أن تشتري الجنة، فالجنة برحمة الله كما قالَ عليه الصلاة والسلام، ((واعلموا أنه لن ينجو أحداً منكم بعمله، قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قالَ: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)) حتى إخواننا الكرام لا يقعون بتناقض بينَ هذا الحديث الصحيح الذي خرّجه علماء الحديث وبين آياتٍ كثيرةٍ تقول:
﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)﴾
قد يسأل سائل: كيف نوفق بين هذه الآيات وهذا الحديث؟ التوفيق سهل جداً، كنتُ قد ضربتُ لكم مثلاً من قبل: أن شاباً في الصف العاشر توفيَّ والده، والده فقير، له عمّ غني، قالَ العمُ لابن أخيه: يا بن أخي إن أردتَ أن تدرس فأنا أُنفقُ عليكَ وعلى أهلك، هذا الشاب درس العاشر تفوق، تابع الإنفاق عليه، درس الحادي عشر تفوق، درس الثاني عشر تفوق، دخل الجامعة، دخل كلية الطب، أخذ أعلى شهادة بالطب، عاد، فتح عيادة، تألقَ اسمه، وذاعَ صيته، وكَبُرَ دخله، وصارَ في بحبوحةٍ مثلاً، التقى العم مع ابنِ الأخ فقال العم لابنِ أخيه: يا بنَ أخي والله لقد نِلتَ ما نلتَ بجهدك، وسعيك، واجتهادك، وعرقك، وكدِّ يمينك، وعرقِ جبينك، هل هذا الكلام صحيح؟ قال له ابن الأخ: واللهِ يا عمي لولا فضلك لما كنتُ بهذا المقام، هو العم لو أنَّ ابنَّ أخيه لم يجتهد ما تابعَ الإنفاقَ عليه، ولو أنّه كانَ مجتهداً، ولم يتوافر له عمّ ينفقُ عليه لما نالَ هذه المرتبة، فنقول: إن ما حصّله من هذه المرتبة الاجتماعية والعلمية سببها، مفتاحها اجتهاده، والفضلُ فيها لعمه، مثل للتقريب، فإذا قالَ عليه الصلاة والسلام: ((سددوا وقارِبوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قالَ: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)) أي العمل مهما كانَ مستقيماً، مهما كانَ البذلُ كبيراً، لا يكفي لدخول الجنة، هو مفتاحٌ للجنة، ربنا عزّ وجل جعل الاستقامة والأعمالَ الصالحة مفتاحاً لدخول الجنة، أما دخول الجنة بفضلِ اللهِ عزّ وجل.
مثل آخر للتوضيح؛ إذا أب وعد ابنه بدراجة غالية الثمن إذا هو نالَ الدرجة الأولى على رفاقه، هذا الطالب نالَ الدرجة الأولى، حملَ الجلاء وتوجّه من فوره إلى بائع الدراجات، قال له: أعطني هذه الدراجة، وهذا الجلاء تفضل، أيعطيه إياها؟ هو تَوَهم الشاب أنه هكذا قال له الأب، خذ الدرجة الأولى وخذ هذه الدراجة من عند هذا البائع، لكن لابد من دفع الثمن من قِبل الأب، هو توجه مباشرةً إلى بائع الدراجات قال له: هذا الجلاء أنا حصلت على الدرجة الأولى أعطني هذه الدراجة، لا، هذه سبب، هذه مفتاح، أما الفضل لابد من أن يدفع الأب ثمن هذه الدراجة، حتى يكون الحديث متوافقاً مع الآية الكريمة: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ، ((لن ينجو أحد منكم بعمله)) التوفيق هكذا.
أيها الإخوة الأكارم؛ الاستقامة بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات،
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. ))
شطرٌ كبير من الاستقامة استقامة اللسان.
لكن بعض العلماء قال: الاستقامة فيها ستة شروط، والمعنى دقيق جداً، قالَ: اجتهادٌ في العمل، واقتصادٌ فيه، ووقوفٌ عندَ حدود العِلم، وإخلاص للمعبود، ومتابعةٌ للسنّة، ولكل كلمة شرح لا بأس به.
اجتهادٌ في العمل، أحياناً الإنسان يعمل عملاً شكلياً، صلى، هذه الصلاة التي أرادها الله عزّ وجل؟ صام، هذا الصيام الذي أراده الله عزّ وجل؟ تصدق، دفعَ زكاة ماله، بالعكس عنده بضاعة فاسدة، موديل سابق، لم تبع معه، قدّمها إلى جمعية، قال: أخي هذه زكاة مالي، وزعوها، وجد بضائع الناس ليسوا بحاجة لها، الناس بحاجة إلى طعام وشراب أحياناً، لاحظت ملاحظة بالجمعيات الخيرية، باركَ الله بها جميعاً، لكن كل شيء كسد عند التجار يقدمونه لهذه الجمعيات من حِسابِ زكاةِ أموالهم، هذا اجتهاد بالعمل؟ لا والله ليس اجتهاداً، كل شيء ممكن لا يُحَصّله وضعه على الزكاة، حتى إن بعضهم تطاولَ على الله عزّ وجل وعدَّ الضريبة من الزكاة، ارتاح، ضاعفوا الضريبة وضعها من الزكاة، فلما الإنسان يريد أن يفعل شيئاً لئلا يُعاتَب يسمونها العوام: رفع عتب، ليس هذه الاستقامة، الاستقامة طعام كرهته نفسه فقدمه للفقراء، هذا لا يجوز أبداً.
العمل والاجتهاد فيه، معنى الاجتهاد أن تبذلَ غاية الجهدِ، لهذا قالَ الله عزّ وجل:
﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)﴾
أي استنفذوا كل استطاعتكم، أي قدر ما تستطيع، فهموها فهماً آخر معاكساً، أي قدر ما تستطيع، أي بعض الجهد، الله سبحانه وتعالى يقول: استنفذوا كل جهدكم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ هو بذل بعض المستطاع، إذاً العمل والاجتهاد فيه، والاجتهاد بذل غاية الجهد، أنتَ تريد أن تصلي، يمكن أن تصلي في غرفة خاصة، في غرفة الضيوف، لو صليت في غرفة الجلوس، وهناك حديث، وهناك تشويش، وهناك كلام، أنت كإنسان لابد من أن تنصرف لما يقال حولك، فلو صليت في غرفة خاصة بعيدة عن الأصوات معنى ذلك أنك بذلت جهداً في هذه العبادة، لو صليت وأنت حاقن، أيةُ صلاةٍ هذه؟ صليت وأنت جائع، أي تريد أن تنتهي من هذه الصلاة، المقصود بذلُ الجُهدِ في العمل، زكاة مالك دفعتها لأول مستحق من دون اجتهاد، يجب أن يُدفع المال لمن هو يستحقه تماماً، ففي دفع الزكاة، بالحج أخذت الرُخص كلها ارتحت، قالَ شخص لآخر: يا أخي حججنا حجة لا مثيل لها، قال له: تصوّر صليت العصر بجدة، يوم عرفة العصر بجدة، ركبنا السيارة الطرقات فارغة ولا سيارة يوجد بالطريق، إلى مكة طفنا طواف القدوم وسعينا، لا يوجد أحد الحمد لله، لا يوجد ازدحام، خرجنا من مكة إلى عرفات، الطريق فارغ، جلست أول إنسان، أي عندما وجد الازدحام توقف، الشمس ما غابت بعد، غادرنا والطرقات فارغة، قال له: حجة مرتبة ما تغلبنا أبداً، هذا هو الجهد يا ترى؟ هذا بذل غاية الجهد في الحج؟ إن في الزكاة أو في الحج أو في الصيام، بالصلاة مثلاً، بغض البصر، كل من يأخذ بالرخص، قالً العلماء: من تصيّد الرخص من كلِّ المذاهب رقَّ دينه، انظر لي أي مذهب الأساور ليس عليها زكاة، قال له: عند الأحناف، أنا حنفي، وأي مذهب فيه قصر؟ والله المذهب الفلاني، وأي مذهب فيه، كلما يريد رخصة من أي مذهب لا يهم، يَتَبع أي مذهب بشرط أن يكون فيه رخصة، تصيد الرخص فيه رقة في الدين، قال له: يا سيدي أطلت الصلاة، قال له قرأت كلمة واحدة مدهامتان، قال له: اثنتان في ركعة واحدة، كنت اقرأ مدهامة واحدة، بذل غاية الجهد.
يوجد شيء ثان بالاستقامة أيها الإخوة؛ الاقتصاد، الاقتصاد أن تسلك بين طرفي الإفراطِ والتفريط، أنا أقول لكم الآن كلاماً دقيقاً جداً، من الطغيان عن الاستقامة أن تتعنتَ في الدين، أن تغلوَ في الدين، العوام تقول: لا إفراط ولا تفريط، مثلاً: أنتَ ورع جداً، ما شاء الله، غيور جداً على زوجتك، ما شاء الله، من شدة غيرتك على زوجتك رفضتَ أن تأخذها إلى الطبيب، أخي أنا لا أتحمل، طبيب أجنبي يطّلع على زوجتي هذا فوق طاقتي، أنت لست مستقيماً بهذا العمل، أنت أخذتَ جانبَ الغلوِّ في الدين، أنتَ أورعُ من سيد المرسلين؟ أنتَ أشد ورعاً من العلماء العاملين؟ فالانحراف عن الاستقامة له مظهران، إما الإفراط أو التفريط، الاستقامة أول شرط من شروطها أن تبذلَ غاية الجهدِ، لا يوجد عمل شكلي بالاستقامة، أداء شكلي، صلاة شكلية، صيام شكلي، حج شكلي، أن تبذل غاية الجهد أولاً، وثانياً: أن تقفَ الموقف المعتدل بين الطرفين، أنت زاهد، أعرضتَ عن الدنيا إعراضاً كليّاً.
السيدة عائشة رأت امرأة رثة الثياب، مهملة جداً في مظهرها، زوجة أحد أصحاب رسول الله، زوجها كان صوّاماً قوّاماً، مرة –قلت لكم هذه القصة-امرأة شكت لسيدنا عمر أن زوجها كانَ صوّاماً قوّاماّ، يبدو أنه لم ينتبه لقولها، قال لها: باركَ الله لك في زوجك، أحد الصحابة انتبه أنها تشكوه ولا تثني عليه، قال: إنها تشكو زوجها، قال: احكم أنتَ بينهما، فحكم أن يعطيها كل أربعة أيام يوماً، لأنه لو عنده أربع زوجات، للواحدة منهنَّ حق يوم، إذاً الاستقامة أن تعطي لكل ذي حقّ حقه، أن تؤدي الحقوق تماماً، لا أن تُفرّط ولا أن تُفْرط، الإفراط المبالغة، الغلو في الدين.
مرة قال لي أخ: طُلب منه أن يصنع أبيات مصاحف، رفض، وهو في أشدِّ الحاجةِ إلى المال، لماذا رفض؟ قال: لأن الذي كلّفه بهذا العمل ليسَ مسلماً، من أهل الكتاب، لا شيء فيها، من قال لك إنَّ هذه استقامة؟ لكَ أن تتعاملَ معه شِراءً أو بيعاً، وبيت مصحف أيضاً، قال تعالى:
﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171)﴾
من الانحراف عن الاستقامة أن تُفرّط أو أن تُفْرِط، ما دام الشرع سمح للطبيب الأجنبي أن يرى المرأة المسلمة، أما إذا كان هناك طبيبة أولى، طبيبان؛ مسلم وغير مسلم، المسلم أولى، أما حينما تكون القضية عويصة، والمرض خطيراً، وهناك شخص متخصص بهذا المرض، سيدنا رسول الله في الهجرة اختار خبيراً للطريق ليسَ مسلماً، هذه إشارة أحياناً الخِبرة لابدَ منها.
الصفة الثانية، الاقتصاد، أي السلوك بين طرفي الإفراط، وهو الجورُ على النفوسِ والتفريط بالإضاعة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟
(( عن أنس بن مالك: روِّحوا القُلوبَ ساعةً وساعةً. ))
[ السخاوي: المقاصد الحسنة: خلاصة حكم المحدث : يشهد له ما في صحيح مسلم وغيره من حديث: يا حنظلة ساعة وساعة ]
فإنَّ القلوبَ إذا كلّت عَميت، سيدنا معاذ صلى بأصحاب رسول الله فأطال الصلاة، فقالَ:
(( عن جابر بن عبد الله: معاذُ أَفَتَّانٌ أنت؟ فلَوْلَا صَلَّيْتَ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، والشَّمْسِ وَضُحَاهَا، واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فإنه يُصَلِّي وراءَك الكبيرُ والضعيفُ وذو الحاجةِ. ))
[ صحيح الجامع: خلاصة حكم المحدث : صحيح ]
إذا صلى النبي وحده أطالَ الصلاة، أما إذا صلى إماماً كان أخفهم في تمام صلاته، إذاً في كسب المال، الله أمرنا يقول لك: أخي العمل عبادة، جيد لكن أين الصلاة؟ ترك صلاته أو أهمل صلاته، وأهمل دروس العلم كلها، لم يعد يقرأ القرآن، في العمل عبادة، أفرط، أو ترك العمل من أجل العبادة، قال له: من يطعمك؟ قالَ: أخي، فقال: أخوك أعبدُ منك، انظر إلى الإسلام كيف هو متوازن، لهذا الجسدِ عليكَ حق، ولأهلكَ عليكَ حق، ولأولادكَ عليكَ حق، ولعملكَ عليكَ حق، فأعطِ كلَّ ذي حق حقه، أحياناً الشيطان:
﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)﴾
يأتيكَ عن اليمين افعل هذا، دع هذا العمل فيه شبهة، دع هذا، دع هذا، بلا عمل، بلا دخل، ضاع، أفتى لنفسه، حرّم الحلال، بلا مال، ثم جاءه الشيطان قال له: كل الاستقامة والله لم يعطك شيئاً، أحياناً هناك حالات انتكاس خطيرة جداً، السبب أنه لم يأخذ المنهج المعتدل، لما ترك العمل صار عنده أزمات مالية، تفاقمت في ساعات ضعفه جاءه الشيطان فانتكس نكسة كبيرة، هذا الاقتصاد.
وقوفاً مع ما يرسمه العلم أي الأمر ما هو؟ والنهي ما هو؟ الأمر أن تفعل كذا، والنهي أن تفعل كذا، أراد أن يصوم صياماً طويلاً، لما صام تعطل عن عمله، صار عنده شيء من التوتر النفسي، النبي الكريم أمر بالصيام يومي الاثنين والخميس لفلان أو ثلاثة أيام في الشهر، فلما زادَ ذلك انعكس على حالته النفسية.
الاستقامة الاجتهاد في العمل، والاقتصاد بين الإفراط والتفريط، والوقوف عند الأمر والنهي، وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر والنهي، أي متابعة السنة، العمل لا يُقبل إلا إذا كان صواباً أي وفق السنة، هذه الاستقامة، عمل مع بذل الجهد، اقتصاد بين الإفراط والتفريط، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص في هذا العمل، وقوف عند الأمر والنهي.
الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنّة:
السلف الصالح كانوا يُركزون على أصلين خطيرين، الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنّة، قالَ بعض السلف: ما أمرَ الله بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريطٍ وإما إلى مجاوزة، أعرف شخصاً يتوضأ حوالي خمسين مرة، توسوس، هناك مكان ما وصل إليه الماء، شعرت ببلل، شعرت بكذا، ما أمرَ الله بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريطٍ وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظَفِرَ زيادةً أو نقصاناً، إذا ظفر بترك الطاعة كسب، وإذا ظفر بالمبالغة بالطاعة إلى درجة أصبحت مستحيلة ممقوتة أيضاً ظفر، النبي عليه الصلاة السلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص:
(( عن عبد الله بن عمرو: كلِّ عاملٍ شِرَّةٌ ولكلِّ شرَّةٍ فترةٌ فمن كانت فترتُه إلى سنَّتي فقد أفلح. ))
[ ابن حجر العسقلاني: الأمالي المطلقة: خلاصة حكم المحدث : صحيح ]
شِرّةً: هي الفورة، الإنسان حينما يؤمن ينتقل من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من التفلت إلى الانضباط، ما كان يصلي، وجد في الصلاة سعادة كبيرة، لمّا غض بصره شعر بسعادة ثانية، لمّا حضر مجلس علم شعر بسعادة، هذه سمّاها النبي: الشِرّة، أي فورة، هذه الفورة رائعة جداً، لكن لها خطران، ((ولكلِّ شرَّةٍ فترةٌ)) بعد هذه الفورة يوجد فترة، كما قال سيدنا الصدّيق: بكينا حتى جفت مآقينا، فكل مؤمن له فترة يسموها العوام: الفترة الأولى هذه الفورة، رائعة جداً، يقول لك: أنا أسعد الناس، لكن بعد الفورة يوجد فترة، هذا كلام رسول الله: ((كلِّ عاملٍ شِرَّةٌ ولكلِّ شرَّةٍ فترةٌ فمن كانت فترتُه إلى سنَّتي فقد أفلح)) ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر، إذا هذه الفورة انتهت بفترة إلى بدعة خابَ وخسر، هذه الفورة انتهت إلى سُنة نجح وأفلح، فالإنسان وهو في الفورة، يجب أن ينضبط بالشرع، لو فرضنا بالفورة دفع كل ماله، فلما جاءت الفترة ندمَ على ذلك، فامتنع عن دفع الصدقات، انتهى إلى بِدعة.
كلُّ الخير كما قالَ بعض العلماء في اجتهادٍ باقتصاد وإخلاصٍ باتباع، هناك كانوا ستة الآن هنا أربع خصائص، اقتصاد بين الإفراط والتفريط مع الاجتهاد، والإخلاص مع الاتباع، أي اقتصادٌ في سبيلٍ وسُنّةٍ خيرٌ من اجتهاد في خِلاف سبيلٍ وسُنّةٍ، إذا أنت مقتصد مع السنة أفضل من أن تكون متهوراً مع غير السنة، قال: فاحرصوا على أن تكون أعمالكم على منهج الأنبياء عليهم السلام.
أشياء تُخرج من الاستقامة:
الآن ما الذي يُخرجُ من الاستقامة؟ قال: الرياءُ في الأعمال يُخرجها من الاستقامة، الرياء، والفتور والتواني يخرجها عنها أيضاً، يُعين المستقيم على الاستقامة أن يُفرّقَ دائماً بينَ الأمر والنهي، والثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، وبين ما يحبه الله وبين ما يبغضه، وبين ما يرضيه وبين ما يسخطه.
الآن مناسبة نتحدث حديثاً سريعاً عن الحيل الشرعية لأنه الموضوع بالاستقامة.
أولاً، بعضهم يحتج بِفعل سيدنا يوسف، لمّا وضع في رحلِ أخيه صواع الملك، وقالت:
﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70)﴾
والقصة معروفة عندكم، بهذه الحيلة احتجزَ أخاه عِنده، فبعض الذين يسلكون سبيل الحيل الشرعية يحتجون بهذا الموقف، مع أن هذا الموقف هو فعلاً حيلة، ولكن كي يأتي بأبيه وإخوته ليسكنوا عنده في مصر ليكرمهم، إذا إنسان لا يأخذ إطلاقاً منكَ شيئاً، وأنتَ احتلتَ على أن تعطيه على شكل قرض مثلاً، هذه حيلة مقبولة، هناك حيل رائعة جداً.
إنسان متعنت بقضية وأنت يجب أن تعاونه، فقد تسلك معه حيلةً كي تساعده، فالحيلة في أصلها مشروعةٌ إن كانت لجلبِ خيرٍ أو لدفعِ شرٍ، أما إذا كانت الحيلة للتحلل من بعضِ أوامر الله عزّ وجل فهذه حيلةٌ شيطانيةٌ مرفوضة، مثلاً من الحيل الشائعة أنتَ معكَ نِصاب المال، قبل أن يحولَ الحول تَهَبُ جزءاً منه لابنكَ، تتفق معه، بعد شهرين تعيد لي المال، أخي ما بلغ النصاب، كان ينقصني عشرة آلاف ليرة للنصاب ابني بحاجة وهبته إياهم، هذا يفعله بعض الناس، يَهَبُ جزءاً من ماله لشخص قبلَ أن يأتي الحول، النِصاب ما تمّ، بعد أن يمضيَ الحول يسترجع هذه الهِبة، هذه حيلة.
الحيلة الثانية: يشتري حاجة من بائع، ثم يردها له بعد مجيء الحول، هذه حيلة في إسقاط الزكاة، هناك حيلة في التعامل بالربا، بيع العَينة، العينة أن تضع حاجة أمامك تبيعها ديناً بسعر ونقداً بسعر، تبيعها للشاري ديناً بمئة ليرة، ثم تشتريها منه بثمانين ليرة نقداً، هذا بيع العَينة، هذا رِبا، لكن بشكل بيع وشراء.
أحياناً تطلقُ المرأة طلاقاً فيه بينونة كبرى من زوجها، فيقوم زواج شكلي، هذا التيس المستعار، يُعقد زواجاً شكلياً، ثم يُطلِّق، ثم تعود لزوجها الأول، أحياناً يُرهنُ العِقار والرهن لا يستعمل، ثم يَهبُ لكَ صاحِبُ العَقار منفعته، أنت أقرضته مبلغاً، وضع عندك عِقاراً رهناً، فأنت سكنت في العِقار، هذا القرض جرَّ نفعاً، هو على شكل رهن، والرهن لا يُستعمل، صاحب العِقار وهبك الانتفاعَ به، عملت حيلة كسبتَ فائدةً من هذا القرض وهكذا، كلُّ هذه الحيل حرامٌ قولاً واحداً لأنها احتيالٌ على الشرع للتفلت من أوامر الله عزّ وجل، ولكن الحيل الجائزة لجلبِ الخير أو لدفعِ الشر، لجلب الخير كما فعل سيدنا يوسف، احتال على أخيه عن طريق وضع صواع الملك في رحله، ثم فُتّشَ هؤلاء، وظهرَ صواع الملك في رحلِ أخيه فاحتجزه، من أجلِ أن يأتي بأبيه وإخوته، ويكرمهم في مصر.
إذاً كلُّ حيلة تنتهي بصاحبها إلى التفلتِ من أوامر الشرع هي حيلةٌ باطلةٌ حرامٌ، أما الحيلة التي تجلب الخير وتدفع الشر فهي حيلةٌ مقبولةٌ في الشرع.
الملف مدقق