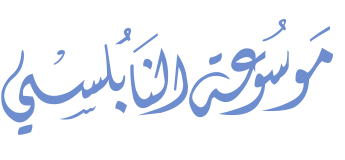الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين.
اللهم لا عِلم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزِدنا علماً، وأرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيُّها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المُزّمِّل.
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(1)﴾
في أصل اللغة يا أيُّها المُتزمِّل، أُدغِم حرفٌ بحرف، كقولك يا أيُّها المُدّثِر، أصلها يا أيُّها المُتدثِّر، فما معنى المُزّمِّل؟ إنها تعني المُتحمِّل، يعني يا أيُّها النبي، جاءتك هذه الرسالة التي حُمِّلتها.
﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً(2)﴾
المعنى الأول: المُزّمِّل: المُتحمِّل، حُمِّل هذه الرسالة، و أيُّ إنسانٍ مكلفٌ بحمل الأمانة، وأمانته هي نفسه التي بين جنبيه، و أمانة النبوّة التبليغ، أمانة المؤمن أن يُزكّي نفسه.
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)﴾
المعنى الثاني: المُتلفِّف، لو فتحتم في معاجم اللغة على معنى المُتزّمِّل أو المُزّمِّل معناها المُتحمِّل أو المُتلفِّف، فالمعنى الأول أنه حُمِّل هذه الرسالة، كُلِّف أن ينقل الحق إلى البشر، وما في هذه المُهمة من جُهدٍ كبير، يا أيُّها الذي حُمِّلت هذه الرسالة، الإنسان أحياناً يُكلَّف بمهمة، يشعُر بثِقل وقد لا ينام الليل، أحياناً يُرسَل ببعثة إلى بلدٍ غربي، يشعُر أنَّ جهةً وثِقت به وحمَّلته أن ينال هذه الشهادة، يشعُر بمسؤولية، فالله سبحانه وتعالى يقول له: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) ، أي: يا أيُّها النبي الذي حُمِّلت هذه الرسالة، والمعنى الثاني المُزّمِّل، (المُتلفِّف) يعني أبسط معنى أنه تلفَّف بثوبه، أمّا المعنى الأوسع أنه تلفَّف بثياب النبوَّة، ألبسه الله ثوب النبوَّة، ألبسه الله ثوب الرسالة.
فالعلماء قالوا: المُزّمِّل، المُتلفِّف بثياب النبوَّة، والمعنى الثاني المُلتزم بالرسالة.
المعنى الثالث: المُتلفِّف بالقرآن الكريم، كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، و كان خُلقه القرآن، فالكون قرآنٌ صامت، و القرآن كونٌ ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآنٌ يمشي.
والمعنى الثالث الدقيق (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) ، ليس هذا من أسماء النبي، ليس من أسماء النبي المُزّمِّل، و لا المُدثِّر، هذا اسمٌ اشتُقَّ من حالةٍ من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مُتلفِّفاً بثوبه، أسلوب اللغة العربية، أسلوب العرب حينما يشتقّون اسماً من حالة إنسانٍ ما، هذا للتحبُّب والتلطُّف، يعني ربُّ العزة في عليائه أراد أن يتلطف مع نبيه.
شواهد هذا الأسلوب في السيرة:
النبي عليه الصلاة والسلام، أنَّ عليٌ رضي الله عنه غاضَب فاطمة بنت النبي رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام، كان سيدنا علي نائماً وقد ألصق جنبه بالتراب، فقال له عليه الصلاة والسلام:
(( ما كانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أحَبَّ إلَيْهِ مِن أبِي تُرَابٍ، وإنْ كانَ لَيَفْرَحُ به إذَا دُعِيَ بهَا، جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا في البَيْتِ، فَقَالَ: أيْنَ ابنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ: كانَ بَيْنِي وبيْنَهُ شيءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِي، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أيْنَ هو فَجَاءَ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هو في المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُضْطَجِعٌ، قدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عن شِقِّهِ فأصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْسَحُهُ عنْه وهو يقولُ: قُمْ أبَا تُرَابٍ ، قُمْ أبَا تُرَابٍ. ))
قُم يا أبا تُراب تلطُّفاً به، وتحبُّباً إليه، وإشعاراً أني لستُ عاتباً عليك، هذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن الكريم نزَل بلسانٍ عربيٍ مُبين.
وهناك شاهدٌ آخر،
(( النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق، أراد أن يندُب صحابياً جليلاً لمُهمةٍ خطيرة، ليدخل هذا الصحابي في صفوف الأعداء، ليأتيه بالأخبار، واحتمال أن يُكشَف قائم، وقد يُقتل، وقد كان سيدنا حذيفة من شدة البرد والجوع، مُتلفِّفاً بالثوب نائماً، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه كلهم، فقال لحذيفة بن اليمان:
كنَّا عندَ حُذَيفةَ فقال رجُلٌ : لو أدرَكْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقاتَلْتُ معه فقال حُذَيفةُ: أنتَ كُنْتَ تفعَلُ ذلك لقد رأَيْتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةَ الأحزابِ وأخَذَتْنا رِيحٌ شديدةٌ وقُرٌّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( ألَا رجُلٌ يأتينا بخَبَرِ القومِ جعَله اللهُ معي يومَ القيامةِ ) ؟ قال: فسكَتْنا فلَمْ يُجِبْه منَّا أحَدٌ ثمَّ قال: ( ألا رجُلٌ يأتينا بخبَرِ القومِ جعَله اللهُ معي يومَ القيامةِ ) ؟ قال : فسكَتْنا فلَمْ يُجِبْه منَّا أحَدٌ ثمَّ قال فسكَتْنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( قُمْ يا حُذَيفةُ فَأْتِنا بخبَرِ القومِ ولا تَذعَرْهم ) فلمَّا ولَّيْتُ مِن عندِه جعَلْتُ كأنَّما أمشي في حمَّامٍ حتَّى أتَيْتُهم فرأَيْتُ أبا سُفيانَ يَصلِي ظَهرَه بالنَّارِ فوضَعْتُ سَهمًا في كبِدِ القوسِ فأرَدْتُ أنْ أرميَه فذكَرْتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا تَذْعَرْهم ) ولو رمَيْتُه لَأصَبْتُه فرجَعْتُ وأنا أمشي في مِثلِ الحمَّامِ فلمَّا أتَيْتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرْتُه بخبَرِ القومِ فألبَسني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَضْلَ عَباءةٍ كانت عليه يُصلِّي فيها فلَمْ أزَلْ نائمًا حتَّى أصبَحْتُ فلمَّا أصبَحْتُ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (قُمْ يا نَوْمانُ) ))
تلطُّفاً به، وتحبُّباً إليه، وإشعاراً له أنه ليس عاتباً عليه، وهذا أسلوب العربية، في التحبُّب والتلطُّف والتبيان.
لذلك (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) اسمٌ اشتُقَّ من حالةٍ لابست النبي، لمّا جاءه الوحي، شعر أنه حمل عبئاً ثقيلاً، وأنَّ أمامه طريقاً شاقَّاً مديداً، فلجأ إلى النوم الموقت، فجاءه الوحي مرّةً ثانية، (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُم) القيام يعني انهض لتبليغ هذه الرسالة، فهذا تحببٌ وتلطفٌ وإشعارٌ، بأن الله جلَّ جلاله ليس عاتباً عليه في تزمُّله و تلفُّفه بالثوب.
أيُّها الإخوة الكرام، المعنى الثاني أنَّ كل متلففٍ بثيابه خالدٍ إلى النوم، معنيٌّ بهذه الآية، يا أيُّها النائم قُم فصلِّ، ألا يقول المؤذِّن في صلاة الفجر الصلاة خيرٌ من النوم، ففي قاعدة في اللغة، أنَّ كل اسمٍ مُشتقٍ من فعل، ينطبِق على كل من اتصف بهذا الفعل، (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) أيُّها المؤمن، المُتدثِّر، المُتلفِّف بثيابك لا تنسَ ذكر الله، قُم فصلِّ.
فوائد صلاة الليل الصحيّة:
ولقد مرَّ في بعض خطب الجمعة، أنَّ بعض العلماء الغربيين، وجدوا أنَّ مرض احتشاء القلب، وهو من أخطر الأمراض، أو مرض تصلُّب الشرايين أو انسداد الشريان التاجي، هذا المرض سببه النوم المديد، لأنَّ الإنسان إذا نام نوماً مديداً، أبطأ قلبه إلى درجة أنه ينبض خمسين نبضة، وحينما تضعف نبضات القلب ويقلّ عددها، يمشي الدم في الأوعية ببُطءٍ شديد، وحينما يمشي ببُطءٍ شديد، تترسب على جُدر الشرايين المواد الدهنية، وعندئذٍ يُصاب الإنسان بما يُسمّى بتصلُّب الشرايين أو انسدادها، يقول أحد الأطباء الغربيين، وهو الباحث العلمي الذي لا يعرف عن الدين الإسلامي شيئاً، أنصَح الإنسان أن يقطع نومه بعد أربع ساعات أو خمس، ويُجري التمرينات الرياضية لمدة ربع ساعة أو أن يمشي مقدار ربع ساعة، وهذه هي صلاة الفجر، لذلك الذي يُصلّي الفجر في جماعة، أو الذي يُصلّي قيام الليل، فيقطع نومه ويقوم إلى الصلاة، لا يدري أنه يُحقِّق صيانةً راقيةً لقلبه وشرايينه، وأنَّ أكثر أمراض انسداد الشرايين أو تُصلّبها، بسبب النوم المديد، ومن فضل الله على المسلم، أنه لا يستطيع أن ينام أكثر من خمس ساعات متتالية، فإذا نام الساعة الحادية عشر، لا بُدَّ من أن يستيقظ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة، وهذا معنىً آخر.
العبادات وإن كانت من أجل القُربى من الله عز وجل، لها فوائد جانبية صحيّة، لو نعلم هذه الفوائد لسارعنا إلى طاعة الله أولاً، وإلى صيانة أجسامنا ثانياً، فكل راقدٍ في فراشه مَعنيٌ بهذه الآية، لأنها لم تأتِ بلفظ: يا محمد قُم، بل: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) المُزّمِّل اسمٌ مُشتقٌ من فعل، فكل مَن تلفَّف بثيابه وخلد إلى النوم والراحة، نقول له قُم فصلِّ.
أيُّها الإخوة الكرام، (قُم) استُعيرت لصلاة الليل، أي قُم صلِّ صلاة الليل، ومنه قيام الليل، (قُمِ اللَّيْلَ) ، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من هنا استنبط عليه الصلاة والسلام أنه مَن صلّى المغرب والعشاء، وصلّى الفجر، قام نصف الليل
(( دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. ))
لأنَّ حدّ الليل من المغرب حتى صلاة الفجر، و صلاة الفجر من قيام الليل، وصلاة المغرب والعشاء من قيام الليل، والذي يُتاح له أن يستيقظ بعد أن ينام، ليُصلّي بعض الركعات قياماً لليل، فهذا من كمال هذا الأمر الإلهي.
السؤال الآن: هل قيام الليل حتمٌ و فرضٌ أم ندبٌ وحضّ؟ هل قيام الليل فرضٌ على النبي عليه الصلاة والسلام وحده، أم عليه وعلى الأنبياء السابقين، أم عليه وعلى أُمته معه؟ الأصح أنه في بادئ الأمر فُرِض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه لقول الله عزَّ وجل:
﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (20)﴾
صلّى النبي وأصحابه قيام الليل عشر سنين حتى تورَّمت أقدام أصحابه، وتورَّمت أقدامه الشريفة هو أيضاً، ثم أنزَل الله عزَّ وجل آيات التخفيف، وستأتي بعد حين، (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) هذا الاستثناء من الليل.
أهمية التوازن بين العبادة ومعاملة الناس:
سيدَنا عمر رضي الله عنه، جاءه من أذربيجان رسول عامله على أذربيجان، فوصل هذا الرسول إلى المدينة في منتصف الليل، فكرِه أن يطرق باب أمير المؤمنين، فذهب إلى المسجد، فإذا رجُلٌ في الظلام يُصلّي ويقول: "ربّي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأُعزيّها" ، فقال هذا الرسول: مَن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر، فقال: أمير المؤمنين؟! لقد كرِه أن يطرق بابه ليلاً لئلا يوقظه، فإذا هو يُصلّي في الليل، قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل، فقال هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام: "إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربّي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي" ، يُستنبط من هذا الكلام، أنَّ هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر، وازن بين اتصاله بالله وخدمته للخلق، ومعظم الناس يجنحون إلى واحدةٍ من هاتين، فإمّا أن يستغرق في خدمة الخلق، فيُضيِّع ما ينبغي أن يفعله مع ربه، وإمّا أن يستغرق في عبادته فينسى خدمة الخلق، والأصح أن تُقيم توازناً بينهما، لا بُدَّ من أن تُشحَن كي تُفرِّغ هذه الشحنة مع الناس، لا بُدَّ أن تتلقى كي تُلقي، لا بُدَّ من أن تتعلم كي تُعلِّم، لا بُدَّ من أن تتصل حتى إذا رآك إنسان ذكر الله بك، لا بُدَّ لك من أن يكون لك مع الله صِلة، من أجل أن تؤثِّر لا بكلامك فقط بل بحالك، (إِلَّا قَلِيلاً) ، استثناء من الليل، يعني صلِّ الليل كله إلا يسيراً، طبعاً لأن قيام الليل كله غير ممكن، وهو شيء غير واقعي يتناقض مع طبيعة الإنسان، وأيُّ قصةٍ تسمعونها بأنَّ أحدهم أربعين سنة صلّى صلاة الفجر بوضوء العشاء دون أن ينام في النهار، هذا شيءٌ مستحيل، وهو مبالغة، لأنه مخالف لطبيعة الجسد، (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) ، هذا القليل عند بعض العلماء هو ما دون النصف أو الثلث.
كيف أصبح هذا الحكم من مستوى الفريضة إلى مستوى الندب؟
بقوله تعالى: (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) ، هذه الآية خفَّفت عن المؤمنين فرضية قيام الليل.
الوقت المُبارك قُبيل أذان الفجر:
في هذا الوقت المُبارك قُبيل أذان الفجر كما ورَد في الصِحاح
(( ينزلُ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى إلى السَّماءِ الدُّنيا كلَّ ليلةٍ حينَ يمضي ثلثُ اللَّيلِ الأوَّلُ فيقولُ: أنا الملِكُ من ذا الَّذي يدعوني فأستجبَ لَهُ، من ذا الَّذي يسألُني فأعطيَهُ، من ذا الَّذي يستغفِرُني فأغفرَ لَهُ، فلا يزالُ كذلِكَ حتَّى يضيءَ الفجرُ ))
فيُناجي الله تعالى هؤلاء الذين تركوا الفِراش الوثير، هؤلاء الذين ما مقصودهم جناتُ عدنٍ ولا الحور الحِسان، سِوى
نظر الحبيب فذا مُناهم وهذا مطلب القوم الكِرامَ
هؤلاء الذين هجروا الفِراش ليقفوا بين يَدي الواحد الديّان يُناجيهم ربهم عزَّ وجل، يقول: (هل من طالب حاجةٍ فأقضيها له، هل من سائلٍ فأُعطيه، هل من مُستغفرٍ فأغفر له، هل من تائبٍ فأتوب عليه، حتى ينفجر الفجر) .
فيا أيُّها الإخوة الكرام، إذا ضاقت بك السبُل، استعصى عليك أمراً، أخافك شيء، تعقدت مشكلة، وأنت ضعيف لا تقوى على حلِّها ولا تملِك حلِّها، فعليك بقيام الليل، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حَزبه أمرٌ بادر إلى الصلاة، وكم نصحت إخوةً كِرام، يضَعون أمامي مشكلةً عويصةً، أقول له: عليك بقيام الليل، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثٌ صحيح لا ينطق عن الهوى: (إذا كان ثلثُ اللَّيلِ الأخير، نزَل ربُكم إلى السماء الدنيا، فيقولُ: هل من تائبٍ فأتوب عليه، هل من طالب حاجةٍ فأقضيها له، هل من سائلٍ فأعطيه، هل من مُستغفرٍ فأغفر له، حتَّى ينفجر الفجرُ) .
أيُّها الإخوة الكرام، هذا هو سرّ الدين، أن تنعقِد لك صِلةٌ بالله عزّ وجل، فإذا كنت في النهار مُطيعاً له يوقِظك في الليل، لا تعصه في النهار، يوقِظك في الليل، فالقليل هو أقل من النصف أو الثلث.
﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4)﴾
كما قلت قبل قليل، فرضية قيام الليل، كانت فرضاً على جميع المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَك) ، ثم جاء التخفيف.
قال العلماء: الذي نسخ فرضية قيام الليل قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ) ، وقوله تعالى: (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) ، وقوله تعالى: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى) .
وقال بعض العلماء هو منسوخٌ بالصلوات الخمس، الآن قيام الليل سُنَّة، قيام الليل مندوبٌ إليه، وكما يقول البعض: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصُر نهاره فصامه، فالليل طويل يحتمل قيام الليل، والنهار قصير يحتمل الصوم.
فضل قراءة القرآن في قيام الليل:
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً(4)﴾
أي أجمل ما في قيام الليل هو قراءة القرآن في الصلاة، وعند الإمام مالك يجوز أن تقرأ القرآن الكريم من المصحف، فإن أردت أن تقرأ القرآن كله في قيام الليل، فلك أن تفتح المصحف أمامك، وأن تقرأ في كل ركعةٍ صفحة، وأن تقرأها قراءةً مُرتَّلة، ما معنى مُرتَّلة؟
(( روى عَنِ الحَسَنِ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلى رَجُلٍ يَقْرَأُ آيَةً ويَبْكِي ويُرَدِّدُها فَقالَ: ألَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ورَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلا﴾ هَذا التَّرْتِيلُ. ))
[ أخْرَجَه ابْنُ أبِي شَيْبَةَ ]
اقرأ القرآن بتمهُّل، اقرأه بتمعُّن، اقرأه بتدبُّر، وعِش جوَّ الآيات، فإن كانت الآية فيها وصفٌ لعذاب أهل النار، فتعوَّذ بالله من عذاب أهل النار، وإن كان في الآية وصفٌ لأهل الجنَّة، فادعُ الله أن تكون من أهل الجنَّة، وإن كان في القرآن الكريم آيةٌ تدل على عظمة الله، فسبح الله ومجّده تفاعل مع هذه الآيات، خصيصة الليل هي السكون والهدوء، فلا يوجد اتصالات هاتفية ولا حركة ولا ضجيج ولا صخب، لأن هذا الليل للمُحبين.
وسر نحونا لا تخش في الليل ظلمة وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا
أيُّها الإخوة الكرام، سمِع علقمة رجُلاً يقرأ قراءةً حسنة، فقال: "لقد رتَّل القرآن فداه أبي وأمي" ، وروى عبد الله بن عمر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( يقالُ لصاحِبِ القرآنِ اقرَأ وارقَ ورتِّل كما كُنتَ ترتِّلُ في الدُّنيا فإنَّ منزلتَكَ عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها ))
[ أخرجه أبو داوود والترمذي ]
(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) ، كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّ صوته بالقراءة مَدّاً.
ومعنى قوله تعالى:
﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121)﴾
أي يقرؤونه قراءةً وفق قواعد التجويد، (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) ، يتفهّمون المعاني التي ينطوي عليها، (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) ، يتدبرون الآيات التي أُمروا أن يتدبروها، (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) ، يُطبِّقونه، فمن حُسن قراءته إلى حُسن فهمه إلى حُسن تدبره، إلى حُسن تطبيقه، هذا معنى (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) ، ومعنى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) .
﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5)﴾
لهذه الآية معانٍ كثيرة، والحقيقة أنَّ الليل هو وقت النوم، والفراش يُغري ويجذب الإنسان إليه، والاسترخاء في الفراش أمرٌ يتوافق مع حاجات الجسد، فإذا أُمِر الإنسان أن يقوم الليل، والناس نيام، ففي هذا الأمر كُلفة، لكن ما من شيءٍ يوصلك إلى مرتبةٍ عالية إلا فيه مشقة بالغة.
المعنى الأول:
إذا الإنسان نالَ الشهادة العُليا، يحتاج إلى وقتٍ مديد و سهرٍ طويل و جُهدٍ جهيد، فالمراتب العُليا تحتاج إلى بذل جهد، فلعلَّ المعنى الأول لهذه الآية (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) أي حينما كلّفناك أنت وأصحابك بترك الفراش والصلاة نصف الليل، ففي هذا كُلفةٌ ومشقّة، لكن طريق المقام المحمود هو صلاة الليل.
قال الله عزَّ وجل:
﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (79)﴾
المراتب العُليا عند الله عزَّ وجل، تُنال من هذه الساعات التي يقضيها الإنسان في ذِكر الله وتلاوة قرآنه والاتصال به، هذا هو المعنى الأول، أي حينما كلّفناك قيام الليل، كان هذا التكليف ثقيلاً على الجسد، لكن مُريحاً للنفس، دائماً وأبداً الأشياء التي تُمتِع الجسد تُتعِب النفس، فإذا الإنسان أطلق نظره في الحرام، قد يستمتع بمنظر الحسناوات، ولكنه إذا جاء يُصلّي وجد بينه وبين الله حجاباً كثيفاً، فإذا استجبت لرغبات الجسد أتعبت نفسك، أمّا إذا ضبطت جوارحك فإنك تُريح نفسك، و راحة النفس في طاعة الله، بل إن أوامر الدين في معظمها تتناقض مع طبع الإنسان و تتوافق مع فطرته، أوضح مثل على ذلك، أنَّ من صلّى الفجر في وقته وعاد إلى النوم شعر بسعادة، يستيقظ الساعة التاسعة وهو في رحمة الله، أمّا لو ترك صلاة الفجر واستيقظ الساعة التاسعة فإن جسمه يستيقظ مُرتاحاً، و لكن كيف حاله مع الله عزَّ وجل عند استيقاظه؟ يشعُر أنَّ الشيطان بال في أذنه.
إذاً التكاليف مُتعِبةٌ للجسد مُريحةٌ للنفس، و التكاليف كلها تتناقض مع الطبع و تتوافق مع الفطرة، هذا المعنى الأول للآية: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) .
فهناك تكليف، الإنسان يُحِب أن يقال له دكتور، كلامٌ طيِّب، أن تكون له مرتبة في المجتمع، برفسور أو أستاذ جامعي، هذه مرتبة عالية في العِلم، لكن تحتاج إلى ثلاثٍ وثلاثين سنة من الدراسة والامتحانات والقراءة والتلخيص والتأليف والمتابعة، فكل شيء تناله في الدنيا أو في الآخرة يحتاج إلى بذل جُهدٍ، وسلعة الله غالية، ومن ظنَّ أنَّ الجنَّة تُنال بعباداتٍ جوفاء أو صدقاتٍ يسيرة تدفعها وأنت غافلٌ عن الله، فهذا إنسان واهم
(( من خاف أدلجَ ومَن أدلج بلغ المنزلَ ألا إن سلعةَ اللهِ غاليةٌ ألا إن سلعةَ اللهِ الجنةُ ))
﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)﴾
المعنى الثاني:
إنّا سنلقي عليك القرآن في قيام الليل، والقرآن قولٌ ثقيل ومنهَج كامل، لماذا الناس يُحبون التفلُّت؟ لأنه ليس مُقيداً بشيء، يأكل ما يشتهي، ينام متى يشاء، ويستيقظ متى يشاء، و يتكلم كيف يشاء، يكسب المال من أي طريقٍ شاء و ينفقه على أي شكلٍ شاء، و يلتقي مع مَن يشاء ويرفض مَن يشاء، فحياة التفلُّت مريحة، لكن حياة التقيُّد بمنهَج الله تحتاج إلى إرادة وإلى جُهد، لكنها مُسعِدة، فالقرآن الكريم منهَج كامل، ومنهَج الله عزَّ وجل منهجٌ كامل، يتدخل في أدقّ خصوصيات حياتك، وأكثر الناس يتوهمون أنَّ منهَج الله عزَّ وجل هو الصلاة والصوم والزكاة والحج، فمَن قال لك أنَّ هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم، هو هذه الفرائض الخمس، أكاد أقول ولا أُبالغ إنَّ الدين هو مائة ألف بند، في كسب المال و إنفاقه، وفي العلاقة الزوجية و تربية الأولاد، والعلاقة مع الجيران، في مناسبات الحزن ومناسبات الفرح، في الزواج و الطلاق، في السفر والإقامة، في نظافة جسمك، وضبط لسانك، وضبط جوارحك، إنه منهَج متكامل، فحينما ضغط المسلمون هذا المنهَج إلى خمس بنود، كانوا في مؤخرة الأُمم، أمّا حينما طبَّقوا منهَج الله عزَّ وجل، في كل أمور حياتهم، وهذه مُصيبة المصائب، اليوم الدين في المساجد فقط، أمّا في البيوت، بيوت المسلمين فهي غير إسلامية، وأسواقهم غير إسلامية، وتجاراتهم غير إسلامية، وهذه المسافة بين الدين والحياة، هي التي جعلت المسلمين وراء الأُمم.
فالمعنى الأول: تكليفك يا محمد بقيام الليل هو تكليفٌ ثقيلٌ على الجسد لكنه مُريحٌ للنفس، وهناك مَثَل في التربية يقول: إنَّ كل شيءٍ كان شاقّاً على النفس في البداية، فهو مُريحٌ لها في النهاية، وإذا كان سهلاً على النفس في البداية، كان مُتعِباً في النهاية ، وأوضح مثل على ذلك هو تعلُّم الآلة الكاتبة، فلو أنك لم تتعلم بمنهجٍ صحيح لضربت بإصبعٍ واحدة، ولو بقيت على هذه الحالة مائة سنة، تحتاج الصفحة إلى ساعة لتقوم بكتابتها، أمّا حينما تذهب لتتعلم استعمال الآلة وفق منهجٍ صحيح و خبرةٍ عميقة، فتكون عينك على النَص وأناملك على أزرار الآلة، فالتعلُّم في البداية صعبٌ جداً، لكن هذا التعلُّم الصعب ينتهي إلى راحةٍ كبيرة، فإذا آثرت الطريق السهل، فضربت على الآلة بإصبعٍ واحدة، فإنك تبقى عشرين سنة تضرب عليها و تحتاج الصفحة منك إلى ساعة أو إلى ساعتين، فكل شيء مُتعِب في بدايته مُريح في نهايته، والعلماء يقولون من لم تكُن له بدايةٌ مُحرقة، فلن تكُن له نهايةٌ مُشرقة، فالمعنى الأول مجرد تكليف قيام الليل أمرٌ ثقيل، لأنه يكون في وقت النوم و الراحة، والفراش يُغري أن تنساق إليه و تستلقي عليه، وأن تنعَم بالدفء في الشتاء، أمّا حينما تنزِع عنك الغطاء، وتنهض لقيام الليل، فهذا معاكسةٌ لطبيعة الجسم، لكنه موافقٌ لطبيعة النفس.
المعنى الثاني: إنَّ هذا القرآن الكريم منهَج تفصيلي، يحتاج تطبيقه إلى جُهد وإرادة وضبط ويقظة، (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) هذا المعنى الثاني.
المعنى الثالث: المعنى الثقيل أي ثقيلٌ في خيره، فالإنسان أحياناً قد يأخذ هديةً قلم رصاص، مثلاً، وأحياناً أُخرى يأخذ هدية سيارة غالية جداً، فنقول: هذه هدية ثمينة، أي ثمنها غالٍ جداً، و لها نفعٌ عظيم، فالمعنى الثالث أنَّ الذي يأتيك من قيام الليل شيءٌ ثمينٌ جداً، (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) .
المعنى الرابع: ثقيل، أي مُبارك فيه خيرٌ كثير، ولحكمةٍ أرادها الله عزَّ وجل، أنَّ الوحي حينما كان ينزل على النبي صلى الهق عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يركب ناقةً، فالناقة على عظم جسمها، كانت لا تحتمل الوحي، فكانت تبرُك، لأن الوحي ليس شيئاً في المنام، فدينُنا كله وحي، فلا بُدَّ لهذا الوحي من أن يكون واضحاً جداً، وأشدّ أسباب وضوحه أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام البرد القارص، إذا نزل عليه الوحي تصبب عرقاً، وكانت ناقته تبرُك على الأرض لثقل هذا الوحي، و هذا هو المعنى الأخير، (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) ثقيل، أي هذا هو الوحي، فمِن أنَّ قيام الليل أمرٌ يثقُل على الجسد إلى هذا القرآن الكريم منهجٌ تفصيليٌ كامل، يحتاج إلى إرادةٍ وجُهدٍ كبيرين، إلى أنَّ هذا القرآن الكريم ثقيلٌ من حيث الخير والبركة، وأخيراً هذا القرآن الذي نزل عن طريق الوحي، كان له وقعٌ شديدٌ على النبي عليه الصلاة والسلام.
﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7)﴾
هذه الآية لها معانٍ كثيرةٌ جداً، وأرجو الله سبحانه وتعالى، في درسٍ قادم أن أوفّيها حقَّها مِن الشرح والتأويل.
الملف مدقق