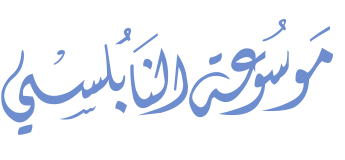أحكام التجويد - الحلقة ( 026 - 113 ) - أنواع المدود - المحاضرة(08-14) : مد الصلة.
- ٠07أنواع المدود
- /
- ٠07أنواع المدود
رابط إضافي لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا
×
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، تكلمنا في الدرس الماضي عن تركيب المدين المنفصل والمتصل أحدهما مع الآخر عندما يقرأ القارئ القرآن، فإذا مر معه مد منفصل ومده مثلاً أربع حركات ثم جاءه متصل يمده أربعاً مثل المنفصل، إذا مد المنفصل خمس حركات ثم جاءه بعد قليل مد متصل يمده أيضاً خمس حركات كالمنفصل، إذاً الأربعة مع الأربعة والخمسة مع الخمسة، هذا الذي قلناه لحفص من طريق الشاطبية، وتوسعنا في الكلام أكثر وقلنا أوجه أخرى لحفص من طريق الطيبة لا داعي لأعادتها لأنها للمتخصصين لكن القاعدة التي ذكرناها وأريد أن تكون راسخة في أذهان الجميع أن المد المتصل دائماً أكبر أو يساوي المنفصل.
لذلك من كان منكم قد درس أحكام التجويد على بعض الأساتذة يسمون المد المتصل المد الواجب، ويسمون المد المنفصل المد الجائز، لِمَ؟ لأن المد المتصل لم يرد قصره أبداً عن أحد من القراء، ولا قارئ من القراء، روى المتصل حركتين، يعني كالطبيعي أما المنفصل فروي بمقدار حركتين، يعني أن يبقى طبيعياً، لذلك يجوز مده ويجوز ترك مده، من أجل هذا سمي جائزا، أما المتصل فلم يقصره أحد ولم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً إلا ممدودا، لذلك يسمونه مداً واجباً، يعني واجب تطويله عن حركتين، واجب تطويله عن الطبيعي، هذا ما كان بالنسبة لدرسنا الماضي.
بفضل الله تكلمنا على خمسة من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المتصل، والمد المنفصل، نتكلم اليوم على المد السادس وهو مد الصلة.
الصلة: مد متعلق بهاء نستعملها بكلامنا العربي وهي هاء التي يكنى به عن الغائب المفرد المذكر، نقول ( إنهُ )، أنا أتكلم مع شخص مخاطب عن شخص ثالث غائب بهاء، هذه الهاء يسميها العرب هاء الغائب المفرد المذكر، هذه الهاء في لغة العرب حركتها دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، إما آخرها ضمة أو آخرها كسرة، ( إنهُ )، (بهِ)، إما مضمومة وإما مكسورة، كانت العرب إذا وقعت هذه الهاء بين حرفين متحركين يطولون ضمتها أو كسرتها، حتى يتولد من تلك الضمة ومن تلك الكسرة، واو مدية وياء مدية، مثال ذلك قوله تعالى:
والتعريف كما نرى على الشاشة، مد الصلة، هو صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، لكن ما هو الشرط؟ بشرط أن تقع بين متحركين.
إذاً لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهاء والذي بعد الهاء متحركاً، وإلا فلا صلة، هذه الهاء يا أخوة لها في تلاوتنا حكمان، إما أن يكون الحرف الذي بعدها همزة أو لا يكون همزة، إذا لم يكن همزة نسميه، صلة صغرى، وهي إذا لم يقع بعد الهاء همزة نحو:
قد يسأل سائل لماذا نقول يلحق بالمد الطبيعي ولا نقول عنه مداً طبيعياً؟ لأننا إذا وقفنا عليه تختفي هذه الواو وتلك الياء، (إنهُ ) إذا وقفنا عليها نقول ( إنَّهْ )، ( رجعهِ ) إذا وقفنا عليها نقول ( رجعهْ )، ولا نقول ( رجعهِ )، لا نفعل ذلك، فهذه الواو وتلك الياء لا تظهرهان إلا حالة الوصل، لذلك هذا المد يعتبر ملحقاً بالمد الطبيعي، أما المد الطبيعي فيكون ثابتاً وصلاً ووقفاً.
ما أظن البحث صعب، اجعلوا في بالكم أن هذه الهاء قبلها متحرك وبعدها متحرك نمطها، وتلاحظون في المصاحف بعد الهاء واوا صغيرة، يعينون القارئ بأن يضعوا بعد الهاء واواً صغيرة أو ياء صغيرة بمعنى أشبع أيها القارئ تلك الضمة وتلك الكسرة، حتى يتولد منهما واو وياء مديتان.
أما إذا كان بعد الهاء همزة مثل:
لذلك هذا المد يعامل معاملة المد المنفصل، إذا مددنا المنفصل أربع حركات نمد هذا المد أربع حركات، وإذا مددنا المنفصل خمس حركات نمده خمس حركات وإذا مددنا المنفصل حركتين من طريق طيبة النشر، نمد الصلة الكبرى أيضاً حركتين ونسميه مد الصلة الكبرى، وتعريفه كما نرى أمامنا على الشاشة، النوع الثاني للصلة، صلة كبرى: إذا وقع بعد الهاء همزة نحو: ( إنهُ أواب )، نلاحظ أن الهاء وقعت بين متحركين والمتحرك الثاني هو همزة، لذلك نمط الضمة حتى يتولد منها واو، ونمد تلك الواو بمقدار المد المنفصل، فحيث أننا في تلاوتنا المنهجية، نمد المد المنفصل أربع حركات نمد هذا المد الذي هو الصلة الكبرى أربع حركات أيضاً.
المثال الثاني، كما نرى على الشاشة، ( لهُ أصحاب )، المثال الثالث: ( بهِ إلا )، المثال الرابع: ( هذهِ أنعام )، ها، وهذه يا أخوة، كلمة ( هذهِ )، ليست هاءها، هاء ضمير مفرد غائب، لكنها تعامل معاملة المفرد الغائب، قد يقول قائل هل الهاء في كلمة هذه ضمير مفرد غائب مذكر؟ الجواب لا، لكن العلماء عاملوها، طيب ليس العلماء لما نقول العلماء يعني عندما قننوا القواعد وقعدوها، أما هي هكذا عاملتها العرب، عاملت العرب هاء ( هذهِ )، معاملة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر، فتمد بمقدار، كسرتها بمقدار حركتين إن لم يكن بعدها همزة، وإن كان بعدها همزة كالمثال الذي بين أيدينا، ( هذهِ أنعام )، يعامل معاملة المد المنفصل، توسطاً وفويق التوسط، الذي هو خمس حركات.
إذاً، ألخص ما قلته، بكليمات، هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب، إذا وقعت بين متحركين تشبع ضمتها وكسرتها، إن وقع بعدها همزة، تعامل معاملة المنفصل ونسميها صلة كبرى، بحث سهل بسيط وهو النوع الخامس من أنواع المدود في كتاب الله عز وجل.
قد يسأل سائل هل هذه القاعدة، تنطبق على القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة عل رواية حفص عن عاصم؟ نقول نعم هذه القاعدة تنطبق على القرآن كله، اللهم إلا كلمتين اثنتين في رواية حفص عن عاصم، الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة، يعني لم تقع بين متحركين وفيها صلة، والكلمة الثانية انطبقت عليها القاعدة ووقعت بين متحركين ولكن لا صلة فيها، لِمَ؟ هكذا رواها حفص عن شيخه عاصم بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نلاحظ على الشاشة، يستثنى من مد الصلة كلمتان، واحد كلمة لا ينطبق عليها الشرط وفيها صلة، وهي قوله تعالى: ( ويخلد فيهِ مهانا )،في سورة الفرقان، نلاحظ أن كلمة ( فيهِ مهانا )، قبل الهاء ياء ساكنة، يعني ليس حرفاً متحركاً، ومع ذلك فإن حفصاً رواها عن شيخه عاصم ( بالصلة ).
أما الكلمة الثانية التي انطبق الشرط عليها ولا صلة فيها، وهي قوله تعالى: (يرضهُ لكم )، في سورة الزمر، قال تعالى: (وإن تشكروا يرضهُ لكم)، لاحظوا الهاء قد وقعت بين متحركين، فقبلها متحرك وبعدها متحرك، ومع ذلك فلم يروها حفص، (يرضهُ لكم)، وإنما رواها، (يرضهُ لكم ) يعني من غير إشباع لضمتها، بهذا نكون قد وضعنا القاعدة التي تعين القارئ على مد الصلة في القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة، ونسأل الله التوفيق والإعانة على بحث المدود الباقي، في دروسنا القادمة بإذنه تعالى، وصلى اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لذلك من كان منكم قد درس أحكام التجويد على بعض الأساتذة يسمون المد المتصل المد الواجب، ويسمون المد المنفصل المد الجائز، لِمَ؟ لأن المد المتصل لم يرد قصره أبداً عن أحد من القراء، ولا قارئ من القراء، روى المتصل حركتين، يعني كالطبيعي أما المنفصل فروي بمقدار حركتين، يعني أن يبقى طبيعياً، لذلك يجوز مده ويجوز ترك مده، من أجل هذا سمي جائزا، أما المتصل فلم يقصره أحد ولم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً إلا ممدودا، لذلك يسمونه مداً واجباً، يعني واجب تطويله عن حركتين، واجب تطويله عن الطبيعي، هذا ما كان بالنسبة لدرسنا الماضي.
بفضل الله تكلمنا على خمسة من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المتصل، والمد المنفصل، نتكلم اليوم على المد السادس وهو مد الصلة.
الصلة: مد متعلق بهاء نستعملها بكلامنا العربي وهي هاء التي يكنى به عن الغائب المفرد المذكر، نقول ( إنهُ )، أنا أتكلم مع شخص مخاطب عن شخص ثالث غائب بهاء، هذه الهاء يسميها العرب هاء الغائب المفرد المذكر، هذه الهاء في لغة العرب حركتها دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، إما آخرها ضمة أو آخرها كسرة، ( إنهُ )، (بهِ)، إما مضمومة وإما مكسورة، كانت العرب إذا وقعت هذه الهاء بين حرفين متحركين يطولون ضمتها أو كسرتها، حتى يتولد من تلك الضمة ومن تلك الكسرة، واو مدية وياء مدية، مثال ذلك قوله تعالى:
﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾
الهاء الأولى وقعت بين حرفين متحركين، كذلك الهاء الثانية،﴿ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾
، وقعت بين متحركين، لذلك نمط ضمة إنهُ، حتى يتولد منها واو، رجعهِ، نمط الكسرة حتى يتولد منها ياء، هذا حرف المد الذي نشأ، نسميه مد صلة.والتعريف كما نرى على الشاشة، مد الصلة، هو صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، لكن ما هو الشرط؟ بشرط أن تقع بين متحركين.
إذاً لا بد أن يكون الحرف الذي قبل الهاء والذي بعد الهاء متحركاً، وإلا فلا صلة، هذه الهاء يا أخوة لها في تلاوتنا حكمان، إما أن يكون الحرف الذي بعدها همزة أو لا يكون همزة، إذا لم يكن همزة نسميه، صلة صغرى، وهي إذا لم يقع بعد الهاء همزة نحو:
﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾
(إنهُ)، انتبهتم كيف مططنا وطولنا الضمة حتى تولد منها واو، وكذلك(رجعهِ)، مططنا الكسرة وطولناها، حتى تولد منها ياء، إذاً وتمد هذه الصلة الصغرى بمقدار حركتين، ويلحق بالمد لطبيعي.قد يسأل سائل لماذا نقول يلحق بالمد الطبيعي ولا نقول عنه مداً طبيعياً؟ لأننا إذا وقفنا عليه تختفي هذه الواو وتلك الياء، (إنهُ ) إذا وقفنا عليها نقول ( إنَّهْ )، ( رجعهِ ) إذا وقفنا عليها نقول ( رجعهْ )، ولا نقول ( رجعهِ )، لا نفعل ذلك، فهذه الواو وتلك الياء لا تظهرهان إلا حالة الوصل، لذلك هذا المد يعتبر ملحقاً بالمد الطبيعي، أما المد الطبيعي فيكون ثابتاً وصلاً ووقفاً.
ما أظن البحث صعب، اجعلوا في بالكم أن هذه الهاء قبلها متحرك وبعدها متحرك نمطها، وتلاحظون في المصاحف بعد الهاء واوا صغيرة، يعينون القارئ بأن يضعوا بعد الهاء واواً صغيرة أو ياء صغيرة بمعنى أشبع أيها القارئ تلك الضمة وتلك الكسرة، حتى يتولد منهما واو وياء مديتان.
أما إذا كان بعد الهاء همزة مثل:
﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾
جاءت هنا همزة لاحظوا لما أقول: ( ما لهُو )، أليس آخر حرف نطقته أنا الآن، واواً ساكنة قبلها ضمة، ( مالَهُو )، حرف مد واو ساكنة قبلها مضموم، ( أخلده )، همزة في أول الكلمة التي تليها، ألا يشبه المد المنفصل الذي كنا درسناه في الحلقة قبل الماضية؟ نعم يشبهه ولكن الفرق بينهما أن حرف المد في ( يا أيها )، في المد المنفصل الذي كنا قد درسناه يبقى هذا المد ووصلاً وقفاً، أما ( مالهُ أخلده )، لو وقفنا على ( مالهُ ) بتسكين الهاء، ( مالهْ ) فتختفي الواو.لذلك هذا المد يعامل معاملة المد المنفصل، إذا مددنا المنفصل أربع حركات نمد هذا المد أربع حركات، وإذا مددنا المنفصل خمس حركات نمده خمس حركات وإذا مددنا المنفصل حركتين من طريق طيبة النشر، نمد الصلة الكبرى أيضاً حركتين ونسميه مد الصلة الكبرى، وتعريفه كما نرى أمامنا على الشاشة، النوع الثاني للصلة، صلة كبرى: إذا وقع بعد الهاء همزة نحو: ( إنهُ أواب )، نلاحظ أن الهاء وقعت بين متحركين والمتحرك الثاني هو همزة، لذلك نمط الضمة حتى يتولد منها واو، ونمد تلك الواو بمقدار المد المنفصل، فحيث أننا في تلاوتنا المنهجية، نمد المد المنفصل أربع حركات نمد هذا المد الذي هو الصلة الكبرى أربع حركات أيضاً.
المثال الثاني، كما نرى على الشاشة، ( لهُ أصحاب )، المثال الثالث: ( بهِ إلا )، المثال الرابع: ( هذهِ أنعام )، ها، وهذه يا أخوة، كلمة ( هذهِ )، ليست هاءها، هاء ضمير مفرد غائب، لكنها تعامل معاملة المفرد الغائب، قد يقول قائل هل الهاء في كلمة هذه ضمير مفرد غائب مذكر؟ الجواب لا، لكن العلماء عاملوها، طيب ليس العلماء لما نقول العلماء يعني عندما قننوا القواعد وقعدوها، أما هي هكذا عاملتها العرب، عاملت العرب هاء ( هذهِ )، معاملة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر، فتمد بمقدار، كسرتها بمقدار حركتين إن لم يكن بعدها همزة، وإن كان بعدها همزة كالمثال الذي بين أيدينا، ( هذهِ أنعام )، يعامل معاملة المد المنفصل، توسطاً وفويق التوسط، الذي هو خمس حركات.
إذاً، ألخص ما قلته، بكليمات، هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب، إذا وقعت بين متحركين تشبع ضمتها وكسرتها، إن وقع بعدها همزة، تعامل معاملة المنفصل ونسميها صلة كبرى، بحث سهل بسيط وهو النوع الخامس من أنواع المدود في كتاب الله عز وجل.
قد يسأل سائل هل هذه القاعدة، تنطبق على القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة عل رواية حفص عن عاصم؟ نقول نعم هذه القاعدة تنطبق على القرآن كله، اللهم إلا كلمتين اثنتين في رواية حفص عن عاصم، الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة، يعني لم تقع بين متحركين وفيها صلة، والكلمة الثانية انطبقت عليها القاعدة ووقعت بين متحركين ولكن لا صلة فيها، لِمَ؟ هكذا رواها حفص عن شيخه عاصم بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نلاحظ على الشاشة، يستثنى من مد الصلة كلمتان، واحد كلمة لا ينطبق عليها الشرط وفيها صلة، وهي قوله تعالى: ( ويخلد فيهِ مهانا )،في سورة الفرقان، نلاحظ أن كلمة ( فيهِ مهانا )، قبل الهاء ياء ساكنة، يعني ليس حرفاً متحركاً، ومع ذلك فإن حفصاً رواها عن شيخه عاصم ( بالصلة ).
أما الكلمة الثانية التي انطبق الشرط عليها ولا صلة فيها، وهي قوله تعالى: (يرضهُ لكم )، في سورة الزمر، قال تعالى: (وإن تشكروا يرضهُ لكم)، لاحظوا الهاء قد وقعت بين متحركين، فقبلها متحرك وبعدها متحرك، ومع ذلك فلم يروها حفص، (يرضهُ لكم)، وإنما رواها، (يرضهُ لكم ) يعني من غير إشباع لضمتها، بهذا نكون قد وضعنا القاعدة التي تعين القارئ على مد الصلة في القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة، ونسأل الله التوفيق والإعانة على بحث المدود الباقي، في دروسنا القادمة بإذنه تعالى، وصلى اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.