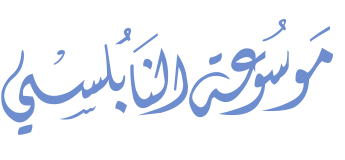الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس الخامس من دروس جامع العثمان.
ندخل الآن في موضوعٍ جديد أو منزلةٍ جديدة من منازل إيّاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين، ولا أبالغ إذا قلت إنها من أرقى المنازل، إنها منزلة العلم، الله سبحانه وتعالى ما اعتمد في قرآنه الكريم إلا قيمة العلم، هناك قيمة المال، وقيمة القوة، وقيمة الصحة، وقيمة الغِنى، وقيمة الجمال، كلُّ هذه القيم ما اعتمدها الله عزّ وجل للترجيح بين خلقه، لكن قيمة العلمِ وحدها كانت معتمدةً في القرآن الكريم حيث قال الله عزّ وجل:
﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)﴾
مرة ثانية إنها من أرقى المنازل، هذه المنزلة إن لم تصحب السالكَ من أول قدمٍ يضعها على طريق الإيمان حتى ينتهي به الطريق فهو على غير طريق، أي إن شبهنا طريق الإيمان بطريق معبّد وطريق غير الإيمان طريقٌ ترابية، فما لم يعتمد سالكُ طريق الإيمان العلمَ، والعِلمَ وحده فهو على غير الطريق، أي يجب أن نؤمن أنَّ هناكَ طريقاً إلى الله، ليس هناك طريقٌ أخرى، إنها طريقُ العِلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول:
﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)﴾
ما قال زدني مالاً، ولا زدني شأناً، ولا زدني وجاهةً، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ .
الإمام الجُنيد من كبار أئمةِ الدين، مشهودٌ له بالعِلمِ والفضل، له كلمةٌ دقيقة يقول: الطرقُ كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثارَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أيُّ طريقٍ إلى الله عزّ وجل من دون أن تقتفيَّ أثرَ النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطريق ليست سالكة إنها مسدودة.
ويقولُ أيضاً: مذهبنا هذا مقيدٌ بأصول الكتاب والسنّة، أنتَ معك كتاب ومعك سُنّة، الكتاب والسنة هما منهجاك إلى الله عزّ وجل.
ويقول بعض العلماء: من لم يزن أفعاله وأحواله، كيف؟ هذا الفعل مطابقٌ للسنّة؟ أقرّه النبي؟ فعله النبي أم لم يفعله؟ يجب أن تجعل من السنّةِ ميزاناً لأفعالك، الآن هذا الشعور بأنني غير هؤلاء الناس، أنا فوقهم، هذا الشعور سوي؟ هذا الشعور صحي أم شعور مرضي؟ يجب أن تزين أفعالكَ وأحوالكَ بالكتاب والسنّة، إذا كنتَ حريصاً على آخرتك، إذا كنتَ حريصاً على سعادتك، على نجاتك، دائماً وأبداً تزين أفعالكَ وأحوالكَ بالكتاب والسنّة.
معرفة الكتاب والسنّة شرطٌ أساسي لاستخدامهما ميزاناً في الأفعالَ والأحوال:
سؤال دقيق الآن، الآن ظهر السؤال، كيف تزين أفعالك وأحوالك بالكتاب والسنّة إن لم تعرف الكتاب والسنة؟ هما الميزان، إذاً معرفة الكتاب والسنّة شرطٌ أساسي لتستخدم هذا الكتاب والسنّة ميزاناً في أفعالكَ وأحوالك، ومن لم يتهم خواطره فلا يُعدّ في ديوان الرجال، أي ما كل خاطرٍ يأتيك حق، ما كلُ خاطر يَرِدُ عليك موافقٌ للكتاب والسنّة، يجب أن تزين الخواطر، أن تزينَ الأقوال، أن تزينَ الأفعال، أن تزينَ الأحوال، أربعة صاروا، الأفعالُ والأحوالُ والأقوالُ والخواطر، هذه كلها يجب أن تمسك بالكتاب والسنة كمقياس تقيس بها كل ذلك، ولكن كما قلت قبل قليل: يجب أن تعرف الكتاب والسنة، كما قال الإمام الغزالي من شروط التوبة العلم، كيف تعرفُ أن هذا ذنب؟ كيف تتوب من ذنبٍ لا تعرفه ذنب؟ مستحيل إنسان يتوب من ذنب لا يعرفه أنه ذنب، إذاً أولُ مرحلةٍ من مراحل التوبة العلم، أن تعلم الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يصح وما لا يصح، ما هو مقبول عند الله وما هو غير مقبول.
يقول بعض العلماء: كلُّ فعلٍ يفعله العبدُ بغيرِ اقتداءٍ فهو عيشِ النفسِ، إما أن تكونَ مع رسول الله وإما أن تكون مع هواك، إذا فعلت، تصرفت، فكرت، جاءتك الخواطر، جاءتك المشاعر، ولم تزنها بالكتاب والسنّة، فهذه من رعونات النفس، ومن حظوظ النفس، جهتان لا ثالثَ لهما، إما أن تكونَ مع الكتاب والسنّة مع منهج الله عزّ وجل، وإما أن تكونَ مع هواك، فكلُّ فعلٍ يفعله العبدُ بغيرِ اقتداءٍ فهو عيشِ النفسِ، أي أنتَ مع حظوظِ نفسك، مع رعوناتِ نفسك، مع مطالبِ نفسك.
ويقول بعض العلماء: من عملَ عملاً بلا اتباعِ سُنّة فباطلٌ عمله.
إذاً يتضح من هذه الأقوال أنه لابد من معرفة السنّة، لابد من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنَّ كلَّ موقفٍ من مواقفه، وكلَّ تصرفٍ من تصرفاته، إنما هو تشريع لنا، فأقواله وأفعاله وأحواله وإقراراته هذه كلها العلم بها فرضُ عين، لأنها المنهج.
قالَ بعضهم: الصحبة مع الله عزّ وجل بحسنِ الأدبِ، ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله باتباعِ سُنّته، ولزومِ ظاهر العلمِ، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأهل بحُسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البِشر، ومع الجهّالِ بالدعاءِ لهم بالرحمة، ومع الحافِظَين بإكرامهما واحترامهما، ومع النفسِ بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة، كل جهة يصحبها هكذا.
قالَ بعضهم: من أمّرَ السنّة على نفسه قولاً وفعلاً نطقَ بالحِكمة، ومن أمّرَ الهوى قولاً وفعلاً نطقَ بالبِدعة، إما أن تنطق بالحكمة وإما أن تنطق بالبدعة، إذا أمّرتَ الكتاب والسنة نطقت بالحكمة، إذا أمّرت الهوى نطقت بالبدعة، ، وكلُّ بدعةٍ ضلالة، وكلُّ ضلالةٍ في النار، يؤكدُ هذا قول الله عزّ وجل:
﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54)﴾
آيةٌ قطعية الدلالة ﴿إن تطيعوه تهتدوا﴾ أي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الهدى.
من قاده العلم إلى الله أراحه الله من المصائب:
بعضهم قال: العِلمُ قائد والخوفُ سائق، الخوف يدفعكَ إلى بابِ الله، والعِلمُ يقودكَ إلى الله، والنفسُ حرونٌ بينَ ذاكَ وذاك، النفس حرون وجموح وخدّاعة وروّاغة فاحذرها وراعِها بسياسة العلم، وسُقها بتهديد الخوف، يتمُ لكَ ما تريد.
إذاً الإنسان إذا قاده العِلمُ إلى الله أراحه الله من المصائب، فإن لم يقده العلم إلى الله سخّرَ الله له بعض المصائب كي تدفعه إلى باب الله، أي إما أن تأتيه طوعاً وإما أن تأتيه كرهاً، إما أن تأتيه بدافعٍ من إيمانك به، وإما أن تأتيه بدافعٍ من خوفك منه، إن أتيته بدافعٍ من إيمانك هذا أرقى لكَ عند الله عزّ وجل من أن تأتيه بدافعٍ من خوفك، وكما يقول بعض العلماء: صيدلية الله عزّ وجل أدويتها كثيرةٌ جداً جداً جداً، أي من ملايين الأبواب يمكن أن تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذلك الإنسان حينما يقوده العِلمُ الله سبحانه وتعالى يطمئنه، فإذا اطمأن على جهله، واطمأنَ على انحرافه، عندئذٍ يدفعه الخوف إلى باب الله عزّ وجل.
بعضهم يقول: ما لنا وللعِلم؟! نحن نأخذُ علمنا من الحيّ الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حيٍّ يموت، عِلمنا من الله مباشرةً، وعِلمكم من أشخاصٍ يموتون، عِلمنا عِلمُ نبعٍ وعِلمكم عِلمُ جمعٍ.
قيلَ لأحدهم: ألا ترحلوا حتى تسمعَ من عبد الرزاق؟ فقالَ: وما أصنعُ بالسماعِ من عبدِ الرزاق من يسمع من الخلّاق؟ هناك أشخاصٌ يحتقرون معرفة الكتاب والسنّة، ما أفعل بهذا؟ أنا لي مشربٌ مباشر من الله عزّ وجل أستقي منه علمي.
هناك من يقول: إن هذا الكلامَ جهلٌ وكلام شيطاني، فلولا هؤلاء الذين نقلوا لك أحاديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنتَ تعرف سُنّته؟ هذه العبادات التي بيّنها النبي وفصلّها أنّى لكَ أن تعرفها لولا أنها نُقلت إليك ورويت لك؟ فهذا الذي يقول: أنا أستغني عن كلِّ علمٍ ظاهريّ، وأنا قلبي موصولٌ بالله عزّ وجل، هذا كلامٌ غير صحيح.
لذلك قالوا: من أحالكَ على غير من أخبرنا وحدثّنا، فقد أحالكَ إما على خيالِ صوفي، أو على قياسِ فلسفي، أو على رأيٍ نفسي، أنتَ ماذا تريد؟ تريد دين الله عزّ وجل، تريد شرعه، تريد قرآنه، تريد سُنّة نبيه، فإذا ألغيتَ الكتابَ والسنّة، أنتَ مع من؟ مع خيال، مع شطحة، مع تجاوز، مع قياس فلسفي، مع رأي نفسي، وأنتَ لستَ مع الكتابِ والسنّة، والله سبحانه وتعالى يقول:
﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32)﴾
الآن موضوع دقيق، هناك عِلمٌ وهناك حال، العلم أن تعرف الله عزّ وجل، أن تعرف ربوبيته، أن تعرف ألوهيته، أن تعرف وحدانيته، أن تعرف أسماءه الحسنى، أن تعرف صفاته الفُضلى، هذا هو العلم، أن تعرف أمره ونهيه، أن تعرف حدوده، أن تعرفَ في كلِّ موقف ماذا ينبغي لكَ أن تفعل؟ هذا هو العلم، وأما الحال أن تشعر بمشاعر مُسعدة، السؤال الآن أيهما خير العِلمُ أم الحال؟ أجابوا عن هذا السؤال بأن نفعَ الحال لا يتعدى صاحبه، هو مسرور وحده، لكن ربنا عزّ وجل قال:
﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)﴾
بينَ أن تكونَ في قلوبِ الآلاف، بين أن يكون أثركَ في قلوبِ المئات والآلاف المؤلفة، بينَ أن يكونَ عِلمكَ قد انتشرَ بين الناسِ كلهم فاستفادوا منه، وبين أن تستمتع وحدك ولا أحدَ معك بهذا الحال، فقالوا: الحالُ لا يتعدى صاحبه، أما العِلمُ كالغيثِ يقعُ على الوديان، والآكام، ومنابت الشجر، العِلم عام بينما الحال خاص، خاصٌ بكَ وحدك، لا ينتقل إلى أهلك، ولا إلى أولادك، ولا إلى جيرانك، ولا إلى أيّةِ جهةٍ أخرى، لكنَ العلم نفعه عميم.
ويقولون أيضاً: دائرة العلم تسعُ الدنيا والآخرة، أما دائرة الحال تضيق عن غير صاحبها، وربما ضاقت عنه، سُميَّ الحالُ حالاً لأنه يتحول، فشيءٌ ليس مضموناً، وشيءٌ ليس ثابتاً، وشيءٌ لا تستطيع أن تنقله للآخرين، وشيءٌ لا تستطيع أن تصرفه، ولا يمكن أن تبيعه، ولا أن تقدمه، شيء خاصٌ بك، لكن الذي يتعلم يؤتيه الله حالاً، لأن الحال ثمرة من ثمار طاعة الله عزّ وجل، إذا أطعته طاعة تامة، من عَمِلَ بما علم أورثه الله عِلمَ ما لم يعلم، إذا أطعتَ الله عزّ وجل في كلِّ شؤونك، في كلِّ حركاتك وسكناتك، عندئذٍ يُتوج الله لكَ هذه الطاعة بحالٍ طيب تسعدُ به، أما إذا بحثتَ عن الحال وحده، وسعيتَ إليه، وأهملتَ ما سواه من العلم والمعرفة والعملِ فهذا الحال لا ينفعك، ولا يغنيك من الله شيئاً.
ويقولون أيضاً: العلمُ هادٍ والحال الصحيح مهتد به، كلّ إنسان إذا حقق هدفه يشعر بحال مسعدة، حتى إن اللص لو سرقَ مالاً كثيراً، ورأى أن هذا العمل عادَ عليه بمبلغٍ كبير، يشعر بنشوة، الحال في تعريفه الدقيق: حينما تصبو إلى شيء وتحققه، تشعر براحة، هذه الراحة ما ميزانها؟ العلم، إذا صبوتَ إلى حق، وحصّلته، وارتحتَ مع الحق، فالعلم يقول لك: هذا حال طيب، أما إذا فعلتَ شيئاً منكراً، وحققته بالتمام والكمال، وشعرت براحة الإنجاز، هذا الحال غير صحيح، هذا حال ليس حالَ أهلِ الإيمان، إذاً العلمُ هادٍ والحال مهتد بالعلم، أي أنتَ بالعلم تعرف ما إذا كان هذا الحال رحمانياً أو شيطانياً، أما أن يأتي الإنسان حالة سرور هذه ممكنة، ممكنة جداً، إذا جاءت حركتك اليومية موافقةً لمهمتك تشعر براحة، أي إذا سافرت إلى بلدٍ أجنبي لتعقد صفقة رابحة، ورأيت البضاعة جاهزةً، وسعرها مناسباً جداً، ووقّعتَ العقد، إذا وقعت العقد ساحَ خيالكَ بالأرباح الطائلة التي سوف تجنيها من هذه البضاعة تشعر براحة كبيرة، تشعر بسرور، هذا السرور بماذا يُقيّم؟ بالعلم، إذا كان العمل مباحاً، لابأس، إذا كان العمل غير مباح، البضاعة محرمة، التعامل مع البضاعة بطريقة غير مشروعة، العلم هو الذي يقيس لك الحال، إذاً العلمُ هادٍ والحال الصحيح مهتد به.
العلم تَرِكةُ الأنبياءِ وتراثهم:
العلم تَرِكةُ الأنبياءِ وتراثهم، الأنبياء لم يُوَرّثوا درهماً ولا ديناراً، ولكن ورّثوا هذا العلم، فمن أخذَ منه أخذَ بحظ وافر، إذاً العلم تراثُ الأنبياء، والذي يتعلم العِلم هو من أهلهم، ومن عصبتهم، ومن ورّاثهم، سلمان منّا آلَ البيت، نِعمَ العبدُ صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، من هم أهل الله؟ الذين تعلموا القرآن، وعرفوا عظمته، وعرفوا أحكامه، العلمُ حياة القلوب، القلب لا يحيا إلا بالعلم، العلم نور البصائر، الله عزّ وجل سمّى كتابه نوراً مبيناً، العلم شِفاءٌ للصدور، إذا عرفتَ هذا الحُكم، إذا عرفتَ أن هذا العمل يرضي الله، هذا لا يرضيه، تشعر براحة، ما دام عملكَ يقع موافقاً لمنهج الله عزّ وجل هناكَ راحة كبيرة.
العلم رياض العقول ولذة الأرواح:
العلم رياض العقول، الإنسان عقل ونفس وجسد، العقل غذاؤه العلم، والجسد غذاؤه الطعام والشراب، والقلب غذاؤه الحب، فإذا لم تتعلم حصل هناك عرج، العرج أي اختلال في التوازن.
العلمُ لذّةُ الأرواح، من ذاقَه عرف، ما من شيء أحبُّ إلى المؤمن من مذاكرةِ العلم، العلمُ لذّةُ الأرواح، العلم أُنسُ المستوحشين، العلم دليل المتحيرين، العلم هو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، العلم هو الحاكم المُفرّق بين الشك واليقين، والغيِّ والرشاد، والهدى والضلال، بالعلم يُعرفُ الله، بالعلم يُعبدُ الله، بالعلم يُذكر الله، بالعلم يوحّدُ الله، بالعلم يحمد، بالعلم يُمجّد، بالعلم اهتدى إلى الله السالكون، من طريق العلم وصلَ إليه الواصلون، من باب العلم دخلَ عليه القاصدون.
طلب العلم أجلُّ وأعظمُ عمل في حياتنا:
أنا أقول لكم ما من عملٍ، والله الذي لا إله إلا هو أجلُّ وأعظمُ وأخطرُ في حياتكم من طلب العلم، وأيُّ علمٍ هذا؟ معرفة الله عزّ وجل، وكيف تعرف الله عزّ وجل؟ يجب أن تعرف القرآن، لأن الله عزّ وجل يقول:
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)﴾
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1)﴾
الكتاب يعدل خلقَ السماوات والأرض، الكون كله في كفة والكتاب في كفة، لذلك إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالبِ العلم رِضاً بما يصنع، بالعلم تُعرف الشرائع والأحكام، بالعلم تُميّز الحلال من الحرام، بالعلم تصل الأرحام، بالعلم تعرف مراضي الحبيب، بالعلم تكون إلى الله قريب، أي العلم هو كلُّ شيء، الطريق السالك الوحيد إلى الله عزّ وجل أن تعلم، أن تعرفه، أن تعرف كتابه، أن تعرفَ سُنّة نبيه، أن تعرف الأحكام الشرعية، أن تعرف سيرة سيد المرسلين، لذلك حينما تنكشف الحقائق، وحينما يُكشَف الغطاء، لا يندم الإنسان في حياته كلها إلا على ساعةٍ مضت لم يتعرّف إلى الله فيها، وقلت لكم دائماً: إن أبواب الدنيا مغلّقة، ولا تدخلها إلا بمبلغٍ كبير، لكن أبواب الحق مفتّحة لكلّ داخل، بلا رسم، وبلا أجر، وبلا صعوبات، وبلا عقبات.
العلم إمام والعمل مأموم، لا يمكن أن يصحَّ عملك إلا إذا صحَّ علمك، لا يمكن أن يصلحَ عملك إلا إذا صلحت عقيدتك، العلم إمام والعمل مأموم، العلم قائد والعمل تابع، العلم هو الصاحب في الغربة، إذا كنت في مكان غريب ومعك شيء من كتاب الله تقرؤه، تدرسه، تُحَدّث به، الصاحب في الغربة والمُحدّث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة.
شخص أقرض إنساناً مبلغاً من المال لشراء بيت، هذا صاحب البيت قال له: سأعطيك أجرة، إنك ساهمتَ معي في شراءِ هذا البيت، ولكَ هذه الأجرة، أخذها وفَرِح بها، فحينما انتهت مدة القرض أعاد المبلغ إلى صاحبه، وقطعَ عنه الأجرة، والله أخي أنا اشتريت وقبضت أجرة، أكل الرِبا وهو لا يدري، هذه الشبُهة، شبهة أنها أجرة، لا، هذا رِبا، أما الأجرة تتملك هذا البيت، وتأخذ أجرة حصتك منه، فإذا أردتَ أن تستردّ ثمن حِصتكَ يُقيّمُ البيتُ تقييماً جديداً، وإذا هَلَكَ البيت فعليك لا على ساكنه، فالعلم يكشف لك الشُّبهات.
والغِنى الذي لا فقر على من ظَفِرَ بكنزه بعده، والكنف الذي لا ضيعةَ على من آوى إلى حِرزهِ، هو غِنىً وملجأ، مذاكرته تسبيح، البحثُ عنه جهاد، أي حينما تأتي من مكانٍ بعيد لتتعلم العلمَ الصحيح، فهذا السير إلى هذا المكان، أو إلى أيّ مكان آخر جهاد، البحث عنه جهاد، طلبه قُربة، بذله صدقة، بذله ومُدارسته تعدِل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من حاجتك إلى الطعامِ والشراب.
الإمام أحمد يقول: الناس إلى العلم أحوجُ منهم إلى الطعامِ والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه،
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ. ))
[ صحيح الترغيب : حسن صحيح ]
كلمة، نظرة، نظرةٌ فيها عدوان، وكلمةٌ فيها سخرية، ونظرة فيها استهزاء، ومشاعر شيطانية، ما الذي يكشف لك هذا؟ هو العلم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلبُ العلم أفضلُ من الصلاة النافلة، وأبو حنيفة يرى هذا الرأي، وقالَ ابن وهبٍ: كنتُ بين يدي الإمام مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي، أي دفاتري، وقمت لأصلي، فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمتَ عنه؟
﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)﴾
في آية أخرى:
﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)﴾
في بعض الآراء يجوز أن نقف عند قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ بل الرأي المتوازن أنكَ إذا أردتَ بتأويل الآيات المتشابهات، أو الآيات التي تتحدث عن ذات الله عزّ وجل يجب أن تقف عند: ﴿ومايعلم تأويله إلا الله﴾ أما إذا أردتَ القرآن الكريم ما هو واضح الدلالة، لك أن تقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ .
العلماء الصادقون ينفون عن العلم تحريف الغالين وتأويل المُبطلين:
العلم كما نُقِلَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف:
(( يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ، وانتحالَ المبطلينَ، وتأويلَ الجاهلينَ. ))
[ السفاريني الحنبلي: القول العلي: خلاصة حكم المحدث : صحيح ]
﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)﴾
هناك من يغلو في الدين، فالعلماء الصادقون ينفون عن العلم تحريف الغالين وتأويل المُبطلين، هو حجةُ الله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائد العباد إلى الله عزّ وجل، ودليلهم إلى جنته، ويكفي من شرفه أن فضلَ أهله على العباد كفضلِ القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكواكب، فضلُ العالم على العابد كفضلِ القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكواكب، ولقد رحلَ كليمُ الله موسى عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النَّصب في سفرهما، في طلبِ العلم، حتى ظَفِرَ بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم، ويكفي شرفاً لمن يطلب العلم أن الله سبحانه وتعالى أمرَ نبيه الكريم فقال: ﴿وقل ربي زدني علماً﴾ .
هذه مقدمة، مقدمة في فضل العلم، من أرقى المنازل في طريق الإيمان، لكن العلم نوعان، نوعٌ جليّ ونوعٌ خفيّ؛ النوع الجليّ على أنواعٍ ثلاث أحدها علمٌ تتعلمه بالحواس الخمس، سمّاه بعض علماء العقيدة: اليقين الحسي، أنتَ ترى بعينكَ هذه المصابيح متألقة، وهذا المسجد نظيف، أنتَ تُحسّ أن هذا الجو معتدل، تسمع أنَّ هذا الصوت صوت فلان، هناك معارف جليّة تتوارد إليك عن طريق الحواس، هذه سماها العلماء: اليقين الحسي، وهناك معارف تتوارد إليك عن طريق التعلّم، كلكم آذان صاغية إلى ما أقوله، هذه طريقة أخرى من طرق التعلُّم، طريقة السمعيات أن تُلقي السمعَ:
﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)﴾
فالأذن مسلكٌ من مسالك العلم، أي إما أن تتأمل وإما أن تأخذَ الحقائقَ جاهزة، والنوع الثالث هو العلم الذي يأتيك عن طريق الاستدلال العقلي، وهذا يسمى أيضاً اليقين الاستدلالي، صار عندنا يقين إخباري ويقين استدلالي ويقين حسي، يقين حسي عن طريق الحواس الخمس، يقين استدلالي عن طريق العقل، يقين إخباري عن طريق الأذن، رأيتُ أو سمعتُ أو فكرتُ، حتى إن بعضَ المفسرين يقول: إذا جاءت كلمة الفؤاد بعد السمع والبصر فإنما تعني الفِكر:
﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)﴾
إذاً عندك علمٌ جليّ وعلمٌ خفيّ، العلم الجليّ ما جاءكَ عن طريق الملاحظة، عن طريق الحواس الخمس، أو ما جاءك عن طريق السماع، أو ما جاءك عن طريق الاستدلال العقلي، وقد يأتيك العلم عن طريق المشاعر، وقد يأتيك عن طريق الاستنباط، أو عن طريق الاستنتاج، هناك طرائق كثيرة يأتيك العلم منها، هذا هو العلم الجليّ، الذي قيل: من عَمِلَ بما عَلِم، تعلّمت من مجلس عِلمٍ أن النظرة إلى النساء محرمة، تعلّمت في مجلس العلم أن نقلَ الكلام إلى جهةٍ قيلَ الكلام فيه نميمة، وهذا محرم، هذا إذا عَمِلتَ بما علمت، الآن علّمكَ الله عِلمَ ما لم تعلم.
قال: والعلم الثاني هو العلم الخفيّ، علم القلب، والحديثُ عنه شيّق، العلم الجليّ يحتاج إلى مُدارسة، يحتاج إلى مطالعة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى سماع، لكن إذا طبقّتَ كلَّ ما عرفته عن الله عزّ وجل، هناكَ شيء ثمينٌ جداً يتوارد إليك.
قال: هذا العلم الخفيّ ينبت في القلوب الطاهرة، أي من بعض معاني هذه الآية:
﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾
أي هذا العلم الخفيّ الذي يُكرم الله به بعضَ العباد، هذا ثمنه القلب الطاهر، عبدي طهّرتَ منظرَ الخلق سنين أفلا طهرّتَ منظري ساعة؟ ما هو منظر الله عزّ وجل؟ هو القلب:
﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)﴾
إذاً هذا العلم لا ينبت إلا في القلوب الطاهرة التي في الأبدان الزكية، معنى الزكية التي ما أكلت حراماً قط، يا سعدُ، أطب مطعمكَ تكن مستجاب الدعوة، قلب طاهر نقي على بدن زكي، أي غُذيَّ بالحلال، ما أكلَ حراماً.
وهذا العلم يحتاج إلى رياضةٍ خالصة، الرياضة تدريبات شاقة من ذكرٍ لله عزّ وجل، من صلاة النوافل، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من خدمة الخلق، هذه سماها بعض علماء القلوب: الرياضة، قلبٌ طاهر، وبدنٌ زكي، ورياضة خالصة، وهِمةٌ عَلِيّة، وأسماع صاغية، هذه بعض شروط العلم الخفي، الذي نوّهَ به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من عَمِلَ بما علم أورثه الله عِلمَ ما لم يعلم، هذا معنى قوله عزّ وجل:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)﴾
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)﴾
ما الفرقان؟ النور، هذا النور يقذفه الله في القلب، ما ثمنه؟ تقوى الله عزّ وجل، ما تقوى الله؟ طاعته، أي إن تطيعوا الله عزّ وجل يقذف الله في قلوبكم نوراً، ترون به الخير خيراً والشر شراً، إذاً هذا العلم الخفي يسميه العلماء تارة المعرفة، ويسميه العلماء تارةً الإلهام، ويسميه العلماء تارةً البصيرة، ويسميه تارة الحِكمة، فالحِكمة والبصيرة والإلهام والمعرفة أسماء لمسمى واحد، أي إما أن يكون العِلمُ كسبيّاً أو إشراقيّاً، العلم الكسبيّ ثمنه المُدارسة، وثمنه طاعة الله عزّ وجل، أما العلم الإشراقي فهو الذي سنتحدثُ عنه قليلاً في هذا الدرس.
طبعاً كما قلتُ قبل قليل قلب طاهر، قلبٌ فيه غِلّ، فيه حِقد، فيه حسد، فيه كِبر، فيه استعلاء، هذا القلب لن يقذف الله به نوراً أبداً، لن يتجلى عليه أبداً، لن يُتْحفَ صاحبه بمعرفةٍ إشراقية أبداً، طهّر قلبك ليكون بيتَ الرب، طهّر قلبك ليكون أهلاً أن يقذف الله به نوراً.
الشيء الآخر؛ الأبدان الزكية، استقم في عملك، أي المال الذي في حوزتك هذا من كسبك، كيف كسبتَ هذا المال؟ هل كسبتَ هذا المال من طريق مشروع أو غير مشروع؟ مَن أصاب مالاً مِن مَهاوشَ أذْهَبَه اللَّه في نَهابِرَ، إذا كان كسبُ المال مشروعاً والقلب طاهراً والبدن زكياً، هل تقرّبتَ إلى الله بالنوافل؟
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال الله تعالى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ؛ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأعْطِيَنَّهُ، وإن استعاذ بي أعذته، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. ))
إذاً من كانت له هذه الرغبة الجموح، وهذا الإلحاح الصادق، في أن يصلَ إلى شيءٍ من العلم الخفيّ الذي عبّرَ الله عنه بالحِكمة تارةً، وبالبصيرةِ تارةً، وبالمعرفةِ تارةً، وبالإلهامِ تارةً، إذا أردت هذا العلم فدونك الثمن، قلبٌ طاهر، بدنٌ زكي، رياضةٌ خالصةٌ لله عزّ وجل، لا ليعرف الناس أنك صليتَ قيام الليل، لا ليعرف الناس أنكَ أحسنتَ إلى فلان، لا، رياضةٌ خالصةٌ للهِ عزّ وجل، وبعد هذا وذاك هِمةٌ عَلِيّة، المنافقون:
﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142)﴾
وأسماعٌ صاغية، أي عندئذٍ يسمعكَ الله عزّ وجل ما لا يسمع الآخرين، يريكَ ما لا يُري الآخرين، قال: يا صاحبَ رسول الله نافقت؟ قالَ: كيف ذلكَ يا حنظلة؟ قال: أكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنَّا الأهلَ ننسى، قالَ: انطلق بنا إلى رسول الله، ماذا قالَ عليه الصلاة والسلام؟
(( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَوَعَظَنَا، فَذَكَّرَ النَّارَ، قالَ: ثُمَّ جِئْتُ إلى البَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ المَرْأَةَ، قالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذلكَ له، فَقالَ: وَأَنَا قدْ فَعَلْتُ مِثْلَ ما تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقالَ: مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بالحَديثِ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قدْ فَعَلْتُ مِثْلَ ما فَعَلَ، فَقالَ: يا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، ولو كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كما تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ المَلَائِكَةُ، حتَّى تُسَلِّمَ علَيْكُم في الطُّرُقِ. وفي رواية : كُنَّا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَذَكَّرَنَا الجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِهِمَا.))
ولزارتكم في بيوتكم، إذاً قلبٌ سليم من البغضاء، من الحسد، من التعالي، من الكِبر، من الأنانية، بدنٌ زكيٌ من المال الحرام، مُطَهّر، كسبٌ حلال، رياضةٌ خالصة، هِمةٌ عَلِيّة، آذان صاغية، عندئذٍ تنالُ شيئاً من هذا العلم الخفيّ الذي خصَّ الله به أحبابه.
تعلق همة الأنبياء بشيئين:
قالَ: هِمةُ الأنبياء تعلّقت بشيئين، تعلّقت بالعليّ الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، وتعلّقت بصلاح الخلق، كلما ارتقت مرتبتك اتسعت دائرة اهتمامك، مثل حسيّ، اصعد إلى هذا الجبل، كلما صعدت مسافة اتسعت دائرة الرؤية، فإذا وصلتَ إلى قمة الجبل رأيتَ دمشقَ كلها، كلما ارتفعتَ نحو الأعلى اتسعت دائرة الرؤية، وكلما ارتقيت إلى الله عزّ وجل اتسعت دائرة اهتمامك، وكلما هبطت المرتبة ضاقت دائرة اهتمامك، يقول الناس مثلاً: أخي يُباعوا بالعزاء، ماذا تريد من الناس؟ اتركهم واجلس، هذا الكلام يقوله إنسان هكذا يشعر، مادمت أجد طعامي، وشرابي، وبيتي، وأهلي، وأولادي، فأنا بخير وعلى الدنيا السلام، أما النبي عليه الصلاة والسلام قال:
(( عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، والله لَوْ تعلمون مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَما تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُش، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، لوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ. ))
قال: اللهم اهدِ قومي إنهم لا يعلمون، فإذا لم تشعر بعاطفةٍ نحو كلِّ مخلوق، فالمرتبة متعتعة.
الإلهام هو ما يعنيه العِلمُ الخفيّ:
شيء آخر؛ الإلهام هو ما يعنيه العِلمُ الخفيّ، الإلهام، الإلهام هو فهم خاص، هو ثمرة من ثمرات العبودية لله عزّ وجل، الإلهام جزاء الصدق مع الله، ثمرة للعبودية، جزاء الصدق مع الله، الإلهام كما ورد في قول الإمام عليٍّ كرّمَ الله وجهه حينما سُئل: هل خصّكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ دون الناس يا آل بيته؟ فقال الإمام عليٌّ كرّمَ الله وجهه: لا، ما خصّنا بشيء، والذي فلقَ الحبَّ وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه:
﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21)﴾
هذا عطاءٌ عظيم أن تفهم كتاب الله، أن تفهم حقيقة الآيات، مراميها البعيدة، مدلولاتها الصحيحة، هذا شيء عظيم جداً، فهذا أيضاً من العلم الخفيّ الذي يُعّدُ نتيجةً لتطبيق العلم الجلي، كلُّ هذا الدرس وإلى دروسٍ كثيرةٍ إن شاء الله محور هذه الدروس من عَمِلَ بما عَلم أورثه الله عِلمَ ما لم يعلم.
لا تطمع بهذه المعرفة، لا تطمع بهذا الإلهام، لا تطمع بهذه البصيرة، ولا بالحكمة، إلا إذا دفعتَ الثمن، والثمن أن تتعلم العِلمَ الجلي، وأن تُطبقه، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، العارية، الوكالة، الكفالة، هذه العلاقات الاجتماعية لابد من أن تكون وفقَ الشرع، إذا طبقتَ الشرع منَّ الله عليك بشيء آخر.
من كان متبعاً لرسول الله فيجب أن يدعو على بصيرة:
هذا العلم الخفيّ يسمى أيضاً بصيرة، والدليل قول الله عزّ وجل:
﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108)﴾
فكلُّ من يدعو إلى الله عزّ وجل بلا بصيرة فهو في نص هذه الآية غير مُتّبعٍ لرسول الله، ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ إذاً إذا كنتَ متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تدعو على بصيرة.
شيء آخر؛ قد نُسَمّي هذا العلم، أي معنى بصيرة أن تعرف المُراد، أن تعرف فكرة دقيقة عن فلسفة الوجود، عن سرِّ الحياة، عن سرِّ وجود الإنسان في الدنيا، هكذا يقولون، نظرية الكون والحياة والإنسان، أين كنت؟ إلى أين المصير؟ ما جدوى الحياة الدنيا؟ ما أفضل شيء تفعله في الدنيا؟ هذه البصيرة.
أما الحِكمة فلنا عندها وقفةٌ متأنية، الحكمة يقول الله عزّ وجل:
﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)﴾
بنصِ القرآن الكريم: ﴿ومن يؤت الحِكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ قال: الحِكمة في كتاب الله نوعان، قد تأتي مفردةً وقد تأتي مع الكتاب:
﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)﴾
إن جاءت مفردةً فلها معنى، وإن جاءت مع الكتاب فلها معنى آخر.
قال: الحِكمة منفردة هي النبوة، أو هي علم القرآن، أو هي-كما قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما-علمُ القرآن ناسخه ومنسوخه، مُحْكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله، الحِكمة منفردة النبوة، الحكمة منفردة أن يعلمك الله القرآن بكلّ ما تعني هذه الكلمة.
وقال الضحاك: الحِكمة هي القرآن والفهم فيه.
وقال مجاهد: هي القرآن والعِلمُ والفِقهُ.
وقالَ بعض العلماء: هي الإصابة في القولِ والعمل، أن يأتي قولكَ صحيحاً مصيباً، وعملكَ صحيحاً مصيباً.
وقال بعض العلماء: هي معاني الأشياء وفهمها.
وقال الحسن، تحدث عن مؤدى الحكمة، قال: الورعُ في الدين، هذه مؤداها، أما إذا جاءت الحِكمة مع الكتاب فتعني السنّة، ﴿يعلمهم الكتاب والحِكمة﴾ أي السنّة، لأن الله عزّ وجل يقول:
﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)﴾
الله سبحانه وتعالى بيّنَ أن النبي عليه الصلاة والسلام من مهمته الأساسية أن يبيّنَ للناسِ ما نُزّلَ إليهم، فحيثُما جاءت الحِكمة مع الكتاب فهي السنّة، كذلك قال الإمام الشافعي: الحِكمة مع الكتاب هي السنّة، قال: أجمل ما قيل في الحِكمة هو قول الإمام مجاهد: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة بالقولِ والعمل.
الحِكمة حكمتان؛ حِكمة علميةٌ وحِكمةٌ عملية:
الحِكمة حكمتان: حِكمة علميةٌ وحِكمةٌ عملية، فالحِكمة العلمية أن تطلّعَ على بواطن الأمور، أن تعرف الخلفيات، أن تعرف ما بين السطور، أن تعرف المدلولات، أن تعرف القصد البعيد، أن تعرف المؤدى، هذه حِكمةٌ علمية، وأما الحِكمة العملية فهي أن تضعَ الشيء في موضعه، أن تضعه في حجمه، وفي موضعه، وفي أوانه من دون زيادة أو نقصان، أو تعجيل أو تأخير.
أحياناً تقول لفلان: واللهِ ما أحكمك! بحجمه، وفي وقته، وفي مكانه، من دون زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، من طلبَ الشيء قبلَ أوانه عوقِبَ بحرمانه، أي ما كلُّ ما يُعْلم يقال، وما كلُّ ما يُقال له رجال، ولا إذا وجِدَ الرجال آنَ الأوان، هناك شيء يُعلم ولا يُقال، هناك شيء يُقال لكن لا لكلِّ الناس، هناك شيء يُقال لزيد، لكن لا في هذا الظرف، في ظرف آخر، فيحب أن تعرف ماذا ينبغي أن تقول، ولمن تقول، وفي أيّ وقتٍ تقول، هذه الحكمة، يُقَابل الحِكمة الطيش والحمق، لذلك فسّروا الحِكمة بقولهم: الحِكمة فِعلُ ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
استمرار العلم والحكمة مع الإنسان إلى أبد الآبدين:
الحقيقة هذا الدرس ليسَ هدفه أخذَ العِلم، لا والله، هدفه الحفز، أي أن يندفع الإنسان إلى طلبِ المزيد، لا أن يكتفي بأنه صلّى، وصام، وفعلَ ما أُمر بشكلٍ شكلي، مُفرّغ، أجوف، لا ينبغي أن يبقى على هامش الدين، أن يغوصَ في أعماقه، فإذا عَمِلتَ بما عَلمت علّمكَ الله عِلمَ ما لم تعلم، وعِلمُ ما لم تعلم هو الحِكمة، انظر؛ الله عزّ وجل أعطى فِرعون المُلك وهو لا يحبه، وأعطى قارونَ المال وهو لا يحبه، ولكن هؤلاء الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟
﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22)﴾
هذا الثمن، كن مُحسناً يؤتِكَ الله حُكماً وعِلماً.
بالمناسبة أيُّ شيء تفتخر بملكه تتركه عند الموت، لكن العلم والحِكمة يستمران معك إلى ما بعد الموت، وإلى أبدِ الآبدين، لذلك قرأت كلمةً في إحدى المدارس من أقدم الثانويات في دمشق، بخطّ أكبر خطاط في مدخل الثانوية، كلما وقعت عيني على هذه اللوحة أشعر بخشوع خاص: رتبةُ العِلمِ أعلى الرتب، أعلى رتبةٍ تصلها أن تعرف الله عزّ وجل، فإذا عرفته عرفت كلَّ شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدتَ كلَّ شيء، وإن فِتكَ فاتكَ كلّ شيء، وأنا أحبُّ إليكَ من كلِّ شيء، يا رب ماذا فقد من وجدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل ترفع السيدة عائشة رجليها، قال: لأن غرفته الصغيرة لا تتسع لصلاته ونومها.
ماذا قال سيدنا عليّ؟ قال: فلينظر ناظرٌ بعقله أنَّ الله أكرمَ محمداً أم أهانه حينَ زوى عنه الدنيا؟ فإن قالَ: أهانه فقد كذب، وإن قال: أكرمه فلقد أهانَ غيره حيثُ أعطاه الدنيا.
النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة، هو في الخامسة والعشرين، وهي في الأربعين، ما قولكم؟ وبقيَّ معها خمسة وعشرين عاماً، ربع قرن، ما فَكّرَ في أخرى، الإنسان الآن تكون سنّه مقاربة لسنّ زوجته يندب حظه دائماً، يقول لك: تزوجتها كبيرة، ما انتصحنا، يجب أن تعرف ما هو المقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام نال كل شيء، يا رب ماذا فقد من وجدك؟ أي عاش بدخل محدود؟ أي سكن ببيت صغير؟ أي كان حجمه الاجتماعي قليلاً؟ ما كان لامعاً؟ يا رب ماذا فَقَدَ من وجدك؟ وماذا وجدَ من فَقَدك؟ والذي ما عرفك، قرأتُ مرةً كلمة، قال: مساكين أهلُ الدنيا، جاؤوا إلى الدنيا وخرجوا منها وما عَرَفوا أجملَ ما فيها، إنَّ أجملَ ما فيها معرفة الله عزّ وجل، والأُنس به، والقُربُ منه.
فيا أيها الإخوة الأكارم؛ ليسَ القصد من هذا الدرس أخذُ العِلم، القصد هو الحفز إلى الله، والأبواب مُفتَّحة، أبواب الجنة مفتّحةٌ على مصارعها، أبواب جهنم ليست مفتّحة، هل تستطيع أن تسهر في فندق من دون دفع الآلاف؟ أبواب جهنم باهظة، ثمنها باهظ، أما أبواب الجنة مفتوحة مجاناً، هل أحد منكم قطع كرتاً عندما دخل إلى هنا؟ أبداً، أبواب الجنة مفتّحةٌ على مصارعها في الدنيا، قيل: اشتقتُ لأحبابي، قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أُناسٌ يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر سبعين، قالوا: مِنّا أم منهم؟ قال: بل منكم، قالوا: ولِمَ؟ قال: لأنكم تجدونَ على الخير مِعواناً ولا يجدون.
الملف مدقق