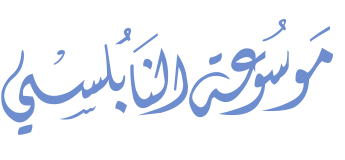الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة نوحٍ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(1)﴾
إن الله جلَّ جلاله يتحدَّث عن ذاته العليِّة تارةً بضمير المُفْرَد، وتارةً بضمير الجمع، قال بعض العلماء: إنْ تحدَّث عن أفعاله كان الحديث بضمير الجمع، وإنْ تحدَّث عن ذاته كان الحديث بضمير المفرد.
﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ(14)﴾
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾
﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ(9)﴾
﴿ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍۢ(49)﴾
أفعال الله جلَّ جلاله تدخل فيها أسماؤه الحسنى كلُّها، وإن كل أفعاله رحمةٌ، وحكمةٌ، وعدلٌ، ولطفٌ، وعلمٌ، وقوةٌ، ورأفةٌ، أسماؤه الحسنى كلها متمثلة في أفعاله، وهذا أول شيء أود ذكره.
إرسال الرسل من رحمة الله:
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ فلو كان توتر التيار الكهربائي في بيتك (مائة وعشرة)، ثم بُدِّل إلى مائتين وعشرين، وأبلغتك المؤسسة أن هذا التيَّار خطِر، فلو كان هناك إنسان يمشي على أرضٍ فيها ماء ولَمَسَتْ يده التيار فقد يموت، فهل هناك أبٌ على وجه الأرض يبقى ساكتاً، أم أنه سيحذِّر أولاده وزوجته ويبين لهم ذلك؟ إن من لوازم رحمة الأب أن يبَيِّن لأهله الأخطار المحدقة بهم، وهذا حد أدنى، وربنا عزَّ وجل ذو الرحمة، ومن لوازم رحمته جلَّ جلاله أن يبيِّن لعباده دائماً، من آدم إلى يوم القيامة.
﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7)﴾
لكل قومٍ هاد على مدى الدوران، فسيدنا نوح أُرسِل إلى قومه، أي: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ إن إرسال الرسل دليل رحمة الله عزَّ وجل، فالتيار مائتين وعشرين تيار خطِر، وقد يؤذي الأولاد، فالأب يبيِّن، فإذا كان جالساً واقترب أحد أولاده من المأخذ الكهربائي ووضع يده على هذا المأخذ فماذا يفعل الأب؟ إنه يقوم ويصرخ ويأخذه ويبعده، فهذا المثل.
﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60)﴾
وربنا عزَّ وجل يبيِّن ويربي، يبين تارةً ويربي تارةً أخرى، فإذا كان هناك حركة نحو المعصية فإن ربنا عزَّ وجل يؤدِّب وينهر ويردع ويخوِّف، وإذا لم يكن هناك حركة نحو المعصية فهناك بيان، فمن لوازم رحمة الله جلَّ جلاله أولاً أنه يُرسل إلى كل خلقه، ويرسل الأنبياء تارةً، والمرسلين تارةً أخرى، ومعهم الكتب والمعجزات، ويسخِّر العلماء، والدعاة، والخُطباء، والمدرِّسين، كما يُنذر بأفعاله، ويحذِّر من خلال أنبيائه، فإرسال الأنبياء أحد مظاهر رحمة الله جلَّ جلاله.
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ الإنذار يعني أن هناك خطراً متوقَّعاً، (احذر هذا الخطر)، فربنا عزَّ وجل حينما ينذرنا فهو ينذرنا من خطرٍ متوقَّع، قال تعالى:
﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ(20)﴾
أي: أنت أيها الإنسان لست كهذه الورقة التي تخضر، ثم تصفر، ثم تيبس، ثم تذروها الرياح، أنت مكلَّف ومن لوازم التكليف المسؤولية، فلو أن هناك شاباً لا ينتمي إلى أي مدرسة، وأمضى وقتاً في النوم أو في النُزُهُات، فهو لا شيء عليه، أما طالب العلم فعنده امتحانات وهناك رسوب ونجاح ومسؤولية، ولأن الإنسان قد اختار حمل الأمانة، ولأنه مكلَّف ومعه منهج، ولأن الله عز وجل سيسأله، فإن سمت نفسه على شهوته كان فوق الملائكة، لذلك كان هناك إنذار، فالإنسان من دون تكليف وأمر ونهي وأمانة يحملها لا يوجد عليه شيء، فلا يكون مؤاخذاً، لكنه حمل الأمانة، وكلَّفه الله بتزكية نفسه، وأعطاه وعداً بمغادرة الدنيا ووقتاً آخر للحساب والعذاب، فالإنسان يجب أن يُنْذَر..
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ في آيةٍ أخرى يقول الله عزَّ وجل:
﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ(37)﴾
النبي هو النذير، والرسول هو النذير، والقرآن هو النذير، والكتاب السماوي هو النذير، وإذا بلغ الإنسان سن الأربعين ومال الميزان فهذه السن تُعَدُّ أيضاً هي النذير، وإذا بلغ الستين فقد صار بينه وبين مغادرة الدنيا قاب قوسين، وهذه السن تعدُّ من النذير، وإذا أصابته مصيبةٌ فهي تعدُّ من النذير، وقد قال لي أحد الإخوة الكرام اليوم عقب خطبة الجمعة أن سبعين بالمائة من الناس عندهم آلام مفاصل بعد سن الستين، فقلت له بطرفةٍ: كأن هذه الآلام التي يُصاب بها الإنسان تذكرة من الله، فينحني ظهره، ويشيب شعره، ويضعف بصره، ويغيِّر أسنانه، فكأن هذه المظاهر والآلام الجديدة تذكرةٌ لطيفةٌ من الله: أنْ يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، فهل أنت مستعدٌ لهذا اللقاء؟
فالنذير؛ أولاً الأنبياء هم النُذُر والمرسلون، والكتب السماوية، والقرآن، وأي كتابٍ نزل على رسولٍ كان قد أرسله الله لقومه نذير، سن الأربعين وسن الستين نذير، والمصائب نذير، وموت الأقارب نذير، فكم من إنسان كان ملء السمع والبصر ثم يغادر الدنيا بلحظةٍ واحدة، ويصبح خبراً وحديثاً، أين هو؟ تحت أطباق الثرى، فالموت نذير، والمرض نذير، وموت الأقارب نذير، والشَيْبُ نذير، وسن الستين نذير، والأربعون نذير، والكُتُب نذير، والأنبياء نُذُر، والمرسلون نُذُر.
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ إذا رأيت لوحةً تشير إلى خطر أمامك في تحويلة، ألا تحس أن هذا الذي وضع هذه اللوحة رحيم؟ إنك قد تسير في طريق السفر بسرعة كبيرة جداً، ولولا هذه اللوحة بأن هناك تحويل لتفاجأت ووقعت في حادث، فتوضع لك قبل ألف متر لوحة كبيرة، وقد تكون مُضاءة أو تكون ذات إشعاع: أن هناك تحويلة انتبه، لقد كنت مرة في بلد، وقد وضعت في أحد طرقاتها قبل ثلاثة آلاف متر لوحة وقد كانت تقريباً مترين بمترين، فوسفورية، ومكتوب عليها عبارة: (هناك مطب انتبه)، لقد وضع هذا قبل ألفين أو ألف أو خمسمائة، فكلها لوحات كبيرة ومضاءة، فالإنسان ينتبه عندئذ، فقلت: هذه رحمة بالإنسان.
ومرة رأيت جسراً عليه أجراس، فلم أعرف لماذا؟ ثم تبين أن هذا الجسر قد أقيم قبل جسر حقيقي، فالذي معه حمولة عالية يسمع صوت الأجراس، انتبه، الجسر القادم لن تستطيع أن تمرَّ من تحته، لسوف تفسد هذه الحمولة، وهذه إنذارات، فالإنذار شيء ينطلق من رحمة وحرص.
﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(128)﴾
فربنا عزَّ وجل يبيِّن و يُنذِر الإنسان إذا تحرَّك حركة خاطئة.
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
إن لم تؤمن بالله فلن تستقيم على أمره:
والشيء الذي يلفت النظر هو أن أركان الإيمان خمسة: "أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي" وإن أكثر ركنين مترافقين في كتاب الله هما الإيمان بالله واليوم الآخر ، لأنك إن لم تؤمن باليوم الآخر فلن تستقيم على أمر الله، لذلك كانت كل الدعوات إلى الله تركِّز على الإيمان باليوم الآخر، والشيء الذي لا يصدَّق أن هناك من الناس مَن يرتكب المعاصي والآثام، ويأكل المال الحرام، ويكيد بعضهم لبعض، وكأن الله لن يسأله، وكأن الله لن يُحاسبه، وكأنَّه متفلت من عذاب الله، ومعنى ذلك أن إيمانه باليوم الآخر ضعيف.
وأحياناً إذا كان هناك إنسان يؤمن بقوة إنسان آخر، ويعلم أن هذا الشخص له عقابٌ أليم ولن يعفو عنه، فإنك تجده ينضبط، فلو آمنت بإنسان قوي من بني جلدتك يحاسِب حساباً عسيراً فإنك تستقيم على أمره، فكيف إذا آمنت بالله، وأن هناك يوماً آخر؟ فإذا ذهبت إلى ما في حياتنا من مشكلات، ومن دعاوى كيدية، ومن اغتصاب أموال، ومن أكل مال حرام، فكأن هذا الإنسان الذي يعصي الله لن يحاسب ولن يموت، وكأن الله عزَّ وجل لن يسأله، مع أن الله عزَّ وجل يقول:
﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)﴾
العبث يتناقض مع وجود الله:
أيها الإخوة الأكارم، حينما تؤمن بالعبثية فالعبثية تتناقض مع وجود الله، والعَبَثْ يعني أن الكون خُلِقَ بلا هدف، والله عزَّ وجل ينكر هذا المعنى، قال تعالى:
﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ(115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ(116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُون(117)﴾
فينبغي أن تنفي فكرة العَبَثْ، فهناك حسابٌ دقيق، لكن الإنسان يؤمن بعقله باليوم الآخر، لكنه يرى بعينه بيوتاً ومركبات، ونساء كاسيات عاريات، ومطاعم فَخْمَة، فالإنسان يجب أن يعرف الأمور بعقله، أما الحيوان فهو يعرف الأمور بعينه، وهناك من يرى بعينه الشهوات وينغمس فيها ويبعد عقله عن إدراك الخطر البعيد. وأوضح مثل هذا المدخِّن، وضرر التدخين شيء مفروغ منه، فمن الحقائق القَطْعِيِّة أن هذا الدخان ينتهي بصاحبه إلى أمراضٍ بالقلب والشرايين، أو بالأورام في الرئتين، أو بالأوعية، فلماذا يفعل هذا؟ لأنه يعيش لحظته، ولم يفكِّر، يقول عليه الصلاة والسلام:
(( إن عمل الجنة حزنٌ بربوةٍ، وإن عمل النار سهلٌ بسهوة. ))
شخص يركب درَّاجة فوجد في الطريق منحدراً شديد الانحدار، وراكب الدراجة يرتاح طبعاً لهذا الطريق، أما لو علم أن في نهاية المطاف حفرةً سحيقةً مالها من قرار، فيها وحوشٌ مفترسة فإنه قد يترك هذا الطريق المُريح، وقد يصعد طريقاً متعباً ينتهي بقصر منيف (إن عمل الجنة حزنٌ بربوةٍ، وإن عمل النار سهلٌ بسهوة) .
﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أيها الإخوة الكرام، المشكلة هنا أن المؤمن يعيش المستقبل، وغير المؤمن يعيش الحاضر، كنت أروي قصةً موجودة في بعض كتب الأدب، وهي قصة رمزية تقول أن صيادَين مرّا على غدير، فرأيَا في هذا الغدير ثلاث سمكات؛ كيِّسةٌ و أكيسُ منها وعاجزة، فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قولهما؛ فأمّا أكيَسُهنّ فارتابت وتخوَّفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، فخرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت، وهذه أعقل واحدة، وأما الكيِّسة (الأقل عقلاً) فبقيت في مكانها حتى عاد الصيَّادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت صديقتها فإذا بالمكان قد سُّد، فقالت: فرَّطت وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي، ثم أنها تماوتت فطفَت على وجه الماء، فأمسكها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت، وأما العاجزة فلم تزل في إقبالٍ و إدبارٍ حتى صِيدَتْ، ومعنى ذلك أن هناك إنسان كَيِّس، وإنسان أكيس، وإنسان عاجز، والكيِّس يحتاط للأمور قبول وقوعها، والأقل عقلاً يحتاط عند وقوعها، والعاجز لا يحتاط قبل وقوع الأمور ولا بعد وقوعها ولا أثناء وقوعها، تراه (يحوص)، فلم تزل هذه السمكة في إقبالٍ وإدبارٍ حتى صيدت، فماذا قال النبي الكريم؟
(( الكيِّس مَن دانَ نفسَه وعمِل لما بعد الموتِ والعاجزُ مَن أتبعَ نفسَه هَواها وتمنَّى على اللهِ الأمانيَّ. ))
[ تخريج الكشاف بسند ضعيف ]
فقد ضبط دخله، وإنفاقه، وعينه، ولسانه، وسمعه، ويده، ورجله، وضبط أعضاءه، وحواسه وبيته وعمله (الكيِّس مَن دانَ نفسَه وعمِل لما بعد الموتِ والعاجزُ مَن أتبعَ نفسَه هَواها وتمنَّى على اللهِ الأمانيَّ) فأكاد أقول لكم: إن الكافر يعيش بحواسِّه لحظته الحاضرة، والمؤمن يعيش بعقله المستقبل، وهذا هو الفرق، فبالعقل يصل الإنسان إلى الشيء قبل أن تصل إليه.
شخص كان يركب مركبة، فلو أنه ألقى نظرةً على مؤشِّر الوقود ورآه قُبَيْلَ الأخير، فإنه يملأ المستودع في أول محطة وقود، أما لو لم ينظر إطلاقاً فمتى سيعلم بانتهاء الوقود؟ حينما ينتهي هذا الوقود، وهناك أمكنة لا يوجد فيها محطة وقود، فإذا تعاملت مع الحواس فالمركبة تسير إلى أن تقف، لكنها تقف في مكان غير مناسب، لعدم وجود محطة وقود، فقد يقف ساعتين أو ثلاثة، أما حينما تلقي نظرةً على مؤشِّر الوقود وتفكر قائلاً: بقي خمسين كيلو، تفكر في محطة وقود. لذلك أقول مرة ثانية: المؤمن يتعامل مع المستقبل بعقله، والكافر وغير المؤمن يتعاملان مع الحاضر بحواسّهما، لذلك هناك شهوات، فأي شيءٍ يلبّي هذه الشهوات يفعله غير المؤمن دون تفكير، دون حساب، دون مسؤولية، دون وجس، دون خوف، فما دام هناك شهوات مُودَعة فيه، ومادام هناك مادة لهذه الشهوات التي أمامه فإنه يلبيها بحيوانيةٍ عجيبة. إذاً:
﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(1) قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ(2)﴾
﴿مُّبِينٌ﴾ معه أدلة، فهو ينطق بلسانهم، بلغتهم.
لماذا كان الأنبياء من بني البشر؟ ليخاطبوهم.
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ(4)﴾
إما بلغتهم التي يعرفونها، أو بالأشياء التي تفوَّقوا بها، فقد كان هناك قومٍ تفوق في السحر، فإذا بسيدنا موسى يأتي بعصاةٍ فتصبح ثعباناً مبيناً، كما كان هناك قوم تفوَّقوا في الطب فأتى سيدنا عيسى وأحيا الموتى، وقد تفوَّق القوم في اللغة والبلاغة فأتى النبي الكريم بقرآنٍ مُعْجِز، فلذلك كان الأنبياء يأتون ببيان وأدلة وأسلوب واضح وعلامات نَيِّرة وبيان معجز.
﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ مرة حدثني أخ أنه كان له جار مُسرِف على نفسه في المعاصي، فنصحه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ونبهه قائلاً: الموت قريب، وأنت لا تصلي، وترتكب المعاصي والآثام، وتشرب، فما كان ينتبه إطلاقاً إلى أن توفِّي، فرآه بعض الجيران في المنام يرتدي ثياباً بالية مُمَزَّقة، ويصيح من شدة الألم ويقول: فلان نصحني ولم أنتصح، يا ليتني قبلت نصيحته، فالإنسان أحياناً تأتيه نصيحة من إنسان فيجب ألا يراها أنها من إنسان، بل هي من الواحد الديان، فالله سخر لك هذا الإنسان لكي ينصحك، فهناك إنسان تتأبّى نفسه قَبول النصيحة، وهذا كِبر.
وهناك فكرة دقيقة جداً، إن الإنسان أحياناً لا يحب أن يستجيب لداعية، ويقول لك: هو أصغر مني، وأنا أكبر منه، وأنا معي شهادة أعلى منه، ولي مكانة اجتماعية أعلى منه، فلماذا ترى أنّ هذا الأمر منه؟ إنه ينقل لك أمر الله عزَّ وجل، فهو ناقل أمين، وهذا ليس أمره، بل أمر الله، وهذا النهي ليس نهيه بل نهي رسول الله، فأنت لا تنظر إلى الشخص بل انظر إلى ماذا يقول، إنه يعطيك أمر ونهي، فأحياناً الإنسان يكون راكباً مركبة، ويكون له زميل بمركبة أخرى، فيعطيه تحذيراً عن طريق الضوء، فيأخذ بهذا التحذير، ولو كان هذا الذي حذَّره عدواً له، فإنه يأخذ بهذا التحذير، فالإنسان يجب أن يقف موقفاً متعَقِّلاً من هذه القضايا الكبرى في حياة الإنسان.
﴿قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: إنني نذير أحذِّركم من عذاب يومٍ أليم لكن السؤال: إنه نذيرٌ مبين ينذرهم ولكن من ماذا؟ عندنا قاعدة في اللغة تقول أن الشيء إذا حُذِفْ أُطلِق ، ولم يذكر الله عزَّ وجل: ينذرهم من ماذا؟ ينذرهم من عذابٍ في الدنيا، ينذرهم من عذابٍ في القبر، ينذرهم من عذابٍ في الآخرة، ينذرهم من تأديبٍ إلهي، من تضييقٍ، من مشكلةٍ، فالله عزَّ وجل رحيم، إما أن تأتيه طائعاً، وإما أن يحملك على أن تأتيه سريعاً، إما أن تأتيه طائعاً مستسلماً تائباً، وإما أن أن يحيطك بمصائب-لا سمح الله ولا قَدَّر- تدفعك إلى الوقوف على بابه، فلو أنك أتيت الله طائعاً من دون مصيبة فهذا موقفٌ شريفٌ جداً، فهناك نقطة دقيقة، لو أن الله أرادنا أن نعبده خوفاً ولو أن الله أراد أن يجبرنا على طاعته، لكانت القضية سهلة جداً، فلو أراد رئيس جامعةٍ مثلا ًأن ينجِّح كل الطلاب لكانت القضية سهلة بالنسبة له، إنه سيوزع أوراق الأسئلة مطبوعٌ عليها الإجابة الصحيحة الكاملة، واكتب اسمك ورقمك فقط، ويحصل الطلاَّب على العلامة النهائية، مطبوع عليها بالأحمر علامة مائة بالمائة، هذه سهلة، لكن هذا ليس امتحاناً، وهذا الامتحان لا يُسْعِدُ الناجحين فيه، ولا قيمة له عند المجتمع، ولا عند الناجح، ولا عند الجامعة، لأنه قسر، لكن الله عزَّ وجل أرادنا أن نأتيه مُحِبِّين، فكلمة: عبد قد تعني عبد قهرٍ، وعبد القهر يُجمَع على عَبيد، وقد تعني عبد شكرٍ، وعبد الشكر يُجْمَعُ على عِباد، فكل إنسانٍ مقهور في وجوده إلى الله، فلو توقَّف قلبه انتهت حياته، ولو تجمَّدت نقطة دمٍ في دماغه انتهت حياته، وإذا جاءته سكتة دماغية أو سكتة قلبية انتهت حياته كذلك، وقد ذكرت اليوم على منبر أن الإنسان قد يشرب عبّاً، فهناك عصب اسمه العصب الحائر، والعصب المُبهَم، له اسمان، وهذا العصب بين المعدة والقلب، فإذا جاء تأثير شديد جداً على هذا العصب، ربَّما أمر القلب أن يَكُفَّ عن النبض، وفي كثير من الحالات يموت الإنسان موتاً مفاجئاً من شربة ماءٍ غباً، قال عليه الصلاة والسلام:
(( إذا شربتُمُ الماءَ فاشربوهُ مصًّا، ولا تشربُوهُ عَبًّا، فإنَّ العَبَّ يورِثُ الكِباد. ))
فالمعدة حارة، وتأتي بلتر ماء، فتلقيه في جوفك مباشرةً وفوراً، وبشكل مفاجئ، وهذا يعطي تأثيراً قاسياً، فربما كفّ القلب عن النبض، لذلك: ﴿قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾
﴿نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ فالإنسان أحياناً يدرك الحقيقة فيلتزم، وكل واحد منا مقهور بوجوده إلى الله عزَّ وجل، فلو توقَّف قلبه مات، ولو تعطَّل دماغه مات، فهناك موت دماغ وموت قلب، ونحن نظن موت القلب هو الموت، ولكن الحقيقة موت الدماغ هو الموت، فنحن مقهورون، أما الذي عرف الله واستقام على أمره وتقرَّب إليه فهو عبد الشكر، قال تعالى:
﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً(63)﴾
قال تعالى:
﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍۢ لِّلْعَبِيدِ (46)﴾
العَبيد غير العِباد، فإذا كنت تعرف الله عزَّ وجل وتحبه وتتقرَّب إليه فأنت من عِباد الرحمن، أما إذا كان الإنسان غارقاً في شهواته فهو من عَبيد الشيطان.
﴿ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ(2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ(3)﴾
﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ طالب في المدرسة، هُويَّته في المجتمع هي: طالب، وهو عند والده ووالدته وإخوته وأقربائه وأصدقائه طالب، كما أنه في الحي طالب، وما دام طالباً فما مهمته الأولى في حياته؟ إنها الدراسة فقط، وأنت عبدٌ لله، فما مهمتك الأولى في الحياة؟ أن تعبده.
﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(56)﴾
المهمة الأولى أن تعبده، والعبادة عِلَّةُ وجودك على وجه الأرض، فأنت هنا من أجل أن تعبده، فإذا قال أحدهم: ليس عندي وقتٌ أن أستمع لدرس علم، أو ليس عندي وقتٌ أن أصلي، فهل تعلمون ماذا يشبه هذا؟ إنه يشبه إنساناً أخذ شهادة عُليا في الطب، واشترى عيادة وأجهزة معقَّدة جداً كلها بالدَّين، ويحمل أعلى شهادة، وجاءه مريض بحسب المواعيد التي رسمها، من الساعة الخامسة إلى السابعة، فقال: أنا لست متفرغاً، فلأيّ شيء متفرّغ إذاً ؟ لقد أخذت دكتوراه في ثلاثة وثلاثين سنة، واشتريت عيادة بالدين وهي بمليونين، وأجهزتها بمليون، وجاءك أناس بالوقت الذي أنت خصصته، فإن قال: لست متفرّغاً، لكان مجنوناً، فإذا قال لك الإنسان: أنا ليس لديّ وقت لأصَلِّي، أو ليس لديّ وقت لأطلب العلم، أو ليس لديّ وقت لأحضر مجلس علم، أو ليس لديّ وقت لأفهم كتاب الله، أو ليس لديّ وقت لأفهم سنة رسول الله، أو ليس لديّ وقت لأعرف أحكام الفقه، نقول لك: أنت موجودٌ على وجه الأرض من أجل أن تعبده، ولن تستطيع أن تعبده إلا إذا عرفته، فإذا عرفته أطعتَه، وإن أطعته سَعِدتَ بقربه، فلا توجد كلمة أشعر أنها تنطلق من غباء أو من سوء فهم أو من عمى، كقول أحدهم: أنا ليس عندي وقت لأطلب العلم، علة وجودك على وجه الأرض أن تعلم..
﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۢ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا(12)﴾
لام التعليل، أنا جئتُ إلى المدرسة لأتعلم ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۢ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا﴾
﴿قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ*أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ العبادة: طاعةٌ طوعيةٌ، ممزوجةٌ بمحبةٍ قلبية، أساسها معرفةٌ يقينية، وتفضي إلى سعادةٍ أبدية، وفي العبادة ثلاث كُلِّيات؛ كليةٌ معرفية، وكليةٌ سلوكية، وكليةٌ جمالية، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً، فالذي يعبد الله هو على شيء من العلم، فمن المستحيل أن تعبده على جهل، كيف تعبده؟ والذي يعبد الله على شيء من الخلق المستقيم فهو لا يكذب، ولا يغتاب، ولا يتكّبَّر، ولا يجحد، والذي يعبد الله على شيء من السعادة، فهناك علم، وانضباط، وسعادة، وهذه هي العبادة، فيها جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب جمالي.
﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ أي: اتقوا عذابه، فإن لم تعبدوه فهناك عذاب ينتظركم، فأنت إما أن تعبده لأنك تحبه، وإما أن تفكر أنه ينبغي ألا تقع تحت وطأة عذابه.
﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ ولن تستطيعوا أن تتقوا الله عزَّ وجل إلا إذا اتبعتم سنة رسوله.
﴿وَأَطِيعُونِ﴾ لذلك لم يقبل ربنا عزَّ وجل من إنسانٍ دعوى محبَّته إلا بطاعة رسوله، قال تعالى:
﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(31)﴾
﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ محبوبيّةً.
﴿وَاتَّقُوهُ﴾ خوفاً.
طاعة الله عين طاعة رسول الله:
﴿وَأَطِيعُونِ﴾ وسيلةً، فبطاعة رسول الله تصل إلى محبة الله عزَّ وجل. قال تعالى:
﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ(62)﴾
قالوا: عين إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وعين إرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله، فالأمر واحد، فالحقيقة النبوية تقريباً كلوح من البلور شفاف تماماً يشفُّ عما وراءه، فليس هناك وجود لذات النبي، فإنه يعبِّر عن حقيقة هذا الدين، ويعبر عن ذات الله عزَّ وجل، فإذا أطعت رسول الله وصلت بطاعته إلى الله.
﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ(3) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(4)﴾
أما هذه (من) فينطوي فيها معنى خطير؛ أي: يغفر لكم بعض ذنوبكم، (من) للتبعيض، فأية ذنوب؟ قال: الذنوب التي بينكم وبين الله، أما التي بينكم وبين العِباد فلا تُغفَر إلا بحالتين؛ بالأداء، أو المسامحة، لأن حقوق الله عزَّ وجل مبنيةٌ على المسامحة، بينما حقوق العباد فهي مبنيةٌ على المشاححة.
﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّى﴾ من أجمل معاني هذه الآية أن الأجل لا يتأخَّر، فالأجل أجل، وما معنى وَيُؤَخِّرْكُمْ؟ أي يمتعكم بصحتكم إلى يوم أجلكم، فمن الممكن أن يعيش إنسان ثلاثين سنة صحيحاً، وثلاثين أخرى بالفراش، وثلاثين مشلولاً، كما أنه من الممكن أن يعيش أربعين سنة صحيحاً وعشرين سنة مشلولاً ، أما حينما تعبدوا الله وتتقوه وتطيعوا رسوله، فإنه: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ التي بينكم وبينه.
نهاية مشرقة لبداية محرقة:
﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي: يمتِّعكم بصحتكم وقوَّتكم، وعقلِكُم، وسمعكم، وبصركم إلى يوم موتكم، أخّرك، أي جعلك نشيطاً وتستطيع الحركة طوال هذا العمر، وهناك رجل سمعت قصَّته وقد تواتر عنه هذا الخبر: عاش ستاً وتسعين سنة، فقامته ظلت منتصبة، كما أن بصره حاد، وسمعه مرهف، وأسنانه بفمه، ولم يستخدم نظَّارة، وحينما يُسأل يقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكِبَر، فمن عاش تقياً عاش قوياً.
لقد زرت مرة والد أحد أصدقائي، فقال لي بالضبط: (لقد عملت تحاليل البارحة والنتائج كلها جيدة)، وعمره ست وتسعون سنة، وليس لديه مشكلة في التحليل، لا بالكولسترول، ولا بالأسيد أوريك، ولا بالشحوم الثلاثية، ولا بحمض البول، ولا بالسكر، لكنه مرة قال لي: والله يا أستاذ لا أعرف أني أكلت قرشاً حراماً في حياتي، ولا أعرف الحرام الذي يعرفُه الناس إطلاقاً، لا أعرف الحرام ولا الدرهم الحرام، (حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكِبَر ) .
إخواننا الكرام، الناس يتشابهون في ربيع العمر، فكلهم شباب، أما في خريف العمر فهم يتمايزون، فربيع العمر يحدد خريف العمر، وإذا كان ربيع العمر في طاعة الله فإنه يحدد خريف العمر في تألق وبهاء، أما إذا كان في ربيع العمر انحراف وخطأ، فلا بد أن يكون في الخريف مشكلات. قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكِبَر.
﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ*يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي: يمتَّعك بمكانتك، فأحياناً هناك الإنسان يَخْرَف، قال لي أخ: إننا نقوم بربط والدتي على ديوان، فنربط يديها فوق رأسها إلى طرف السرير، ورجليها إلى الطرف الآخر؟ قلت له لماذا؟ قال لي: لأنها تأكل غائطها وتخلع كل ثيابها.
﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍۢ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ(70)﴾
فالإنسان إذا حفظ الله في الصغر حفظ الله عليه صحته وعقله ومكانته، والله لقد زرت إنساناً في بلدة في الشمال، وقد دعا إلى الله بإخلاص، وعمره خمس وتسعون سنة، والله ما رأيت ملكاً في عرشه كما رأيت هذا العالم؛ لأنه حفظ الله في الصغر؛ فهو في مكانة، وله شخصية ومنطق وأدب ومحبة، وهو مخدوم محفوظ محسود، وكل الناس أمامه، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة.. ومن لم تكن له بدايةٌ محرقة لم تكن له نهايةٌ مشرقة.
﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴾ فالأجل لا يؤخَّر، أما: ﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي: يمتِّعكم بصحتكم طوال عمركم، وقد زرت شخصاً يعمل في الحقل الديني وعمره خمس وثمانون سنة، فقلنا له: كيف الصحة؟ قال: "الحمد لله، والله بالنسبة لسني صحتي ممتازة" فحركته نشيطة، وهو بكامل الحواس الخمس، وبكامل إدراكه، ويعمل في الإفتاء، قال لي: الحمد لله. وكلما رأيت إنساناً بسن متقدمة وصحة طيبة، أقول: سبحان الله، شيء جميل جداً أن يكون لإنسان بداية محرقة فتكون له هذه النهاية المشرقة.
﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ لا يؤخَّر، لكنك قد تستمتع بهذه الحياة وأنت في صحةٍ طيبة، وفي درسٍ قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى:
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً(5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً(6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً(7)﴾
الملف مدقق