- التربية الإسلامية
- /
- ٠9سبل الوصول وعلامات القبول
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.
الرضا :
أيها الأخوة الكرام، لا زلنا في موضوعٍ يتصل أشد الاتصال بـ: "سبل الوصول وعلامات القبول" ألا وهو "الرضا"،  أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى:
أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى:
﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾
الإمام الجنيد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول: الرضا هو العلم، أنت حينما تعلم حكمة الله، ورحمته، وعدله، لابد أن ترضى عنه، وحينما تنطلق من حقيقةٍ في الإيمان دقيقة وهي أن كل شيءٍ وقع أراده الله، وأن كل شيءٍ أراده الله وقع ، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، ومعنى يريد أنه سمح بذلك، قد يسمح ولم يأمر، وقد يسمح ولم يرضَ.
كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق :
أيها الأخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، 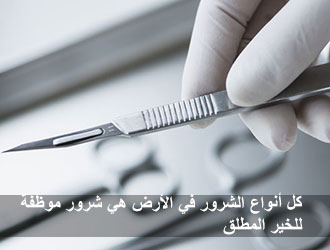 والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله، هناك شر نسبي.
والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله، هناك شر نسبي.
الإنسان أحياناً حينما يُفتح بطنه، ويخدر، وتستأصل الزائدة الدودية، هذا شرٌ نسبي من أجل سلامته، ومن أجل استمرار حياته، فدائماً كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق، لذلك ننطلق في هذا المعنى الدقيق من قوله تعالى:
﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾
أي الإنسان إذا أكرمه الله بنعمٍ لا تعد ولا تحصى في الدنيا يتوهم أن هذا إكرامٌ له، وحينما يزوي الله عنه نعمةً لحكمةٍ بالغةٍ بالغة يتوهم أن الله أهانه، فجاء الجواب الإلهي:
﴿ كَلَّا ﴾
كلا ليست أداة نفي، أداة ردعٍ ونفيٍ، لو أن إنساناً سُئل هل أنت جائع ؟ يقول: لا، أما إذا قيل له: هل أنت سارق؟ ـ وهو إنسان ذو أخلاق عالية جداً ـ لا يقول: لا، يقول: كلا، أي ما كان لي أن أسرق، ولا أن أقبل بالسرقة، ولا أن أدعو إليها، ولا أن أرضى بها، ولا، ولا، علماء اللغة عددوا أكثر من عشر حالات نفي بهذه الصيغة "وما كان"، فالله عز وجل قال:
﴿ كَلَّا ﴾
أي:
(( يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء ))
حظوظ الإنسان موقوفةٌ على طريقة الحركة من خلالها :
المال هل هو نعمة؟ الجواب: نعم ولا، نعم إذا اكتسب من طريقٍ حلال، وأنفق في وجهٍ حلال، فهو نعمة، أما إذا اكتسب من طريقٍ حرام، وأنفق في وجهٍ حرام، فهو نقمة.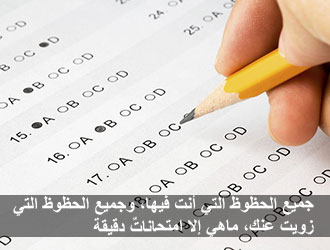
الصحة نقمة أم نعمة؟ إن تقوى الإنسان بالصحة على معصية الله فهي نقمة، وإن تقوى بالصحة على طاعة الله فهي نعمة.
الزوجة نعمةٌ أم نقمة؟ إذا أعانتك على أمر آخرتك فهي نعمة، أما إذا ضغطت عليك حتى حَملتك على معصية الله فهي نقمة، كل حظوظ الإنسان ابتلاء، أو موقوفةٌ على طريقة الحركة من خلالها، فالآية الآن معناها الدقيق .
﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ ﴾
أي امتحنه بالمال،
﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ ﴾
هو
﴿ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾
﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ ﴾
امتحنه بقلة المال،
﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾
يأتي الرد الإلهي،
﴿ كَلَّا ﴾
لذلك جميع الحظوظ التي أنت فيها، وجميع الحظوظ التي زويت عنك، امتحاناتٌ دقيقة، أنت ممتحن شئت أم أبيت، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن فيما أنت فيه، ممتحن فيما لست فيه، ممتحن بالمال، ممتحن بفقده، ممتحن بالصحة، ممتحن بفقدها، ممتحن بالوسامة، ممتحن بضدها، ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض، أي شيءٍ إيجابي هو مادة امتحانك مع الله، وأي شيءٍ سلبي هو مادة امتحانك مع الله، اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، أنت في دار امتحان.
(( إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ))
الرضا أن يرضى الإنسان عن الله إن أعطاه أو منعه :
إذاً الرضا أن ترضى عن الله إن أعطاك أو منعك، إن قواك أو أضعفك، إن أغناك أو أفقرك، إن عُمرت طويلاً وإن كان العمر قصيراً، في بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام:
((إن الله عز و جل يحمي عبده المؤمن كما يحمي الراعي الشقيق غنمه من مراتع الهلكة ))
فحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يزوي عنا نعمةً من نعمه فلحكمةٍ بالغةٍ بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، والحقيقة لن تكون راضياً عن الله إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك، لا تعد راضياً عن الله، لا تبلغ مقام الرضا، إلا إذا استوى عندك أن تؤتى الدنيا أو أن تزوى عنك، لذلك من أجمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم:
(( اللَّهمَّ ما رَزَقْتَني مما أُحِبُّ فاجعَلْهُ قُوَّة لي فيما تُحِبُّ، وما زَوَيْتَ عني مما أُحِبُّ فاجعَلْهُ فَرَاغا لي فيما تُحِبُّ ))
هذا المؤمن أعطاه الله المال يقول: يا رب اجعله قوةً لي في التقرب إليك، زوى عنه المال: يا رب اجعل الوقت الذي نتج عن إبعاد المال عني قربةً إليك.
من خصائص المؤمن أنه شاكرٌ في السراء صابرٌ في الضراء :
أيها الأخوة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ مع أصحابه إذ ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني ممَ أضحك؟ قالوا: يا رسول الله وممَ تضحك ؟ قال:
(( عَجَبا لأمر المؤمن! إنَّ أمْرَه كُلَّه له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتْهُ سَرَّاءُ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابتْهُ ضرَّاءُ صَبَر، فكان خيراً له ))
 هذه من خصائص المؤمن، شاكرٌ في السراء، صابرٌ في الضراء، إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول: الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول: الحمد لله ، وهناك حمد مشهور عند عامة الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه، والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذه من خصائص المؤمن، شاكرٌ في السراء، صابرٌ في الضراء، إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول: الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول: الحمد لله ، وهناك حمد مشهور عند عامة الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه، والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ))
فالمؤمن شاكر وحامد، قيل لأحد العلماء الكبار: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ تحدثنا في لقاءٍ سابق عن فرقٍ دقيق بين المقام والحال، المقام كسبي وثابت، والحال وهبي وطارئ، وأحيانا إنسان يكون في حال رضا بجو معين، بمكان معين، مع أشخاص معينين، أما مقام الرضا مقام دائم وثابت، وهو كسبي، فسُئل هذا العالم الجليل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول، يقول هذا العبد المؤمن الراضي: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
الأمر حينما يتضح جلياً فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية :
أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً: أنت حينما تطيع الله في أمر اتضحت لك حكمته، وحينما تتلكأ في طاعة الله في أمرٍ لم تتضح لك حكمته، أنت إذاً لا تعبد الله، ولكنك تعبد ذاتك، الشيء الذي اقتنعت به أنه سيعود عليك بالخير أطعت الله به، والشيء الذي لم تتضح لك حكمته تلكأت في طاعة الله به، هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته.
بالمناسبة: كلما اتضحت حكمة الأمر ضعف الجانب التعبدي فيه، وكلما غابت عنك حكمة الأمر ازدادت قيمة التعبد فيه، أي أعلى عبادة في تاريخ البشرية عبادة سيدنا إبراهيم :
﴿ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾
أي هناك شيء مقبول، وشيء غير مقبول، أمره الله أن يذبح ابنه، الشاب النبي الذي بلغ معه السعي:
﴿ قال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾
طبعاً الحكمة ليست واضحةً إطلاقاً من ذبح ابنه:
﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾
﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾
إذاً الأمر حينما يتضح جلياً فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية، وحينما تغيب عنك الحكمة تزداد قيمة التعبد في هذا الأمر، للتقريب: أب أمر ابنه بتنظيف أسنانه، الأمر واضح لمصلحة الابن، لمصلحة سلامة أسنانه، وكلما أعطى الأب أمراً لابنه، الحكمة واضحة جداً عند الابن، فالابن يبادر إلى تطبيقها، هو في الحقيقة بادر إلى تحقيق مصالحه، لكن لو أن الابن بحالة من الجوع شديدة، والطعام نفيس، والطعام احضره الأب، وهذا الولد ابنه، قال له: يا بني لا تأكل، الأمر غير واضح، أنا يا أبتِ ابنك، وأنا جائع، وهذا طعامك من لي غيرك؟ لا تأكل، فقال له: سمعاً وطاعةً يا أبي، لأن الحكمة من هذا المنع ليست واضحة، فلما وقف الابن موقف المتأدب مع أبيه كان في أعلى درجات القرب من أبيه.
حينما يأتيك أمر إلهي وليست الحكمة واضحة عندك منه، وتبادر إلى طاعته، فأنت عبدٌ لله، أما لا تطبق إلا الأمر الذي تقتنع به فأنت عندئذٍ تعبد ذاتك، ولا تعبد الله، قال بعض العلماء: علة الأمر أنه أمرٌ من الله.
علة أي أمرٍ أنه أمر :
أنا لا أنسى لقاء تمّ بين عالم من علماء الشام، وعالم في أمريكا من أصل أمريكي هداه الله إلى الإسلام، جاء موضوع لحم الخنزير، هذا العالم الدمشقي وله أجر عند الله أفاض وأسهب في الحديث عن مضار لحم الخنزير لساعةٍ أو أكثر، فلما انتهى من شرحه الطويل، وأدلته العميقة، وتحليله الدقيق، ابتسم هذا العالم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي: إن الله حرمه.
لأنك أنت مع طبيب من بني جلدتك، يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً، قال لك: دع الملح، قد لا يخطر في بالك أن تسأله لماذا؟ هكذا قال الطبيب، قد يقول لك الطبيب: بع بيتك في الطابق المرتفع، وتكون أنت قد اعتنيت به وبكسوته عناية فائقة، وتكلفت مبالغ طائلة، وأمضيت وقتاً طويلاً في كسوته، في اليوم التالي تبيعه، الطبيب قال: هذا البيت لا يناسبني.
فأنت مع إنسان عادي تثق بعلمه لا تفكر في مناقشة أوامره، فكيف مع الواحد الديان؟ لذلك قالوا: علة أي أمرٍ أنه أمر وكفى، هذا المؤمن، فأنت حينما تطبق تقطف كل ثمار الدين، أما حينما تحلل، وتفلسف، وتبحث عن الحكمة، يمكن أن تقنع الناس بذلك، تنقلب إلى داعية، أما العابد لله يقطف كل ثمار الدين من تطبيق الأمر.
وأوضح فكرة في هذا الموضوع أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيفاً، ضغط على مفتاح التشغيل فجاءه الهواء البارد، وإنسان آخر يحمل دكتوراه بالتكييف، اشترى مكيفاً، وضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد، فالانتفاع بالهواء البارد وبخصائص هذا المكيف ليست متعلقة بفهم آلية العمل، هذا الدين كالهواء للناس، يطبقه المؤمن الأمي والمثقف، من فهم الحكمة ومن لم يفهمها، هذا هواء للناس، فالذي يطبق أوامر الدين يقطف كل ثماره ولو لم يقف على حكمة هذه الأوامر لكنه عابد، أما الذي وصل إلى حكمة الأوامر فيمكن أن يكون داعيةً يقنع الناس بهذا الدين.
الله عز وجل عزيز يمتحن صدق الإنسان وصبره فإن رآه صادقاً أعطاه :
أيها الأخوة، الله عز وجل عزيز، ومعنى عزيز أي الشيء الذي تطلبه منه لا تأخذه فوراً، يمتحن صدقك، لذلك قال تعالى:
﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾
لا تتصور أن القضية ببساطة بالغة، طلب الجنة من دون عملٍ ذنبٌ من الذنوب، فالله عز وجل عزيز يمتحن صدقك، وصبرك، وإلحاحك، وسعيك، فإذا رآك صادقاً أعطاك.
من غابت عنه حكمة ما أصابه فهو بحاجة إلى الصبر :
أيها الأخوة قال تعالى:
﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾
 الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة، إنسان راشد بالغ عاقل، قال له طبيب الأسنان: قلبك لا يحتمل المخدر، وسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر فعليك تحمل الألم، الإنسان واع، وهذا كلام دقيق.
الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة، إنسان راشد بالغ عاقل، قال له طبيب الأسنان: قلبك لا يحتمل المخدر، وسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر فعليك تحمل الألم، الإنسان واع، وهذا كلام دقيق.
لذلك حينما يأتي الألم الذي لا يحتمل يتجلد ولا يتكلم، ما الذي أعانه على الصبر؟ توضيح الطبيب له، فهو بالغ، وعاقل، وراشد، لكن حينما تغيب عنك الحكمة أنت الآن في حاجةٍ إلى الصبر.
إنسان يأكل المال الحرام، يتلف الله هذا المال، لكن أحياناً إنسان وهو مستقيم على أمر الله تأتيه مصيبة، هنا تحتاج إلى الصبر، قال تعالى:
﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾
الآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمنٍ منها نصيب :
لكن الآية التي تذيب الإنسان.
﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾
 ولي رأي في هذا الموضوع، أن كل آيةٍ موجهةٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمنٍ منها نصيب، بقدر إيمانه وإخلاصه، فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم:
ولي رأي في هذا الموضوع، أن كل آيةٍ موجهةٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمنٍ منها نصيب، بقدر إيمانه وإخلاصه، فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم:
﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾
فيا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاعلم
﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾
هكذا تقتضي الحكمة .
﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾
فالآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمنٍ منها نصيب.
﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾
أيها الأخوة، مما جاء في بعض الأحاديث القدسية:
(( يا ابن آدمَ لا تَعْجِز من أربع ركعات في أول نهارك، أكْفِكَ آخرَهُ ))
صدقوا ولا أبالغ أن كل واحدٍ من الأخوة وقد جاء لصلاة الفجر، وترك فراشه الوثير، وسار في الطريق إلى بيت الله عز وجل كأنه في ذمة الله حتى المساء.
(( لا تَعْجِز من أربع ركعات في أول نهارك ، أكْفِكَ آخرَهُ ))
فإنك في هذا اليوم بأعيننا، فإنك في هذا اليوم بحفظنا، فإنك بهذا اليوم في توفيقنا، فإنك بهذا اليوم في رعايتنا، شيء جميل جداً،
(( من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ))
(( مَنْ صَلَّى العِشاء في جماعة فكأنَّما قام نِصْفَ الليل، ومن صلَّى الصبحَ في جماعة فكأنَّما صلَّى الليلَ كُلَّهُ ))
عدم التناقض بين الألم من المصيبة و الرضا عن الله عز وجل :
أيها الأخوة، هناك ملاحظة مهمة جداً، الألم عند المصيبة لا يلغي الرضا، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا قالوا: يا رسول الله: أتبكي؟ قال:
النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا قالوا: يا رسول الله: أتبكي؟ قال:
(( تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ، وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ، لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ))
هذا الموقف سليم، المصيبة تؤلم، وحينما يتألم الإنسان من مصيبة لا يعني أنه ليس راضياً عن الله، لا يوجد تناقض أبداً بين الألم من المصيبة وبين الرضا عن الله عز وجل.
بطولة الإنسان أن يقف من المصيبة الموقف الكامل لأن الدنيا دار ابتلاء :
بالمناسبة أيها الأخوة، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة أبداً، قال تعالى:
﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾
ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة لا أحد ينجو منها لأن هذه الدنيا دار ابتلاء،
﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾
والإمام الشافعي سُئل: " ندعو الإله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى" فالابتلاء قدرنا، والبطولة لا أن تنجو من ابتلاء بل أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء.
قيل للحسين بن عليٍ ـ رضي الله عنهما ـ:" إن أبا ذر ـ رضي الله عنه ـ يقول: الفقر أحب إليّ من الغنى، والسقم ـ أي المرض ـ أحب إلي من الصحة، فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنَ غير ما اختار الله له".
الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين :
الله عليم حكيم، جعلك غنياً، أرادك أن تتقرب إليه بإنفاق المال، الحمد لله على نعمة الغنى، الآن جعلك فقيراً، أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان، إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راض، اختار الله لك قلة المال، أنت راض، اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راض، أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته، أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راض، جعلك وسيماً، أنت راض، غير وسيم، أنت راض، صحيح، راض، مريض، راض، هذا هو المؤمن، قالوا: إن الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي، أي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.
أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان، إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راض، اختار الله لك قلة المال، أنت راض، اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راض، أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته، أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راض، جعلك وسيماً، أنت راض، غير وسيم، أنت راض، صحيح، راض، مريض، راض، هذا هو المؤمن، قالوا: إن الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي، أي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.
لذلك من اتكل على ماله ضلّ، ومن اتكل على قوته ذلّ، ومن اتكل على الله لا ضلّ ولا ذلّ.
سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول: "الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر".
أي هناك صبر وهناك رضا، الرضا أرقى من الصبر، إذا أحبّ الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر ـ أي رضي ـ اقتناه.
قال بعض العلماء: الرضا أقسامٌ ثلاث: رضا العوام بما قسمه الله لهم، رضا الخواص بما قدره الله عليهم، رضا خواص الخواص يرضون به بدلاً عما سواه.





